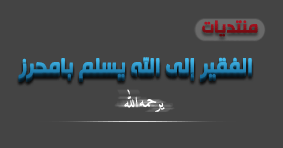
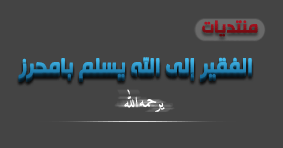 |
| 12-21-2010 01:37 PM | |
| ناصر |
( شرح ألفية ابن مالك [22] ) للشيخ : ( محمد بن صالح العثيمين ) شرح ألفية ابن مالك [22]
ما ولا ولات حروف نفي كليس، وقد جعل لها بعض العرب عمل ليس في رفع المبتدأ ونصب الخبر، ولكنها تعمل هذا العمل بشروط. فصل: في ما ولات وإن المشبهات بليس   ......  شروط إعمال ما عمل ليس  قال: [ إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقا النفي وترتيب زكن ] إعمال: مصدر مبين للنوع، وعامله (أعملت) وهو مضاف إلى (ليس). أعملت: فعل ماض مبني للمجهول. ما: نائب فاعل لأعمل. وتقدير الكلام: أعملت ما إعمال ليس، والذي عمل هذا الإعمال هم العرب. و ابن مالك رحمه الله لم يصغ هذا الفعل صيغة المجمع عليه، فقال: (أعملت) يعني: أعملها ناس، فالذي أعملها الحجازيون دون التميميين، فالتميميون أهملوها؛ لأن الأصل عندهم أن الحروف لا تعمل إلا الحرف المختص؛ ولهذا فإن (هل) حرف استفهام لا يعمل؛ لأنها مشتركة بين الأسماء والأفعال. لكن (إلى) و(من) و(على) و(لم) و(إن الشرطية) تعمل؛ لأن (لم وإن) مختصة بالأفعال، و(إلى وعلى) مختصة بالأسماء، وهذه القاعدة أغلبية وليست مطردة في كل حال. فإذاً: الذين أعملوا (ما) إعمال (ليس) هم الحجازيون، وبلغتهم جاء القرآن، قال الله تبارك وتعالى:  مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ  [يوسف:31]. وبنو تميم قبل توحيد القرآن على حرف واحد يقرءون: (ما هذا بشرٌ) أما بعد توحيده فيجب أن يقرأ بما وحده عليه الصحابة. وهنا بيت أديب يقول فيه: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب: ما قتل المحب حرام فهذا الحبيب ينتمي إلى قبيلة تميم؛ لأنه قال: ما قتل المحب حرامُ، ولو كان حجازياً لقال: ما قتل المحب حراماً. لكن يشترط لإعمال (ما) عمل ليس أن تكون غير مقترنة بإن؛ ولهذا قال ابن مالك : (دون إن). فإن اقترنت بإن لم تعمل، والمراد بإن هنا إن الزائدة، ومن ذلك قول الشاعر: بني غُدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمُ ذَهَبٌ وَلا صَرِيفٌ ولكِنْ أَنْتُمُ الخَزَفُ الخزف من الطين، والذهب معروف، والصريف الفضة، فيقول: أنتم ما لكم أصل، إذ معدنكم رديء لأنه من الخزف، ولا يريد أن يبين للناس أن أصل بني آدم من طين. وهنا لم تعمل ما؛ لأنها اقترنت بإن الزائدة. ولو قلت: ما زيد قائماً، صح. وإن قلت: ما إن زيد قائماً، فهذا خطأ؛ لأنها اقترنت بها إن الزائدة، وإذا اقترنت بها إن الزائدة بطل عملها. الشرط الثاني: قوله: (مع بقا النفي وترتيب زكن). (مع) ظرف مكان منصوب على الظرفية، وربما قيل فيه: معْ، لكنه قليل، كما قال ابن مالك : ومعَ معْ فيها قليل ونُقل فتح وكسر لسكون يتصل لكن هنا لا يجوز (معْ)؛ لأنه ينكسر البيت، فيقال: معَ بقا النفي، و(بقا) أصلها: بقاء، بالهمزة ولكن حذفت الهمزة لاستقامة ميزان النظم. وقوله: (وترتيب) يعني: ومع ترتيب زكن. هذان شرطان: الشرط الأول: أن يبقى النفي، فإن انتقض النفي فإنها لا تعمل، مثاله: ما زيد إلا قائم، فلا يجوز أن تقول: ما زيد إلا قائماً؛ لأن النفي انتقض. وقيل: تعمل وإن انتقض النفي. فتقول: ما زيد إلا قائماً، لكن هذا القول ضعيف؛ لأن القرآن يدل على أنه إذا انتقض نفيها بطل عملها، قال الله تعالى: [يوسف:31]. وبنو تميم قبل توحيد القرآن على حرف واحد يقرءون: (ما هذا بشرٌ) أما بعد توحيده فيجب أن يقرأ بما وحده عليه الصحابة. وهنا بيت أديب يقول فيه: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب: ما قتل المحب حرام فهذا الحبيب ينتمي إلى قبيلة تميم؛ لأنه قال: ما قتل المحب حرامُ، ولو كان حجازياً لقال: ما قتل المحب حراماً. لكن يشترط لإعمال (ما) عمل ليس أن تكون غير مقترنة بإن؛ ولهذا قال ابن مالك : (دون إن). فإن اقترنت بإن لم تعمل، والمراد بإن هنا إن الزائدة، ومن ذلك قول الشاعر: بني غُدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمُ ذَهَبٌ وَلا صَرِيفٌ ولكِنْ أَنْتُمُ الخَزَفُ الخزف من الطين، والذهب معروف، والصريف الفضة، فيقول: أنتم ما لكم أصل، إذ معدنكم رديء لأنه من الخزف، ولا يريد أن يبين للناس أن أصل بني آدم من طين. وهنا لم تعمل ما؛ لأنها اقترنت بإن الزائدة. ولو قلت: ما زيد قائماً، صح. وإن قلت: ما إن زيد قائماً، فهذا خطأ؛ لأنها اقترنت بها إن الزائدة، وإذا اقترنت بها إن الزائدة بطل عملها. الشرط الثاني: قوله: (مع بقا النفي وترتيب زكن). (مع) ظرف مكان منصوب على الظرفية، وربما قيل فيه: معْ، لكنه قليل، كما قال ابن مالك : ومعَ معْ فيها قليل ونُقل فتح وكسر لسكون يتصل لكن هنا لا يجوز (معْ)؛ لأنه ينكسر البيت، فيقال: معَ بقا النفي، و(بقا) أصلها: بقاء، بالهمزة ولكن حذفت الهمزة لاستقامة ميزان النظم. وقوله: (وترتيب) يعني: ومع ترتيب زكن. هذان شرطان: الشرط الأول: أن يبقى النفي، فإن انتقض النفي فإنها لا تعمل، مثاله: ما زيد إلا قائم، فلا يجوز أن تقول: ما زيد إلا قائماً؛ لأن النفي انتقض. وقيل: تعمل وإن انتقض النفي. فتقول: ما زيد إلا قائماً، لكن هذا القول ضعيف؛ لأن القرآن يدل على أنه إذا انتقض نفيها بطل عملها، قال الله تعالى:  مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ  [المؤمنون:24] فرفع (بشر) لأنه انتقض النفي بإلا، وعلى هذا نعرب الآية فنقول: (ما) نافية ملغاة، و(هذا) مبتدأ، و(إلا) أداة حصر، و(بشر) خبر المبتدأ. وإذا قلت: ما ما زيد قائم، أو ما ما زيد قائماً، فلا بد من التفصيل: إذا كانت ما الأولى نافية والثانية نافية، فهنا يتعين الرفع؛ لأن النفي انتقض؛ لأن نفي النفي إثبات، فقولنا: ما ما زيد قائم، يعني: ليس الأمر انتفاء قيام زيد. وإن جعلنا (ما) الثانية توكيداً للأولى غير مستقلة عملت؛ لأن النفي باق بل أكد، كما لو قلت: ما زيد قائماً ما زيد قائماً، هنا كررها في الجملة كلها، فإذا كررت ما وحدها فهو توكيد. ولكن هل إذا عبرت ابتداء فقلت: ما ما زيد قائماً، هل هذا صحيح؟ نقول: لا. هذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، وإذا كان الأصل في الكلام التأسيس صار النفي هنا منفياً فينتقض، لكن لو فرض أنه وجد في لغة العرب: (ما ما زيد قائماً) هكذا بالنصب، فنقول: أراد المتكلم أن ما الثانية توكيد. الشرط الثالث قوله: (وترتيب زكن). أي: وترتيب بين الاسم والخبر، يعني: ألا يتقدم خبرها على اسمها، بل ولا عليها أيضاً، لا بد أن يقع الاسم ثم الخبر، فلو قلت: ما قائماً زيد، فالحكم خطأ، يجب أن أقول: ما قائم زيد. وإذا قلت: ما عندك زيد، فهذا صحيح، لكن (ما) هنا ملغاة؛ لأن ابن مالك يقول: لا بد من الترتيب، فإذا قلت: ما عندك زيد، فقد قدمت الخبر فتقول: (زيد) مبتدأ مؤخر، ولا تقل: (زيد) اسم ما؛ لأن الترتيب اختلف. [المؤمنون:24] فرفع (بشر) لأنه انتقض النفي بإلا، وعلى هذا نعرب الآية فنقول: (ما) نافية ملغاة، و(هذا) مبتدأ، و(إلا) أداة حصر، و(بشر) خبر المبتدأ. وإذا قلت: ما ما زيد قائم، أو ما ما زيد قائماً، فلا بد من التفصيل: إذا كانت ما الأولى نافية والثانية نافية، فهنا يتعين الرفع؛ لأن النفي انتقض؛ لأن نفي النفي إثبات، فقولنا: ما ما زيد قائم، يعني: ليس الأمر انتفاء قيام زيد. وإن جعلنا (ما) الثانية توكيداً للأولى غير مستقلة عملت؛ لأن النفي باق بل أكد، كما لو قلت: ما زيد قائماً ما زيد قائماً، هنا كررها في الجملة كلها، فإذا كررت ما وحدها فهو توكيد. ولكن هل إذا عبرت ابتداء فقلت: ما ما زيد قائماً، هل هذا صحيح؟ نقول: لا. هذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، وإذا كان الأصل في الكلام التأسيس صار النفي هنا منفياً فينتقض، لكن لو فرض أنه وجد في لغة العرب: (ما ما زيد قائماً) هكذا بالنصب، فنقول: أراد المتكلم أن ما الثانية توكيد. الشرط الثالث قوله: (وترتيب زكن). أي: وترتيب بين الاسم والخبر، يعني: ألا يتقدم خبرها على اسمها، بل ولا عليها أيضاً، لا بد أن يقع الاسم ثم الخبر، فلو قلت: ما قائماً زيد، فالحكم خطأ، يجب أن أقول: ما قائم زيد. وإذا قلت: ما عندك زيد، فهذا صحيح، لكن (ما) هنا ملغاة؛ لأن ابن مالك يقول: لا بد من الترتيب، فإذا قلت: ما عندك زيد، فقد قدمت الخبر فتقول: (زيد) مبتدأ مؤخر، ولا تقل: (زيد) اسم ما؛ لأن الترتيب اختلف. أعلى الصفحة  حكم تقدم معمول خبر ما الحجازية  ثم قال: [وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنياً أجاز العلما]. (سبق) مفعول مقدم، وعامله قوله: (أجاز). و(العلما) فاعل، والتقدير: وأجاز العلماء سبق حرف جر أو ظرف. ثم مثل المؤلف بمثال يحدد مراده، فقال: (كما بي أنت معنياً)، فالذي تقدم الآن هو معمول الخبر؛ لأن (ما) نافية، و(بي) جار ومجرور متعلق بمعنياً، والترتيب الأصلي لهذه الجملة: ما أنت معنياً بي، فقدم معمول الخبر على الاسم. و ابن مالك يقول: (أجاز العلما) وظاهر كلامه أن هذا إجماع، وليس كذلك، بل فيه خلاف. مثال الظرف: ما عندك زيد مقيماً، فعند ظرف متعلق بـ (مقيماً). فيجوز أن يتقدم معمول الخبر على الاسم، ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، وهذا عجيب، إذ كيف يجوز أن يتقدم فرعه وهو لا يجوز، هذا خلاف الأصل. والواقع أنه إذا جاز تقدم الفرع جاز تقدم الأصل، لكن يقولون: إنه يغتفر في الظروف والمجرورات ما لا يغتفر في غيرها، وهذا منتقض أيضاً في قولنا: ما عندك زيد، حيث قالوا: لا يصح أن يكون (عند) في محل نصب. وعلم من قوله: (وسبق حرف جر أو ظرف) أنه لو سبق معمول الخبر، وليس بظرف ولا جار ومجرور فإنه لا يصلح، فلو قلت: ما طعامَك زيد آكلاً، فإنه لا يجوز، إلا إذا أهملتها فقلت: ما طعامَك زيد آكل. وقول ابن مالك : (أجاز العلما)، ظاهره الإجماع. ولكن المسألة فيها خلاف أيضاً، فمن العلماء من قال: يجوز أن تقول: ما طعامَك زيد آكلاً، واستدل بالقياس، فقال: إنه إذا جاز تقديم المعمول جاز تقديم العامل، وأنتم أيها النحويون استدللتم على جواز تقديم خبر (ليس) عليها بتقدم معمول الخبر عليها. فنقول هنا أيضاً: تقديم معمول الخبر يؤذن بجواز تقديم الخبر؛ لأنه معموله وفرعه؛ ولهذا كان الصحيح الجواز، وأنه لا فرق بين أن تقول: ما بي أنت معنياً، وأن تقول: ما طعامك زيد آكلاً، فكلاهما جائز. بقي أن يقال: هل يجوز أن يتقدم الخبر على ما، فأقول: قائماً ما زيد؟ فالجواب: لا، لأنه قد سبق أن ما النافية في كان وأخواتها لا يجوز تقدم الخبر عليها، هذا مع أن الفعل العامل أقوى من الحرف العامل، فكيف إذا كان العامل حرفاً؟! وبهذا يتبين أن المسألة لها صور: طعامَك ما زيد آكلاً، وما طعامَك زيد آكلاً، على قولين، وكلام ابن مالك يدل على المنع. وما زيد آكلاً طعامَك، صحيح قولاً واحداً. وما زيد طعامَك آكلاً، يجوز؛ لأنه لم يتقدم على الاسم، إنما تقدم على الخبر، أي: صار متوسطاً بين الاسم والخبر. وما آكلاً طعامك زيد، لا يصح. إذاً: قوله: (وترتيب زكن) معناه أنه لا يجوز أن تقول: ما طعامك آكلاً زيد، ولا ما آكلاً طعامك زيد؛ لأنه لا بد من الترتيب بين الاسم والخبر، وفيه الخلاف، وإذا كان فيه خلاف فالصحيح التسهيل: (ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً). ويرد هنا سؤال وهو: لماذا قال المؤلف: (إعمال ليس أعملت ما)، ولم يقل: إعمال كان، مع أن كان هي الأصل؟ والجواب أن نقول: إن هذه الحروف أشبهت ليس في النفي بخلاف كان؛ لأن كان للإثبات، فلهذا قال: المشبهات بليس، إشارة إلى أن هذه الحروف ألحقت بليس لمشاركتها إياها في النفي. أعلى الصفحة  رفع المعطوف بلكن أو ببل على خبر ما المنصوب  قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما الزم حيث حل] ( رفع ) مفعول مقدم والعامل فيه (الزم)، و(رفع) مضاف و(معطوف) مضاف إليه. (بلكن أو ببل) متعلقان بالمعطوف. (من بعد منصوب) جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بمعطوف. (بما) جار ومجرور متعلق بمنصوب. (الزم) فعل أمر، والفاعل مستتر وجوباً تقديره أنت. (حيث) ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب. (حل) فعل ماضٍ، وفاعله مستتر، وحيث مضاف والجملة مضاف إليه. ومعنى البيت: الزم رفع معطوف بلكن أو ببل إذا جاءت بعد منصوب بما، مثاله: ما زيدٌ قائماً بل قاعدٌ، ولا يصلح أن تقول ( بل قاعداً )؛ لأن النفي انتقض، فإنك إذا قلت: (ما زيدٌ قائماً) فقد نفيت قيامه، فإذا قلت: (بل قاعد) أثبت قعوده، فانتقض النفي فوجب الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: بل هو قائم. وكذلك: ما زيدٌ قائماً لكن قاعد، ولا يجوز أن تقول: لكن قاعداً؛ لما ذكرنا. ونعرب (لكن قاعد) فنقول: (قاعد) خبر المبتدأ المحذوف والتقدير: لكن هو قاعد. فإن عطفت بغير لكن أو ببل، فإنه يبقى منصوباً، فتقول: ما زيدٌ قائماً ولا قاعداً؛ لأن النفي باق. ومثله: ما زيدٌ أكلاً ولا شارباً. وجميع حروف العطف كالواو فإذا عطفت بالواو أو غيرها من الحروف ماعدا (بل ولكن)، فإن المعطوف يكون منصوباً. وأما بلكن أو ببل فإن المعطوف يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف. أعلى الصفحة  جر خبر ما وليس ولا وكان المنفية بالباء الزائدة  يقول: [ وبعد ما وليس جر البا الخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر ] هذه مسألة ثانية تتعلق بالعطف يقول: (بعد ما وليس جر البا الخبر). بعد: ظرف، وهو مضاف إلى (ما). وليس: معطوف على (ما)، يعني: بعد ما وبعد ليس، والظرف متعلق بجر. (جر: فعل ماض. البا: فاعل حذفت منه الهمزة تخفيفاً، أو من أجل مراعاة الوزن. الخبر: مفعول به لجر. و(بعد لا) يعني: لا النافية، و(نفي كان) يعني: كان المنفية (قد يجر) أي: قد يجر الخبر بالباء. ومعنى البيت: أنه ورد جر الباء للخبر إذا كان خبراً لما أو خبراً لليس، وكذلك إذا كان خبراً لـلا، أو خبراً لكان المنفية فهذه أربع مواضع تدخل فيها الباء على الخبر وتجره لكن لفظاً لا محلاً. تقول: ما زيدٌ بقائم، فتجر الخبر بالباء، ولا ينصب الخبر لفظاً فلا تقول: بقائماً، لأن العامل -وهو الباء- عامل ظاهر، فيجب أن يعمل في مجروره ظاهراً، بخلاف الخبر فليس عامله ظاهراً، ولهذا نقول: إنه معرب بحسب هذا العامل الذي دخل عليه ظاهراً. إذاً: ما زيدٌ بقائم: (ما) نافية تعمل عمل ليس. و (زيد) اسمها. و(الباء) حرف جر زائد. و(قائم) خبر (ما) منصوب بها، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وفي قوله تعالى:  أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ  [الزمر:37]: الهمزة للاستفهام التقريري. و(ليس) فعل ماضٍ ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، والاسم الكريم اسم ليس. و(الباء) حرف جر زائد. و(عزيز) خبر ليس منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذاً: تدخل الباء الزائدة على خبر (ما)، وعلى خبر (ليس) وتجره لفظاً؛ لكن إعرابه محلاً يكون خبراً لليس، أو خبراً لما. وقوله: (وبعد لا ونفي كان قد يجر) أي: كذلك قد يجر بعد (لا)، وبعد (نفي كان). فلا النافية أيضاً يجر خبرها بالباء الزائدة فتقول: لا أحد بمغن عن الإنسان شيئاً سوى الله. وقول المؤلف: هنا (بعد لا ونفي كان) الظاهر أن مراده (لا) النافية للجنس، وكذلك (لا) التي من أخوات ما الحجازية؛ لأنه أطلق (وبعد لا ونفي كان قد يجر). ومنه قول الشاعر: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب الشاهد قوله: لا ذو شفاعة بمغن فتيلا. أما بعد نفي كان، فيقول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل فالباء هنا حرف جر زائد دخلت على خبر كان المنفية؛ (لم أكن بأعجلهم). والفرق بين (لا) النافية للجنس، و(لا) النافية يظهر بالتمثيل؛ فإذا قلنا: لا رجلٌ قائماً، لنا أن نقول: بل رجلان؛ فهذه لا نافية للوحدة أو للاثنين فهي مقيدة. أما إذا قلنا: لا رجل قائم؛ فيعني أنه لا يوجد أحد من جنس الرجال. [الزمر:37]: الهمزة للاستفهام التقريري. و(ليس) فعل ماضٍ ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، والاسم الكريم اسم ليس. و(الباء) حرف جر زائد. و(عزيز) خبر ليس منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذاً: تدخل الباء الزائدة على خبر (ما)، وعلى خبر (ليس) وتجره لفظاً؛ لكن إعرابه محلاً يكون خبراً لليس، أو خبراً لما. وقوله: (وبعد لا ونفي كان قد يجر) أي: كذلك قد يجر بعد (لا)، وبعد (نفي كان). فلا النافية أيضاً يجر خبرها بالباء الزائدة فتقول: لا أحد بمغن عن الإنسان شيئاً سوى الله. وقول المؤلف: هنا (بعد لا ونفي كان) الظاهر أن مراده (لا) النافية للجنس، وكذلك (لا) التي من أخوات ما الحجازية؛ لأنه أطلق (وبعد لا ونفي كان قد يجر). ومنه قول الشاعر: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب الشاهد قوله: لا ذو شفاعة بمغن فتيلا. أما بعد نفي كان، فيقول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل فالباء هنا حرف جر زائد دخلت على خبر كان المنفية؛ (لم أكن بأعجلهم). والفرق بين (لا) النافية للجنس، و(لا) النافية يظهر بالتمثيل؛ فإذا قلنا: لا رجلٌ قائماً، لنا أن نقول: بل رجلان؛ فهذه لا نافية للوحدة أو للاثنين فهي مقيدة. أما إذا قلنا: لا رجل قائم؛ فيعني أنه لا يوجد أحد من جنس الرجال. أعلى الصفحة  شروط إعمال لا ولات عمل ليس  قال المؤلف: [ في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العملا ] (في النكرات) جار ومجرور متعلق بأعملت. (أعملت): فعل ماضي مبني للمجهول. (كليس): الكاف حرف جر، لكنها اسم في الواقع بمعنى (مثل)، والكاف يجوز أن نستعملها اسماً كما قال ابن مالك : [ شبه بكاف وبها التعليل قد يعني وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسماً ............ ..................... ] يعني: يكون اسماً مثل: (مثل). وعلى كل حال يكون التقدير هنا: أعملت لا مثل ليس. (لا) نائب فاعل، يعني: أن (لا) أعملت في النكرات كإعمال ليس، وإذا كانت (الكاف) بمعنى (مثل) صارت مفعولاً مطلقاً، أي: في محل نصب. وقد: للتقليل؛ لأنها دخلت على الفعل المضارع. (وتلي) فعل مضارع. (لات) فاعل. (وإن) معطوف على (لات). ( ذا ) اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب. (العملا) بدل من ( ذا ) أي: هذا العمل. في هذا البيت ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث أدوات، وهي: لا ، ولات، وإن. لكن لا بد فيها من شروط: اشترط في عمل (لا) أن تكون في النكرات، يعني: فلا تعمل في المعارف، ومنه قول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا الشاهد قوله: (فلا شيء على الأرض باقياً) فـ(شيء) نكرة، و( باقياً ) نكرة، و(وزر) نكرة أيضاً، وكذلك (واقياً)، فهذا البيت جمع شاهدين: ففي الشطر الأول شاهد، وفي الشطر الثاني شاهد. وقوله: (في النكرات) يفهم منه أنها لا تعمل في غير النكرات، بل تهمل، فلو قلت: لا زيدٌ قائماً، لا يصح؛ لأنها لا تعمل إلا في النكرات. ومثله: لا الرجال قائمين، لا تصح. ولكن أورد على هذا الشرط قول الشاعر: وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا وجه الاعتراض: أنها عملت في معرفه؛ لأن (أنا) ضمير. أجابوا: بأن هذا شاذ. وأجاب آخرون: بأن هذا قليل. وعلى هذا فيكون إعمالها في النكرات أكثر من أعمالها في المعارف، ولكنها تعمل في المعارف على وجه قليل، ومنه أيضاً قول الشاعر: إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقيا والمعنى: أن الإنسان الجواد إذا لم يكن جوده خالصاً من أن يؤذي الشخص من جاد عليه، فإنه لا الحمد مكسوباً ولا المال باقياً؛ لأن ماله أنفذه، ولا يحمد؛ فيكون خسراناً حساً ومعنى. والشاهد: قوله: (فلا الحمد مكسوباً، ولا المال باقياً) حيث عملت لا في (الحمد، والمال) وهما معرفتان، لكنه قليل. قوله: (وقد تلي لات وإن ذا العملا). يعني: قد تأخذ (لات) و(إن) عمل ليس. فهاتان أداتان، و(لات) هي في الحقيقة (لا)؛ لكن زيد عليها تاء التأنيث. ولكن قد يقول قائل: تاء التأنيث تكون ساكنة فلماذا كانت هنا متحركة؟ نقول: لأنها اتصلت بحرف، وإذا اتصلت بحرف تكون مفتوحة، كما يقال: ثُمَّتَ في تأنيث (ثم). وعلة أخرى: أن ما قبلها ألف ساكنة؛ فلزم أن تحرك بالفتح. وعليه تقول في (لات): (لا) نافية، و(التاء) للتأنيث. و(إن) كذلك أيضاً تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، ومن ذلك قول الشاعر: إن المرء ميتاً بانقضاء حياته ولكن بأن يُبغى عليه فيخذلا (المرء) اسمها و(ميتاً) خبرها. يقول: المرء لا يموت بانقضاء حياته، فالحياة ستنقضي إن عاجلاً أو آجلاً، ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا، فهذا هو الموت حقيقة؛ أن يبغي عليك باغٍ، ويخذلك قريب، والشاهد قوله: (إن المرء ميتا) أي: ما المرء ميتا بانقضاء حياته. لكن هل هنالك فرق بين ميَّتٍ وميْتُ؟ قالوا: إن ميتَّاً من ينتظر الموت ولم يمت بعد، وميْتاً من مات، واستدلوا لذلك بقوله تعالى:  إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ  [الزمر:30]. واستدلوا للثاني بقوله تعالى: [الزمر:30]. واستدلوا للثاني بقوله تعالى:  أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ  [الأنعام:122]، وبقوله تعالى: [الأنعام:122]، وبقوله تعالى:  وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ  [ق:11]. وهذا في الغالب، أعني أن الميت بالتشديد لمن ينتظر الموت، والميْت بالسكون لمن وقع به الموت. وإعراب الشاهد في البيت كما يلي: (إن) نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. (المرء) اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. (ميتاً) خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. قال: [وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل] هذا الشرط يختص بلات، وهو أنها لا تعمل إلا في حين. وهل المراد بالحين الوقت أو لفظ (حين)؟ قيل: المراد لفظ (حين). وقيل: المراد الوقت، يعني ما دل على الحين، وهذا أصح. وإعراب هذا الشطر كما يلي: (ما) نافية. و(للات) جار ومجرور خبر مقدم. (في سوى) جار مجرور متعلق بعمل، و(سوى) مضاف، و(حين) مضاف إليه. و (عمل) مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع منها مراعاة حرف الروي، وأصلها (عملٌ). ولكن قد يقول قائل: بل علامة رفعة ضمة ظاهرة في آخره، لكنه سكن من أجل الوقف، كما تقول: قام زيدْ. والأول أظهر؛ لأن (عمل) لو حركت ووصلت بما بعدها فقلت: وما للات في سوى حين عملٌ وحذف ذي الرفع فشا والعكس قلْ لا يستقيم؛ إذاً: فسكونها هذا ليس من أجل الوقف ولكن من أجل مراعاة الروي، فتكون مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها منع من ظهورها مراعاة الروي. وقال: (وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل). حذف مبتدأ، وهو مضاف إلى (ذي)، وذي مضافة إلى (الرفع). (فشا) فعل ماض، وفاعله مستتر جوازاً تقديره (هو)، والجملة خبر (حذف). والمعنى: كثر حذف ذي الرفع، و(العكس) وهو حذف ذي النصب (قل). إذاً: لات تتميز بأنها لا تعمل إلا في حين، ولا بد من حذف أحد معموليتها: إما الاسم وهو الأكثر، وإما الخبر وهو الأقل. مثال ذلك قوله تبارك تعالى: [ق:11]. وهذا في الغالب، أعني أن الميت بالتشديد لمن ينتظر الموت، والميْت بالسكون لمن وقع به الموت. وإعراب الشاهد في البيت كما يلي: (إن) نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. (المرء) اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. (ميتاً) خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. قال: [وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل] هذا الشرط يختص بلات، وهو أنها لا تعمل إلا في حين. وهل المراد بالحين الوقت أو لفظ (حين)؟ قيل: المراد لفظ (حين). وقيل: المراد الوقت، يعني ما دل على الحين، وهذا أصح. وإعراب هذا الشطر كما يلي: (ما) نافية. و(للات) جار ومجرور خبر مقدم. (في سوى) جار مجرور متعلق بعمل، و(سوى) مضاف، و(حين) مضاف إليه. و (عمل) مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع منها مراعاة حرف الروي، وأصلها (عملٌ). ولكن قد يقول قائل: بل علامة رفعة ضمة ظاهرة في آخره، لكنه سكن من أجل الوقف، كما تقول: قام زيدْ. والأول أظهر؛ لأن (عمل) لو حركت ووصلت بما بعدها فقلت: وما للات في سوى حين عملٌ وحذف ذي الرفع فشا والعكس قلْ لا يستقيم؛ إذاً: فسكونها هذا ليس من أجل الوقف ولكن من أجل مراعاة الروي، فتكون مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها منع من ظهورها مراعاة الروي. وقال: (وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل). حذف مبتدأ، وهو مضاف إلى (ذي)، وذي مضافة إلى (الرفع). (فشا) فعل ماض، وفاعله مستتر جوازاً تقديره (هو)، والجملة خبر (حذف). والمعنى: كثر حذف ذي الرفع، و(العكس) وهو حذف ذي النصب (قل). إذاً: لات تتميز بأنها لا تعمل إلا في حين، ولا بد من حذف أحد معموليتها: إما الاسم وهو الأكثر، وإما الخبر وهو الأقل. مثال ذلك قوله تبارك تعالى:  فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ  [ص:3]. ( لا ) نافية ترفع الاسم وتنصب الخبر، و(التاء) تاء التأنيث، واسمها محذوف، ولا نقول: مستتر؛ لأن (لا) حرف، والحرف لا يتحمل الضمير، والضمير اسم وهو أقوى من الحرف. والتقدير: ولات الحين حين مناص؛ يعني: ليس ذلك الوقت حين مفر. وقد قلنا: إن المراد بالحين الوقت وهو الأصح، واستشهد لذالك بقول الشاعر: ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم البغاة: جمع باغ. ولات ساعة مندم: أي ليست الساعة ساعة مندم. فنلاحظ الآن أن (لات) عملت في لفظ غير لفظ حين، لكنه يدل على الحين والوقت، فعليه يكون المراد بقوله: (في سوى حين عمل) الوقت. وقوله: (والبغي مرتع مبتغيه وخيم)، هذا الشطر يكتب بماء الذهب، ومعناه: أن مرتع طالب البغي وخيم؛ لأن المصارع تأتي دائماً على البغاة، فما أقرب مصرع الباغي! وقول المؤلف: (العكس قل ) العكس هو حذف الخبر وبقاء الاسم. فلو قال الشاعر: ندم البغاة ولات ساعة مندم لقلنا: (الساعة) الاسم والخبر محذوف [ص:3]. ( لا ) نافية ترفع الاسم وتنصب الخبر، و(التاء) تاء التأنيث، واسمها محذوف، ولا نقول: مستتر؛ لأن (لا) حرف، والحرف لا يتحمل الضمير، والضمير اسم وهو أقوى من الحرف. والتقدير: ولات الحين حين مناص؛ يعني: ليس ذلك الوقت حين مفر. وقد قلنا: إن المراد بالحين الوقت وهو الأصح، واستشهد لذالك بقول الشاعر: ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم البغاة: جمع باغ. ولات ساعة مندم: أي ليست الساعة ساعة مندم. فنلاحظ الآن أن (لات) عملت في لفظ غير لفظ حين، لكنه يدل على الحين والوقت، فعليه يكون المراد بقوله: (في سوى حين عمل) الوقت. وقوله: (والبغي مرتع مبتغيه وخيم)، هذا الشطر يكتب بماء الذهب، ومعناه: أن مرتع طالب البغي وخيم؛ لأن المصارع تأتي دائماً على البغاة، فما أقرب مصرع الباغي! وقول المؤلف: (العكس قل ) العكس هو حذف الخبر وبقاء الاسم. فلو قال الشاعر: ندم البغاة ولات ساعة مندم لقلنا: (الساعة) الاسم والخبر محذوفأعلى الصفحة |
 تعليمات المشاركة
تعليمات المشاركة
|
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|