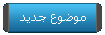فصل
في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع
الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان:
الشرح
هنا أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن، لكن خلافهم في تفسير القرآن أقل من خلافهم في الأحكام، لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه، معناها والمراد بهان وهذا شيء يقل فيه الخلاف، لكن الأحكام مبينة على الاجتهاد والنظر والقياس ، فصار الاختلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسير،وذلك لاختلاف الناس في العلم والفهم.
وقد سبق لنا القول بأن هناك فرقاً بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ، فتفسير اللفظ شيء وتفسير المعني الذي يراد بالآية شيء آخر، يعنى أن اللفظ يفسر بمعناه بحسب الكلمة، ويفسر بالمراد به بحسب السياق والقرائن.
والفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد: أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين؛ لأن الضدين لا يجتمعان.
واختلاف التنوع يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين؛ لأن كل واحد منهما ذكر نوعاً، والنوع داخل في الجنس، وإذا اتفقا في الجنس فلا اختلاف.
وعلى ذلك فاختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع، ولا بفرد من باب أولى، واختلاف التنوع معناه أنه يجمع بين القولين في الجنس ويختلفان في النوع ، فيكون الجنس اتفق عليه القائلان ولكن النوع يختلف، وحينئذ لا يكون هذا اختلافاً ؛ لأن كل واحد منهما ذكر نوعاً كأنه على سبيل التمثيل.
وسيذكر المؤلف أمثلة لذلك، لكننا لا بد لنا أن نعرف الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد.
* * *
أحدهما : أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة.
الشرح
اختلاف التنوع جعله المؤلف صنفين:
الأول: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، والضمير في قوله: (( منهم)) هنا يعود على الصحابة ، بل على السلف أعم، ليشمل الصحابة والتابعين ، فيعبر بعبارة غير عبارة صاحبه، لكن تدل على معني في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى ، فهما اتفقا على المراد لكن عبر كل واحد منهما عنه بتعبير غير الأول، وإلا فهما متفقان ، كما لو قال قائل في تعريف السيف: هو المهند، وقال الثاني: السيف هو الصارم، وقال الثالث: السيف ما تقطع به الرقاب ، وما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة ليس بخلاف.
وكذلك لو قال إنسان : الغضنفر الأسد، وقال الثاني: الغضنفر القسورة، وقال الثالث: الغضنفر الليث ، وما أشبه ذلك، فليس هذا خلافاً ولا تنوعاً أيضاً ، لكن كل لفظه تدل على معني لا تدل عليه اللفظة الأخرى والمسمى واحد.
وهذا هو المقصود بعبارة المؤلف : ( أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معني في المسمي غير المعني الآخر مع اتحاد المسمي).
ثم قال المؤلف: إنها بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، فقوله: (( المتكافئة )) هذه فيها إشكال إلا إذا كان المؤلف رحمه الله يريد بها معنى آخر، فالأسماء المترادفة هي الدالة على معنى واحد، والأسماء المتباينة هي الدالة على معنيين. فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على المسمى مترادفة، وباعتبار دلالتها على معني يختص بكل لفظ منها تكون متباينة.
* * *
كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد.
الشرح
أسماء الله- تعالي- كثيرة جداً، لكن مسماها واحد. فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات متباينة من حيث اختصاص كل اسم منها بالمعني الخاص به وكذلك أسماء الرسول صلي الله عليه وسلم متعددة، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة ، وباعتبار دلالة كل لفظ منها على معنى آخر متابينة. وكذلك القرآن يسمي القرآن ، والفرقان، التنزيل وغير ذلك، فهذه الألفاظ باعتبار دلالتها على القرآن مترادفة، وباعتبار أن كل واحد منها له معني خاص متباينة.
* * *
فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)(الاسراء:110)، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة.
الشرح
إذا هذه الأسماء الثلاثة باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالة الأول: على العلم، والثاني: على القدرة ، والثالث: على الرحمة، فهي متباينة.
ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون : لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض، كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان- مع دعواه الغلو في الظاهر- موافقاً لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك.
الشرح
والمؤلف رحمه الله لتشبعه بهذا العلم صار لا بد أن يذكره.
انقسم الناس في أسماء الله سبحانه وتعالي إلى أقسام فمنهم من جعلها أعلاماً محضة لا تدل على المعنى إطلاقاً، ومنهم من جعلها أعلاماً وأوصافاً، ومنهم من قال: لا نقول: إنه حي ولا نقول: إنه ليس بحي، فننكر هذا وهذا وهم الباطنية، ويجيبون بقولهم: إن الحياة والموت لا يصح نفيهما وإثباتهما إلا لمن هو قابل لذلك، والله تعالى ليس بقابل للحياة ولا للموت، ولهذا لا يوصف الجدار بأنه حي ولا ميت.
وللإجابة على ذلك نقول لهم: إن دعواكم إن الحياة والموت لا يوصف بها إلا من كان قابلاً لها مجرد دعوى أو عرف اصطنعتموه ، فالله سبحانه وتعالي وصف الأصنام بأنهم أموات، ونفى عنهم الحياة. فقال: (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ) ( النحل:20،21) ، وهم يعبدون شجراً وحجراً وما أشبه ذلك، فانتقض قولهم بنص القرآن.
أما زعمهم أننا لو قلنا: إن الله حي شبهناه بالأحياء ، ولو قلنا: إنه ميت شبهناه بالأموات ،نقول: فإنكم على زعمكم هذا قد شبهتموه بالجمادات. فما دمتم تقولون: إنه غير قابل للحياة والموت كالحجر فقد شبهمتوه بالجماد.
ثم نقول لهم: هب أننا تنازلنا معكم، لكن أنتم تقولون: إننا لا نقول: إنه موجود ولا غير موجود ، فنفيتم عنه الوجود والعدم، وهذا مستحيل باتفاق العقلاء، لأن المقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين نقيضين يجب إذا ارتفع أحدهما أن يثبت الآخر، وأنتم تقولون: لا يجوز أن نقول: إن الله موجود، ولا يجوز أن نقول: إن الله ليس بموجود فإذا قلت: إنه موجود فقد ألحدت، وإن قلت: معدوم، فقد ألحدت، وهذا غير ممكن ، ونقول: الآن شبهتموه بالمستحيلات والمتنعات التي لا يمكن وجودها.
فهذا مذهب الباطنية في الله عز وجل، يقولون: لا يمكن أن نثبت لله اسماً ولا معنى بل ننفي عنه النقيضين.
والآخرون- وهم المعتزلة وأهل الظاهر الذين يغالون في إثبات الظاهر- يقولون : إنا نثبت الاسم لكن لا نثبت له معني،ونقول هذه الأسماء مجرد أعلام فقط، أي سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، ورحيم بلا رحمة وهكذا، أي مجرد علم، كما أنك تقول لهذا الرجل محمد وهو مذمم ما فيه خصلة حميدة، وتقول لهذا الرجل عبد الله وهو من أكفر عباد الله ينكر وجود الله.
إذاً معنى قولنا: عبد الله مجرد علم يعين مسماه فقط، فهم يقولون : إن أسماء الله هكذا أعلام محضة، ليس لها معنى ولا تحمل معنى إطلاقاً.
وهذا الكلام الذي جاء به المؤلف جاء به استطراداً وليس له دخل في التفسير؛ لأنه قال: (( وليس هذا موضع بسط ذلك)) اللهم إلا أن يقال : قد يدخل في التفسير من حيث إن في القرآن أسماء كثيرة لله عز وجل.
1* *
وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ، ويدل أيضاً على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم.
الشرح
إن الاسم يدل على الصفة التي تضمنها وعلى صفة أخرى تضمنها اسم آخر بطريق اللزوم، مثاله اسم الخالق دل على الذات وعلى صفة الخلق، ودل على العلم الذي تضمنه اسم العليم، وعلى القدرة التي تضمنها اسم القدير ودل اسم الخالق على العليم والقدير؛ لأنه لا يمكن أن يخلق إلا بعلم وقدرة، ولهذا قال الله عز وجل: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) (الطلاق:12) ، وهذا واضح ؛ فلو أن أحداً صنع جهازاً من الأجهزة فلا يمكن أن يصنعه وهو لا يدري كيف يصنعه ولا يمكن أن يصنعه وهو أشل ؛ لأنه ليس قدرة.
وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل: القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب ، وأمثال ذلك.
فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمي هذا الاسم،وقد يكون الاسم علماً وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله : (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي)(طـه: 124).ما ذكره ؛ فيقال له: هو القرآن مثلاً، أو هو ما أنزله من الكتب ، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلي الفاعل وتارة إلي المفعول ، فإذا قيل : ذكر الله بالمعني الثاني، كان ما يذكر به مثل قول اعبد: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعني الأول، كان ما يذكره هو، وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي)(طـه: من الآية124).
لأنه قال قبل ذلك: ( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى)(طـه: 123) ، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك (قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً) (قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا )(طـه: :125،126)، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل :ذكري :كتابي أو كلامي ،أو هداي ،أو نحو ذلك فإن المسمى واحد.
الشرح
هنا يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان مقصود السائل- يعني الذي يسأل عن تفسير آية من القرآن_، تعيين المسمي عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. فلو قال سائل: ما معني قوله تعالي: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي)؟ وهل المراد بذكري المضاف إلي الفاعل أو المضاف إلي المفعول؟ يعني هل المعنى من أعرض عن ذكره إياي أو المعنى من أعرض عن ذكري الذي أنزلته إليكم؟
والجواب على ذلك أنه يحتمل أن يكون المعنى من أعرض عن ذكري أي: عن ذكره إياي ، كما قال تعالي: ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) ، أي: لتذكرني بها، فالمعني لذكري أي: لذكره إياي، ويحتمل أن يكون المراد بذكري أي: ما أنزلته عليه من الذكر وهو القرآن، أو بعبارة أعم وهو أحسن ما أنزله الله من الكتب،فالمعنى من أعرض عن الكتب الذي أنزلتها ليذكر بها، وهذا المعني إلي اللفظ أو إلي السياق أقرب؛ لقوله: (ٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي )(طـه: 123،124)، فالمراد بذكري هنا هداه الذي أنزله؛ لأنه قال: (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ ) ،(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ) ولكنه عبر في الإعراض عن ذكره؛ لأن فيما أنزله من الهدى تذكيراً للإنسان وإنذاراً له وتخويفاً.
فهنا إذا سأل عن الذكر فقيل له: الذكر قول سبحان الله، والحمد لله ، والله أكبر صار تفسيراً صحيحاً وإذا عن ذكري فقلنا له: ما أنزله من الكتب على عباده صار معنى صحيحاً ؛ لأن اللفظ صالح لهما جميعاً.وهذا اختلاف تنوع ، لأن المعني الثاني لا يضاد المعني الأول.فكل ما أنزله الله عز وجل فهو مستلزم لذكره وهو تذكير لعباده.
* * *
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمي مثل أن يسأل عن القدوس ، السلام، المؤمن ، وقد علم أنه الله، لكن مراده: ما معنى كونه قدوساً،سلاماً، مؤمناً ، ونحو ذلك.
الشرح
إذا قال : من هو القدوس؟ قلنا: الله. أو قال: من السلام؟ قلنا: الله لكن إذا قال ما القدوس؟ ما السلام؟ فهنا يختلف الجواب، لأن سؤاله ب (ما) يدل على أنه أراد المعنى، يعني ما معنى القدوس؟ وما معني السلام ؟ بخلاف ما إذا قال: من القدوس؟ فلا يمكن أن تفسر القدوس له، بل تعين المراد به المسمى بهذا الاسم، وهو الله سبحانه وتعالى.
* * *
إذا عرف هذا، فالسلف كثيراً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول: أحمد هوالحاشر، والماحي، والعاقب.
والقدوس هو :الغفور الرحيم أي: إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه.
الشرح
وهذا أيضاً جواب ثالث، إذا قال: من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ فقلت: عالم الغيب والشهادة، أو الذي وسعت رحمته كل شيء، أو هو الغفور الرحيم، فهذا جواب ثالث غير السابقين، لكنه في المعنى مثل من عرفه بالذات؛ لأنني عندما أقول هو الغفور معناه ما ( فسرت له) معني القدوس، ففهم مني أني أريد تعيين المسمى الذي هو الذات، لكن بمعنى آخر جديد قد لا يطرأ على باله، فأتيت باسم يدل على صفة ليست في نفس الاسم المسؤول عنه.
وذلك مثلاً إذا كان السائل يعلم، أو سأل: من هو القدوس؟ من هو السلام؟ فأقول: هو شديد العقاب لمن عصاه ؛ لأني أعرف أن هذا الرجل يقيم على معصية الله، فأريد أن أذكره. أو مثلاً يكون السائل إنساناً مشفقاً على نفسه خائفاً، فأقول في معناها هو من كان على حسن ظن عبده به، وذلك لأذكره بحسن الظن بالله.
فهذه الآن ثلاثة أنواع، قد يكون التفسير للكلمة تفسيراً للمراد بها بقطع النظر عن صفته، وقد يكون التفسير للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته، وقد يكون التفسير للكلمة بمعنى آخر يوصف به من يراد بها، مثل الغفور الرحيم السميع العليم..إلى آخره.
* * *
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم: هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة (5) ، (( هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم)) وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: (( ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداعٍ يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على راس الصراط، قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن )) (6).
فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبّه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله صلي الله عليه وسلم ، وأمثال ذلك.
فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
الشرح
عرفنا أنه إذا فسر السلف الكلمة بمعني، وفسرها آخرون منهم بمعنى آخر، باعتبار أن هذه الصفة تشمل هذا وهذا، فهو من باب اختلاف التنوع ، فقوله تعالى: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) ، معنى الصراط الطريق الواسع، لكن المراد بالصراط المستقيم الإسلام، هذا قول، وقول ثان هو القرآن، والمؤلف جاء لكل من هذين القولين بدليل من السنة، ومع ذلك فهما لا يتنافيان أبداً، لأن الإسلام هو ما في القرآن، وحينئذ فلا تضاد بينهما سواء فسر بأنه القرآن، أو فسر بأنه الإسلام.وواضح أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد، بدليل أن كل واحد منهما لا ينافي الآخر.
* * *
الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ (( الخبز)) فأري رغيفاً، وقيل له: هذا فالإشارة إلي نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف وحده.
الشرح
لو سأل أعجمي: ما هو الخبز؟ فقيل له: الخبز هو قرص يصنع من البر بعد طحنه وبله بالماء وعجنه فلن يعرف ما الخبز، ولكن إذا كان معك خبزة فقلت له هذا فهو لن يفهم أنه ليس في الدنيا خبز إلا الذي بيدك، بل سيعرف أن هذا على سبيل التمثيل،ولهذا لو ذهب إلي بقالة ووجد لفة خبز، فسيقول بكم لفة الخبز، فهذا التعيين ليس معناه أنه يراد أن يفسر اللفظ بهذا المعنى على وجه المطابقة، لا يزيد ولا ينقص، لكن على سبيل التمثيل.
* * *
مثال ذلك ما نقل في قوله: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات)[فاطر: من الآية32].
الشرح
يقول تعالي: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا ) الاسم الموصول ليس وصفاً للكتاب، بل الصحيح أن الكتاب مفعول أول، والذين مفعول ثاٍن.
قال تعالي: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) ، والمراد بالذين اصطفى الله من عباده هذه الأمة الإسلامية ؛ لأن آخر كتاب نزل هو هذا القرآن.
* * *
فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات، والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون.
ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار.
أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة ، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا ، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن، وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل.
فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق.
الشرح
صحيح هذا هو الغالب أن التعريف بالمثال أبين وأظهر من التعريف بالحد المطابق، فمثلاً لو قال لك قائل ما البعير؟ فقلت حيوان كبير الجسم، طويل العنق، ذو سنام ، له ذيل قصير وما أشبه ذلك من صفاته، فلن يعرفه ، حتى لو رآه ربما يشك فيه لعله يكون هناك شيء آخر يشابهه،لكن إذا قلت مثال البعير هذا اتضح ، والإيضاح بالمثال أكثر وضوحاً.
ولهذا ذهب كثير من الفقهاء رحمهم الله إلي التعريف بالحكم، وإن كان عند المناطقة يرونه عيباً، فمثلاً يقولون: الواجب هو ما أثيب فاعله واستحق العقوبة تاركه مثلاً، لكن لو قال: الواجب هو ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام ،فقد يشكل على الإنسان أكثر.
والحاصل أن السلف فسروا ( الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ )،بأن الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وأن المقتصد هو الذي يصليها في الوقت، وأن السابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول الوقت، أو بعبارة أصح على وقتها، وذلك من أجل أن يشمل الذي يصليها في أول الوقت فيما يسن تقديمه وفي آخره فيما يسن تأخيره، ولهذا جاء حديث ابن مسعود: (( الصلاة على وقتها)) (7) ؛ لأن هناك بعض الصلوات يسن تأخيرها كالعشاء.
وإذا قيل المقتصد هو الذي يؤدي الزكاة الواجبة، والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة مع الصدقات المستحبة، والظالم لنفسه هو الذي لا يزكي، فليس بين القولين تناقض؛ لأن كل واحد منهم ذكر نوعاً يدخل في الآية ، مع أن الآية أعم من هذا حيث تشمل كل ما ينطبق عليه ظلم النفس والسبق والاقتصاد.
* * *
والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
وقد يجئ كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إذا كان المذكور شخصاً، كأسباب النزول المذكورة في التفسير ، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة(( أوس بن الصامت)) وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله ، وإن قوله ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه))(المائدة: 49) نزلت في بني قريظة والنضير وإن قوله (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَه)(لأنفال: 16) ، نزلت في بدر، وإن قوله: ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْت)(المائدة: من الآية106) نزلت في قضية تميم الداري، وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله: ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(البقرة: من الآية195) ، نزلت فينا معشر الأنصار.. الحديث، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة ، أو في قوم من أهل الكتاب واليهود والنصاري، أو في قوم من المؤمنين .فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا ، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
الشرح
وهذا القول هو الصحيح : أنها تعم ذلك الشخص ؛ لأنها تختص بنوع ذلك الشخص أو تعم نوع ذلك الشخص فقط. مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: (( ليس من البر الصيام في السفر)) (8).فهذا اللفظ عام، لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص، فهل نخصصه بذلك الشخص؟
يقول شيخ الإسلام: ما أحد قاله من المسلمين ، وهل نخصصه بذلك النوع؟ يمكن ذلك إذا علمنا أن العلة والسبب في ذلك النوع لا يتعداه لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع، وإذا أخذنا بالعموم في حديث: (( ليس من البر الصيام في السفر)) ، قلنا: إن الصيام في السفر ليس من البر؛ سواء شق على الإنسان أم لم يشق. وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام عليه زحام ظللاً عليه، كأنه قال ليس صومه من البر وهذا أيضاً خطأ لا أحد يقوله من المسلمين مثل ما قال الشيخ ، وإذا قلنا: إنه خاص بالنوع ، قلنا: ليس من البر الصيام في السفر فيمن حاله كحال ذلك الشخص يشق عليه، فإنه ليس من البر أن يصوم في السفر بخلاف من لا يشق، وهذا القول الوسط هو الصواب ، وأنه يجب أن يعدى الحكم الوارد على سبب معين إلي نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم، ولا أن يختص بنفس ذلك الشخص.
وهنا نشير إلي أن ربطه بعلته أولى من التعميم؛ لأننا لو عممناه لاحتجنا إلي دليل على التخصيص، لكن كأنه من العام الذي أريد به الخصوص.
وفرق بين قوله: (( ليس من البر)) وبين قول: (( البر ألا يصوم))، لأنه قول قال : (( ليس من البر)) فهو من الإثم.
والرخصة لا نؤثم من لم يفعلها، اللهم إلا إذا اعتقد في نفسه الاستغناء عن رخصة الله له فهذا شئ آخر، فيكون آثماً من هذا الوجه، وأما من قال: الحمد لله الذي رخص لي لكن أنا قوى ونشيط، فهذا غير.
والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناوله لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضاَ.
ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلي سبب يمينه وما هيجها وآثارها.
الشرح
وكذلك إذا لم يعرف ما نواه المطلق رجع إلي سبب الطلاق، فمثلاً لو أن رجلاً رأى مع امرأته شخصاً فظنه أجنبياً، فقال لها: أنت طالق. بناء على أن الرجل الذي معها أجنبي، ثم تبين أنه أخوها فإنها لا تطلق؛ لأنه كأنه قال: أنت طالق لأنك صاحبتي رجلاً أجنبياً، وكذلك أيضاً الحالف لو قال: والله لا أزور فلاناً، لأنه قيل له إن الرجل فاسق، ثم تبين له أنه ليس بفاسق ، فإنه لا بأس أن يزوره ؛ لأن السبب في حلفه هذا أنه رجل فاسق، ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس بفاسق فإذا زاره ، فإنه لا يحنث؛ لأن السبب كالمشروط فكأنه قال والله لا أزوره لأنه فاسق، فيكون هذا السبب كأنه مشروط، وبهذا لا يكفر لأنه زال حكم اليمين، فلو قال: والله لا أزوره بناء على أنه فاسق، فتبين أنه ليس بفاسق، فهذا يزوره ولا شيء عليه؛ لأن اليمين انحلت فتبين أنها غير مرادة، وهذه قاعدة تنفعك في باب الأيمان وفي باب الطلاق ، أن ما بني على سبب فتبين زوال السبب فلا حكم له، لكن لو قال الحالف أنا نويت والله لا أزور فلاناً مطلقاً، لا أزوره لشخصه ، سواء كان فاسقاً أم عدلاً، فإذا زاره حنث لأننا هنا علمنا مراده.
والقاعدة في ذلك: أن كل لفظ بني على سبب فتبين انتفاء ذلك السبب فإنه لا حكم له.
والمسبب هو الآية النازلة أو الحديث الوارد، فمثلاً: سبب نزول آية اللعان قذف هلال بن أمية زوجته بشريك بن سحماء (9) فهذا هو السبب ، والمسبب الذي حصل من أجل هذا السبب هو نزول الآية. فورود الحديث ونزول الآية هذا هو المسبب. فالآية أو الحديث قد يكون معناها خفياً إلا إذا عرفت سبب النزول.
* * *
وقولهم : (( نزلت هذه الآية في كذا)) يراد به تارة أنه سبب النزول.
الشرح
المؤلف رحمه الله دائماً يستطرد في مؤلفاته ، فهنا استطرد للتعبير عن سبب النزول، وهو ثلاثة أنواع:
فتارة يقول: (( حصل كذا وكذا، فأنزل الله كذا))، وتارة يقول: (( سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا)) وتارة يقول: (( نزلت هذه الآية في كذا وكذا)) فهذه ثلاث صيغ.
أما قوله: (( سبب نزول الآية كذا)) فهي صريحة في أن هذا سبب النزول.
وأما قوله: (( كان كذا وكذا فأنزل الله)) فهي ظاهرة أيضاً- وليست بصريحة ، ظاهرة في أن هذا سبب النزول؛ لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبير على السببية أولي من حمله على العطف المجرد والترتيب، فيكون ظاهرها أن هذه الحادثة سبب النزول.
الثالث أن يقول ((نزلت هذه الآية في كذا)) فهذه فيها احتمال متساوي الطرفين، بين أن يكون المراد أن هذه الآية معناها كذا وكذا فيكون تفسيراً للمعنى، وبين أن يكون ذلك ذكرا لسبب النزول، فعلى الاحتمال الأول تكون (( في)) للظرفية، والظرف هنا معنوي، وعلى الاحتمال الثاني تكون (( في)) للسببية، أي بسبب كذا وكذا، و(( في )) معروف أنها تكون للسببية، ومثال ذلك : (( دخلت امرأة النار في هرة حبستها)) (10) ، (( في)) بمعنى بسبب، وليس المعني أنها دخلت في جوفها.
والحاصل أن العبارات التي يعبر بها عن أسباب النزول تنقسم ثلاثة أقسام: صريحة، وظاهرة، ومحتملة، فالصيغة الصريحة أن يقول: (( سبب نزول الآية كذا وكذا)) والظاهرة(( كان كذا فنزلت)) والمحتملة : (( نزلت في كذا)).
ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب.
* * *
ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عني بهذه الآية كذا.
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: (( نزلت هذه الآية في كذا)) هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجرى مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإنهم يدخلون مثل هذا في المسند.
الشرح
قول الصاحب: (( نزلت في كذا)) إذا أجريناه مجرى المسند صار معناه أن الأمر حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية تفسيراً له، أو بياناً لحكمه، وأما إذا جعلناه ليس جارياً مجري المسند، صار ذلك تفسيراً منه للآية، وقد يكون صواباً وقد يخالفه غيره.
* * *
فإذا عرف هذا فقول أحدهم: (( نزلت في كذا)) لا ينافي قول الآخر : (( نزلت قي كذا)) إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سبباً نزلت لأجله، وذكر الآخر سبباً، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب، ومرة لهذا السبب.
الشرح
ولكن الأول أقرب، إذا ذكر كل واحد منهما سبباً لنزول الآية بلفظ صريح أو بلفظ ظاهر على حسب ما شرحناه ، فهل نقول: إن السبب متعدد والمسبب واحد؟ أو نقول: إن السبب متعدد والمسبب متعدد وأن الآية صار لنزولها سببان؟ والأقرب الأول؛ لأن تكرر نزول الآية خلاف الأصل ، فالأصل أن الآية إذا نزلت ، نزلت مرة واحدة، فتكون الأسباب سابقة على نزول الآية، يعني معناه وجد سبب وسبب وسبب ، ثم أنزل الله الآية مبينة لحكم هذه الأمور. مع أنه نادر أن تنزل الآية مرتين وهذا إن صح.
وقد ذكر أن سورة الفاتحة نزلت مرة في مكة، ومرة في المدينة ،والله أعلم. لكن الكلام على أنه إذا تعدد ذكر الأسباب الصريحة في نزول الآية فإنها تحمل عل أحد أمرين: إما أن الأسباب متعددة والنزول واحد، وإما أن الأسباب متعددة والنزول متعدد. هذا إذا كان كل من الصيغتين صريحا في النزول، أما لو قال أحدهم: (( نزلت في كذا)) وقال الآخر: (( كان كذا فنزلت الآية)) فمعلوم أننا نقدم الثاني؛ لأنه ظاهر، وكذلك لو قال أحدهم: (( سبب نزولها كذا)) والآخر قال: (( نزلت في كذا)) فإننا نقدم الذي قال: (( سبب نزول الآية )) لأنه صريح.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأول الذي ذكر صريحاً فهو قطعاً سبب النزول ، وأما الثاني فنقول: هذا ذكر للمعنى يعني أن هذا الشيء داخل في معناه، مثل لو قيل إن قوله تعالي: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ(4)الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) (الماعون:4،5) ، نزلت هذه الآية في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فليس معناها أنه كان تأخير الصلاة عن وقتها سبباً لنزولها ؛ بل معناها الظاهر المتبادر أن هذا هو المراد من الآية، فيكون مثل هذا القول تفسيراً وليس ذكراً لسب النزول.
* * *
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير- تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
الشرح
مثال لما ذكره المؤلف رحمه الله من تنوع الأسماء والصفات مثل صارم، ومهند، ومسلول، وسيف وما أشبه ذلك، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى، مثل تفسير: ( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ) ، حيث فسر بعضهم هذا بالمصلين وهذا فسره بالمتصدقين..
* * *
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين ، إما لكونه مشتركاً في اللغة كلفظ: ( قَسْوَرَةٍ) الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ ( عَسْعَسَ) الذي يراد به إقبال الليل وإدباره.
الشرح
اللفظ المشترك سبق أن عرفناه بأنه ما اتحد لفظه وتعدد معناه؛ لأن هذا اللفظ مشترك بين معنيين، ومثاله: (( القسورة)) ، فهو مشترك بين الرامي وبين الأسد. قال تعالي: (كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ) (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) (المدثر:50،51) ، حمر الوحش إذا رأت الرامي فرت، والحمر الأهلية إذا رأت الأسد فرت، فهل المراد بالقسورة الرامي، أو المراد بذلك الأسد؟ بعضهم قال: المراد الأسد، وبعضهم قال: المراد الرامي، وما دام اللفظ صالحاً للمعنيين بدون تناقض؛ فإنه يحمل على المعنيين جميعاً.
كذلك : (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ) (17)(وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) (التكوير:17،18) ، عسعس : بعضهم يقول: يعني أدبر، وبعضهم يقول: عسعس يعني أقبل، واللفظ محتمل. إن وجد ما يرجح أحد المعنيين أخذنا به، وإلا قلنا اللفظ صالح للأمرين، فهو شامل. فيكون الله أقسم بالليل عند إقباله وعند إدباره وإذا قلنا عسعس : بمعني اقبل ليقابل قوله : (وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) (التكوير:18) ، صار من هذه الناحية أرجح.
ومثال الألفاظ المشتركة أيضاً : (القرء ) يراد به الحيض، ويراد به الطهر.
* **
وإما لكونه ، متواطئا في الأصل ، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله: ( ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) (7)(فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) (لنجم:8،9)
الشرح
يقول تعالي: (ذو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى) (6)(وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى) (7)(ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) (8)(فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى)(9) (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) (لنجم:6-10) ، الضمير في (( دنا)) يعود على جبريل ، وفي قوله: (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) الضمير يعود على الله. وهذا هو الصحيح من أقوال المفسرين ، وبعضهم قال: إن الضمائر واحدة لله.
وعلى هذا القول يكون تعالي دنا دنوا يليق بجلالة عز وجل ، مثل ما قال: (( يدنو ربنا عز وجل إلي السماء الدنيا…الحديث)) (11).
(فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) متعلقة بدنا، ويصح أن نقول: دنو الله قاب قوسين مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (( إن الذي تدعون هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)) (12) .
(أَوْ أَدْنَى) (( أو)) هذه معناها عند المفسرين ، بمعني بل، أو للتحقيق، كقوله: (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) (الصافات:147) ، أي: بل يزيدون . وبعضهم قال: إن (( أو)) هذه لتحقيق ما سبق كأنه يقول: إن لم يزيدوا لم ينقصوا ، كما تقول عندي ألف درهم أو أكثر، فإن الناس يفهمون من المعنى أن الذي عندك لا ينقص عن ألف درهم؛ بل إما أن يزيد أو يكن بقدره.
* * *
وكلفظ الفجر، والشفع ، والوتر ، وليال عشر، وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك.
فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه ، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.
الشرح
يقول المؤلف: ومن التنازع الموجود بينهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين: وذكر أن اللفظ يكون محتملاً للأمرين بإحدى واسطتين:
الأولي: أن يكون اللفظ مشتركاً؛ كلفظ العين وما أشبهها.
والثانية: أن يكون متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، والمتواطئ هو الذي طابق لفظه معناه، مثل إنسان ،حجر، شمس، قمر، وما أشبهها، فهذا نسميه متواطئاً، لأن اللفظ يطابق المعني، فهما متواطئان أي: متفقان، يقول المؤلف: إما متواطئ لكن المراد به أحد النوعين، وهذا عندما يكون في متواطئ له نوعان فيراد به أحدهما، ولكن هذا في الواقع قليل جداً، إلا أنه قد يوجد ويكون تعيين أحد النوعين بحسب السياق.
فمثلاً كلمة(مع) في اللغة العربية هي متواطئة في معناها، إذ معناها المقارنة والمصاحبة ، لكنها أنواع بحسب ما تضاف إليه، فإذا قلت: الماء مع اللبن فهو مختلط، وإذا قلت الزوجة مع زوجها، فمعناه بقاء عقد الزواج بينهما، وإذا قلت الضابط مع الجند فمعناه أنه يراعيهم، وليس بلازم أن يصاحبهم بذاته، بل يراعيهم ويلاحظهم، فكلمة (مع) الآن تجد أنها كلمة مطابقة فيها مصاحبة، لكنها اختلفت هذه المصاحبة في أنواعها باعتبار ما تضاف إليه.
ومن ذلك، الضمائر التي أشار إليها المؤلف، فإذا اختلفوا فيها فإننا نقول: إذا كانت الضمائر صالحة للمعنيين، فهو اختلاف تنوع وكل واحد منهم ذكر نوعا، وإذا لم تكن صالحة، فهو اختلاف تضاد، ثم إنه تعرض المؤلف -رحمه الله -إلى أن المشترك هل يجوز أن يراد به معنياه؟ والصواب أنه يجوز أن يراد به معنياه إذا لم يتنافيا، مثل ما مضي في (قسورة) يجوز أن يراد بها المعنيان، ويكون كل معنى كالمثال ، فيكون الله عز وجل أراد بقوله : (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) .أي: من الرامي فهم كحمر الوحش إذا رأت الرامي، أو المراد به الأسد فهم كالحمير الأهلية إذا رأت الأسد فرت ، لأنه ليس عندنا قرينة تؤيد أحد المعنيين واللفظ صالح لهما ولا مناقضة بينهما .
أما لو كان بينهما مناقضة فإنه لا يمكن أن يراد به المعنيان ، مثل (القرء) بمعنى الطهر وبمعني الحيض، فلا يمكن أن نقول الآية صالحة للمعنيين جميعاً، لأنه يختلف الحكم ولا يمكن أن يجتمعا , ومثل (( من راح في الساعة الأولى)) (13) الرواح يطلق على المسير بعد زوال الشمس ، ويطلق على مجرد المسير، فهو مشترك بين مطلق الذهاب وبين نوع معين من الذهاب وهو المسير بعد زوال الشمس، ولذلك لا يمكن الجمع بينهما؛ لأنك لو قلت: من راح في الساعة الأولى معناه أن الساعات بعد الزوال، فمعناه لا تبتدئ رواحك للجمعة إلا بعد زوال الشمس، وعلى هذا تكون الساعات دقائق، لأن الإمام إذا زالت الشمس حضر، وإذا قلنا بأن الرواح مطلق الذهاب صار الرواح يبتدئ من أول النهار، أي من طلوع الشمس.
قوله: (وَالْفَجْرِ) (1)(وَلَيَالٍ عَشْرٍ) (الفجر:1،2) ،(وَلَيَالٍ عَشْرٍ) ، فيها قولان:
فبعضهم قال: هي ليالي عشر رمضان، وبعضهم قال: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ) هي عشر ذي الحجة، فصار فيها قولان لاشتراك اللفظ، كذلك (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) (الفجر:3) بعضهم قال الوتر: الله، والشفع:المخلوق ، لأنه قال: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن)(الذريات: 49)
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (( إن الله وتر)) (14) وبعضهم قال: (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) هو العدد ، لأن كل الخلائق متعددة إما إلي شفع وإما إلي وتر، واللفظ صالح للمعنيين جميعاً.
والصلاة وتر، لأن صلاة الليل تختم بالوتر فتكون وترا، وصلاة النهار تختم بالوتر فتكون وتراً، ولا ينافي ذلك كون صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة العصر أربع ركعات، فإن صلاة المغرب وتر، وهذه أوترت تلك، يعني أن المغرب جعلت ما سبق وتراً، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إنها وتر النهار)) (15) . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إذا خشي أحدكم الصبح صلي واحدة فأوترت له ما قد صلي )) (16) والراجح أنها شاملة للمعنيين؛ لأنه كلما كانت الآية تتضمن معنيين لا يتنافيان تحمل عليهما.
ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة الأقوال ، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن.
الشرح
يقول المؤلف رحمه الله: الترادف في اللغة العربية قليل، لأن الترادف في الحقيقة عبارة عن تضخم اللفظ، وكلام المؤلف صحيح بالنسبة للمعاني، أما بالنسبة للأعيان فإن الترادف فيها كثير، فكم للهر من اسم؟ وكم للأسد من اسم؟ وهكذا، المعاني صحيح أن الترادف فيها قليل ولكن مع ذلك موجود ولا يمكن أن ينكر، فمثلاً بر، وقمح، وحب، وعندنا باللغة العامية عيش هذا مترادف وهو كثير. وفي القرآن يقول: إنه نادر بمعنى أنه لا يمكن أن تأتي كلمة بمعنى كلمة في القرآن،ولكن هناك كلمة (( الشك))في قوله تعالي: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ)(يونس: 94) وهناك كلمة ( رَيْبَ) ، (( لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ))(البقرة:2) يظن بعض الناس أن الشك والريب معناهما واحد وليس كذلك كما سيذكر المؤلف، فحينئذ الترادف من كل وجه يقول إنه نادر أو معدوم. قوله: ( وقل أن يعبر عن لفظ واحد ،بلفظ واحد يؤدي جميع معناه) قوله: (( بلفظ واحد)) يعني مغاير أي غير الأول(( عن لفظ واحد بلفظ آخر )) يعني آخر لو ،وقال المؤلف: (( عن لفظ واحد بلفظ واحد )) لكان أبين وأوضح ، وهذا هو مراده.
* * *
فإذا قال القائل: (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً) (الطور:9) إن المور هو الحركة ،كان تقريباً، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال: الوحي الإعلام، أو قيل: ( أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ) أنزلنا إليك، أو قيل: (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائيل)(الاسراء: من الآية4) أي أعلمنا. وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام ، فإن فيه إنزالاً إليهم وإيحاء إليهم والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته.
الشرح
يعنى الذين قالوا: إن معنى قوله تعالي: (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً) أي: تتحرك ، يقول هذا تقريباً، لأن المور حرك خفيفة سريعة وليست مطلق حركة، كذلك إذا قال الوحي هو الإعلام .أوحى الله إلى نبيه يعني أعلمه بكذا، فهذا أيضاً تفسير تقريبي، أو قال: (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائيل) يقول: أي أعلمنا إليهم، هذا أيضاً تقريبي؛ لأن معني قضينا إليهم أخص من أعلمنا؛ لأن معناها قضينا إليهم، يعني قضاء قدرياً واصلاً إليهم فهو ليس بمعنى مجرد الإعلام.
وبين المؤلف ذلك فقال: (( فإن الوحي هو إعلام سريع خفي. والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالاً إليهم وإيحاء إليهم والعرب تضمن الفعل معني الفعل وتعديه تعديته)) وهذا معروف وهو التضمين، بأن يضمن فعل معني فعل فيكون متعدياً تعدي ذلك الفعل.
ومثال ذلك وهو من أوضح الأمثلة قوله تعالي: (عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّه)(الانسان: 6)، فالفعل يشرب ضمن معني يروي بها؛ لأنه ليس معقولاً أنهم يشربون بالعين، بل إنهم يشربون بالكاس، فبعضهم قال: إن معني (( بها)) أي: منها، وبعضهم قال: معني يشرب أي يروى بها، فيكون الفعل هنا مضمناً للشرب إعدالاً عن الشرب بلفظه ودالاً على المعنى وهو الري بمتعلقه وهو قوله( بها).
* * *
ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله: (قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ)(صّ: 24) أي مع نعاجه و(( مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّه)(آل عمران: 52)أي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلي نعاجه.
الشرح
وذلك لأن علماء النحو اختلفوا فيما إذا تعدى الفعل بغير ما يتعدى به في الأصل . هل يكون التجوز في الحرف أو أنه في الفعل، والصحيح كما قال أنه بالفعل ، فيضمن الفعل معنى يتعدى بمثله إلي ما هو متعد إليه الآن وهنا (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ) أي: بضم السؤال هنا ضمن معني الضم، أي: ضم نعجتك إلي نعاجه، وليس المعنى بسؤال نعجتك مع نعاجه. أي ليس المعنى أن نجعل إلي بمعنى مع، كذلك ( مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّه) ، يقول : ( مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّه) أي مع الله، أي من أنصاري مع الله، وليس الأمر كذلك، بل المعني من ينيب معي إلى الله؛ لأن أنصاري إلي الله يعني منيبين إليه، كما قال تعالى: (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ )(الروم: 31).
* * *
وكذلك قوله: (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك)(الاسراء: 73) ضمن معني يزيغونك ويصدونك ، وكذلك قوله(وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا)(الانبياء:77) ضمن معني نجيناه وخلصناه ، وكذلك قوله ( يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّه)(الانسان:6)، ضمن يروي بها، ونظائره كثيرة.
الشرح
لماذا هنا قلنا إن تضمين الفعل أولى من التجوز بمعنى الحرف؟ لأن تضمين الفعل يؤدي معنى زائداً على معنى الفعل، بخلاف ما إذا جعلنا الحرف متجوزاً فيه فإنه يبقي الفعل على دلالته لمعناه فقط، ونحول معنى الحرف إلي معنى يناسب لفظ الفعل، فالتضمين إذاً أوضح وأولى.
قوله تعالي: (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ) (المعارج:1) ، على رأي من يرى التجوز بالحرف يقول: سأل سائل عن عذاب واقع،وعلى القول الثاني سأل سائل مهتما بعذاب واقع. فيكون ضمن سأل بمعنى اهتم به وبحث ، حتى سأله عنه، أو يقال : سأل سائل أخبر بعذاب واقع، فيكون السؤال هنا مضمناً معنى الإخبار، يعني: سأل عن العذاب فأخبر بالعذاب.
* * *
ومن قال: (( لا ريب)) لا شك) فهذا تقريب . وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال: (( دع ما يريبك إلي ما لا يريبك)) (17) وفي الحديث: أنه مر بظبي حاقف فقال: (( لا يريبه أحد)) (18) ، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة ، فالريب ضده(( ضمن الاضطراب والحركة)) لفظ الشك وإن قيل : إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل: ( ذلك الْكِتَاب)(البقرة: 2) هذا القرآن فهذا تقريب؛ لأن المشار إليه وإن كان واحداً، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، ولفظ (( الكتاب)) يتضمن من كونه مكتوباً مضموماً ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهراً باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن.
الشرح
أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا الكلام أن العلماء قد يفسرون اللفظ بما يقاربه لا بما يطابقه، تقريباً للأذهان فمثلاً، (ذَلِكَ الْكِتَاب) إذا قال أي: هذا القرآن فهذا التفسير تقريبي، لأن إبداله ذلك بهذا يختلف به المعنى، فالإشارة بالبعد تتضمن من المعنى ما لا تتضمنه الإشارة بالقرب، والكتاب يتضمن ما لا يتضمنه القرآن،من كون الكتاب مجموعاً ، وهذا معني قول المؤلف مضموناً، فإن الكتاب من الكتب بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة لجماعة الخيل؛ لأنها مجتمعة.
* * *
فإذا قال أحدهم: (( أن تبسل)) أي: تحبس ، وقال الآخر، ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى، كما تقدم.
وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداً؛ لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.
الشرح
وذلك لأن عباراتهم المختلفة في اللفظ توجب للإنسان أن يحيط بكل ما تحتمله الكلمة من معنى قاله السلف، ومن أجمع ما يكون في ذلك تفسير ابن جرير- رحمه الله- فإنه جمع من ألفاظهم ما لم يجتمع في غيره، وتفسير ابن كثير كالمختصر له؛ لأنه إذا قال معنى الآية كذا وكذا قال: هكذا قال فلان وفلان وفلان، وعدد المفسرين القائلين بذلك، الذين أتى بهم ابن جرير بالسند، فشيخ الإسلام رحمة الله يقول: (( جمع العبارات في هذا نافع)) لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.
* * *
ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق (19) معلوم: بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها، وفرائض الزكاة ونصبها، وتعيين شهر رمضان، والطواف، والوقوف، ورمي الجمار، والمواقيت وغير ذلك، ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريباً في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء ، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة. ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض؛ كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب ، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلي الله عليه وسلم .
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون لغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
الشرح
المؤلف رحمه الله يقول: هذا الاختلاف قد يكون لأحد الأسباب لكن هذه الأسباب ليست شاملة؛ لأن أسباب اختلاف العلماء ذكرها رحمه الله في كتاب (( رفع الملام عن الأئمة الأعلام)) أكثر من هذه الأسباب ، فهنا يقول : (( قد يكن لخفاء الدليل)) ، ويخفي الدليل بمعنى أنه لا يظن أن هذا دليل على كذا، فهو سمعه لكن خفي عليه أنه دليل، وقد يذهل عنه، أي: يكون ذاكراً له ولكن نسيه، وقد يكون لعدم سماعه وهذا هو الجهل، وقد يكون الغلط في فهم النص، وهذا قصور الفهم، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، يعني أنه فاهم الدليل، وعالم به لكنه اعتقد أن هناك معارضاً راجحاً يمنع القول بهذا الدليل، إما تخصيص ، أو نص، أو تقييد، أو ما أشبه ذلك، ومن أراد البسط في هذا فليرجع إلي كتاب المؤلف رحمه الله وهو: (( رفع الملام عن الأئمة الأعلام)) ، وكذلك كتاب لنا صغير كالملخص لكن فيه زيادة تمثيل واسمه: (( الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه)).
* * *
(5) رواه الترمذي ،كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن، رقم (2906)، والدارمي ، كتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن، (3331).
(6) رواه الترمذي كتاب الأمثال ، باب ما جاء في مثل الله لعباده، (2859).
(7) رواه البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها ، (725) ومسلم ، كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ، (85).
(8) رواه البخاري، كتاب الصوم باب قول النبي صلي الله عليه وسلم لمن ظلل عليه …، (1946)، ومسلم، كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (1115).
(9) رواه أبو داود، كتاب الطلاق باب في اللعان، (2254).
(10) رواه البخاري، كتاب المساقاةباب فضل سقي الماء (2365)، ومسلم، كتاب التوبة باب في سعة الله تعالى وأنها سبقت غضبه(2619).
(11) رواه الطبراني في الدعاء(1/59)
(12) رواه أحمد في المسند( 4/402)
(13) رواه مالك في الموطأ (1/101).
(14) رواه البخاري ، كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد، (6410)، ومسلم، كتاب الذكر ، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (2677).
(15) رواه الترمذي، كتاب الجمعة باب ما جاء في التطوع في السفر، ( 0552).
(16) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، رقم (472)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثني مثني، رقم (749).
(17) رواه البخاري ، كتاب البيوع باب تفسير المشبهات بدون رقم.
(18) أخرجه النسائي، كتاب مناسك الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، رقم (2817).
(19) قال شيخنا: عندي في حاشية نسختي: (( لعله من الأحكام)) وهذه الرسالة قرأتها على سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز، والتعليق من إملائه، وعندي (( من الاتفاق)) أحسن.