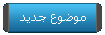الخطبة الأولى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخليله وأمينه على وحيه، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على محجة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، إلى يوم الدين.
أما بعد:
فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واشكروه على ما أنعم به عليكم في هذه البلاد من نعمة الدين والدنيا، نعمة الدين التي مبناها على التوحيد، وعلى إقامة شريعة الله من غير إشراك ولا ابتداع، فإن أسلم بلاد العالم من هذين الوبائين العظيمين المهلكين الفتاكين - الإشراك والابتداع - فيما نعلم هي هذه البلاد ولله الحمد، فنسأل الله - تعالى - أن يزيدنا من فضله، وأن يجعل هذه البلاد قادتها من علماء وأمراء نبراساً يهتدى بهم في جميع بلاد المسلمين.
أيها الإخوة، إن الله - تعالى - أنعم علينا حينما أرسل إلينا رسولاً يتلو علينا آيات الله، يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، أبقى الله - تعالى - هذا الدين متلواً في كتاب الله غير مبدل ولا مغير، مأثوراً فيما صح من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنقولة إلينا بنقل العدول الثقاة الإثبات، وذلك من نعمة الله علينا، نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها ظاهراً وباطناً.
أيها الإخوة، إن من نعمة الله على عباده ما خولهم من المال والبنين؛ الذي جعله قياماً لهم في دينهم ودنياهم، خادم لهم في أمورهم، ليس مستخدماً لهم؛ ولهذا ضل في دينه وسفه في عقله من كان خادماً للمال، والحقيقة أن المال هو الخادم لبني الإنسان، إن من نعمة الله علينا أن بيَّن الله - عز وجل - لنا كيف نكتسب هذا المال، وكيف نتصرف فيه بعد اكتسابه في الحياة وفي الممات، فاعرفوا - أيها المسلمون - اعرفوا حقيقة هذا المال، اعرفوا قدره، فإنه إما أن يكون طريقاً إلى الجنة وإما أن يكون طريقاً إلى النار: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً﴾ [المزمل: 20].
أيها الإخوة، إن مالكم في الحقيقة هو ما قدمتموه لأنفسكم ذخراً عند الله، وليس مالكم الذي تجمعونه في الصناديق فيقتسمه الوارث بعدكم، إنكم سوف تخلفون المال الذي تجمعونه وسوف تتركونه وراء ظهوركم؛ كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ [الأنعام: 94]، فسوف تنتقلون عن الدنيا أغنياء عما خلفتم، فقراء إلى ما قدتم، لن يدفع الإنسان من ماله في الدنيا إلا خرقة يكفن بها وطيب يكون في تلك الخرقة، وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟" استمع لهذا السؤال، "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟"، الجواب قالوا:يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر"(1)، إذاً: قدم لنفسك حتى تنتفع بمالك، فإما أن تقدم فتنتفع به وإما أن تؤخر فينتفع به الوارث، وفي الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بها سوى كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه قد بقي كلها غير كتفها"(2)؛ لأنهم تصدقوا بها إلا الكتف، فكان الذي تصدقوا به هو الباقي، وأما الكتف فسوف يؤكل وسوف يكون مآله إلى المرحاض بيت الخلاء.
أيها المسلمون، إنكم مسؤولون عن المال في استيراده وفي اكتسابه وفي إنفاقه، ولكن الموفق هو الذي يكتسبه من طريق حلال، وينفقه فيما يقرب إلى الكبير المتعال، وإن من إنفاق المال المقرب إلى الله أن يتصدق به المرء صدقة منجزة على الفقراء والأقارب، فيملكونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وذلك من أفضل الأعمال وأربح التجارة؛ لما نزل قول الله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، جاء أبو طلحة - رضي الله عنه - وكان له حديقة قبلتها مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمى بيرحاء، كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، وفي دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - لها وشربه من مائها ما يزيدها غلاء في قلب مالكها أبي طلحة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن الله أنزل هذه الآية - يعني قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 192] - وإن أحب مالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها ودخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بخ بخ ذاك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت - أي: سمعت ما قلت -وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين"(3)، فقسمها أبو طلحة - رضي الله عنه - في أقاربه وبني عمه، وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به وهو يتأول هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 192]، ومن أفضل ما تنفق فيه الأموال أن يصرف الإنسان ماله في بناء المساجد والمشاركة فيها، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة"(4)، من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله لا يريد بذلك ثناءً من الناس، ولا مدحاً عند الناس؛ ولهذا نرى أن الإنسان إذا بنى مسجداً فلا ينبغي أن يكتب اسمه عليه؛ لأنه يخشى أن يكون في كتابة اسمه عليه شيء من الرياء، بل يجعله مسجداً يصلى فيه ويسمى بالاسم الذي ترتضيه الجهات المسؤولة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة"(5)، المساجد يصلي فيها المسلمون، ويأوي إليها المحتاجون، ويذكر فيها اسم الله بتلاوة كتابه، وسنة رسوله، والفقه في دينه، وفي كل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها، الناس يصلون فيها في رمضان فينال الذي بناها أجر من صلاتهم فيها، يصلون فيها فرائض الله في كل العام فينال بانيها من الأجر ما يناله أجر صلاتهم فيها، وهذا كل يوم، حتى وإن كان في قبره فهو والله من أفضل الأعمال والصدقات الجارية، ومن إنفاق المال في دروب الخير أن ينفقه في طبع الكتب النافعة والنشرات الهادفة، سواء كان ذلك في كتب أو رسائل أو أشرطة؛ لأن في ذلك نشر لشريعة الله عز وجل، ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه في المصالح العامة؛ كإصلاح الطرق، وتأمين المياه، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - حين قدموا إلى المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومه، لا يحصنون الماء منها إلا بثمن فاشتراها عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من حفر رومه فله الجنة"(6) فحفرها عثمان رضي الله عنه، ومن إنفاق المال في طرق الخير تحبيسه وإنفاق غلته، يعني: المال الذي يأتي من الأجرة فيما يقرب إلى الله، وهو الذي تسمونه الوقف أو السبيل، ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أصاب أرضاً بخيبر لم يصب مالاً أغلى عنده منه، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيره فيها ويستأمره أن يطلب مشورته وأمره، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"(7)، وفي رواية للبخاري: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره"(8)، وفي رواية للنسائي: "احبس أصلها وسبل ثمرتها"(9)، فتصدق به عمر - رضي الله عنه - تصدق بها على من حبسها على ذريته يتقاتلون عليها، لا أسمع مصارف وقف عمر رضي الله عنه، تصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى، ولم يخص الذرية، وجعل ذي القربى آخر المصارف رضي الله عنه؛ لأن المقصود بالوقف هو التقرب إلى الله عز وجل، فإذا سبل الإنسان ملكه وقال: هو سبيل أو هو وقف أو ما أشبه ذلك صار وقفاً محبوساً من حين أن ينطق بذلك لا يباع ولا يوهب ولا يورث، حتى الذي وقفه لا يمكنه التصرف فيه، وإنما يصرف فيما جعله الواقف فيه ما لم يكن إثما.
أيها الإخوة، إن المقصود بالوقف أمران عظيمان؛ أولهما: التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب منه ببذل غلة الوقف فيما يرضي الله تعالى ويقرب إليه، وثانيهما: نفع الموقوف عليهم والإحسان إليهم، وإذا كان المقصود به التقرب إلى الله فإنه لا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله ورسوله، إذاً لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بطاعته، فلا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض؛ لأن الله - تعالى - أمر بالعدل، فقال جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ [النحل: 9]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"(10)، والوقف على بعض الأولاد دون البعض منافٍ للعدل، إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق مطلوبة شرعاً توجد في أحدهم دون الآخر، مثل أن يوقف على الفقير من أولاده، أو على طالب العلم منهم فلا بأس حينئذٍ؛ لأنه وقفه على جهة مطلوبة، فإذا وقفه على الفقير منهم فلا حظ فيه للغني حال غناه، وإذا وقفه على طالب علم فلا حظ فيه لغير طالب العلم حال تخليه عن الطلب، ولا يجوز أن يوقف شيئاً من ماله وعليه دين لا وفاء له من غير ما وقفه حتى يوفي دينه؛ لأن إيقافه إضرار بغريمه، ووفاء الدين أهم من الوقف؛ لأن قضاء الدين واجب والوقف تطوع، ولا يجوز أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض؛ لأن الله - تعالى - قسم المال بين الورثة وقال:﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: 11، التوبة: 60]، وفي الآية الثانية: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّه﴾ [النساء: 12] وبين أن لا يتعداها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"(11)، وقد كان بعض الناس يوصي لبعض أولاده أو بعض ورثته وهذا حرام عليه، فإذا قال الإنسان: أوصيت بداري وقفاً على ذريتي وله ورثة غير الذرية كان ذلك خروجاً عن فريضة الله وإخلال بوصية الله، متعدياً لحدود الله، ومعصية لرسول الله، فليحذر الإنسان هذه المحذورات الأربعة: الخروج عن فريضة الله، والإخلال بوصية الله، التعدي لحدود الله، ومعصية رسول الله، أتريد يا أخي وأنت في قبرك أن تعذب على هذا الجور؟ إن أحداً لا يريد ذلك أبداً، ومن كان عنده وصية على هذه الوجه فعليه أن يغيرها ويجعلها على الوجه الشرعي قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يؤخذ بغتة وهو لا يشعر.
أيها المسلمون، إذا كان المقصود بالوقف هو التقرب إلى الله عز وجل ونفع الموقوف عليهم، ينبغي للإنسان أن ينظر ما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده، ولينظر في النتائج المترتبة على وقفه، وليتجنب ما يكون سبباً للعداوة والقطيعة، ولقد بلغنا أن أبناء العم يتخاصمون ويتحاكمون عند القضاة ويتعادون ويتهاجرون حينما يشتركون في وقف قد لا ينال الواحد منهم إلا عشرة دراهم أو نحوها، ولكنهم عند الشح والطمع لا يبالون بما أوجب الله عليهم من الصلة وبما حرم عليهم من القطيعة، وإذا كان الإنسان يريد الخير فليبتعد عن النتائج السيئة، وليعلم الإنسان حق العلم أن إنفاق المال في الحياة والصحة خير وأفضل وأعظم أجراً، لا سيما إذا كان في صالح مستمر؛ كبناء المساجد، وإصلاح الطرق، وتأمين المياه، وطبع الكتب النافعة، أو شرائها وتوزيعها على من ينتفع بها، وإعانة في زواج فقير يحصنه ويحصن زوجته، وربما يولد بينهما ولد صالح ينفع المسلمين، فهو مصلحة وأجر لمن أعانه على زواجه، قد يقول قائل: ربما أعين شخصاً على أن يتزوج ثم يولد له ولد فاسد يفسد الدين والدنيا، فنقول: إن ذلك لا يضرك، لأنك إنما بذلت لله عز وجل وصدقتك مقبولة، ومن الأمور النافعة أن تصرف الأموال في جمعيات تحفيظ القرآن؛ لأن حفظ القرآن الكريم حفظ لكلام الرب عز وجل؛ ولهذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"(12)، ومن المعلوم أن المشارك في هذه الجمعيات مشارك في تعليم القرآن وتعلم القرآن، ومن المعلوم - أيضاً - أن مثل هذه الجمعيات لا تقوم إلا بمال، فإذا ساعد الإنسان بماله فيها فقد ساعد - بلا شك - على تعلم القرآن وتعليمه، وما أحسن أن يخرج طفل من المسلمين يحفظ القرآن يحفظ كلام الله وأنت مشارك في تعليمه، إن هذا لهو الفوز العظيم، وفي صحيح مسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ وفي لفظ: أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: "أن تصدق" استمع قال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء"، أي: تخاف إن تصدقت أن تفتقر، وتخاف أن تعمر في الدنيا فتحتاج إلى المال، يقول عليه الصلاة والسلام: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل - أي: لا تتأخر - حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان: كذا، ولفلان: كذا - أي: تصدقوا على فلان بكذا وفلان بكذا - وقد كان لفلان أي قد كان لفلان الوارث"(13)، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الصدقة في حال الصحة أفضل؛ لأنها صدقة من شخص يخاف الفقر ويأمل البقاء، فهو شحيح بالمال لذلك، بخلاف من جعل تنفيذ المال بعد يأسه من الحياة وانتقال المال للوارث، وقد تصدق الله عز وجل على عباده بثلث أموالهم، يوصون بها بعد موتهم لأقاربهم غير الوارثين أو للفقراء أو لبناء المساجد أو لغيرها من طرق الخير، وإذا كان الورثة ليسوا ميسوري الحال فالأفضل ألا يوصي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد بن أبي وقاص حين أراد الوصية قال له: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"(14)، وقد كان بعض الناس يظن أن الوصية أفضل ولو كان وراثه محتاجين، وهذا قصور نظر في الواقع وجهل بالشريعة، إن بقاء المال للوارث الذي يحتاج إليه أفضل من الصدقة به؛ لأنه ينتفع به القريب، وإذا أوصى الإنسان بشيء من ماله فله الرجوع في وصيته، وهذا بخلاف الوقف فإن الوقف ينفذ من حينه ولا يمكنه الرجوع فيه، أما الوصية فلا، فله الرجوع في وصيته بإبطالها، وله أن يغيرها وينقصها ويزيدها في حدود ثلث المال، فالوصية أوسع من الوقف لغير الوارث من هذه الناحية ومن ناحية جوازها، ولو كان على الإنسان دين - أعني: أنه يجوز للإنسان أن يوصي ولو كان عليه دين - وذلك لأن الوصية لا تضر أهل الطلب؛ لأن الدين مقدم على الوصية، أما الوقف فإنه ينفذ في الحال، ولكن كما قلت لكم أولاً لا يجوز لمن عليه دين لا يوفي به إلا مما أوقف، لا يجوز أن يوقف؛ لأن ذلك إضرار بالغرماء، أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممَن امتثلوا أمر الله - تعالى - في قوله:﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فيا عباد الله، إن الأمر كله لله، إليه يرجع الأمر كله، وهو الحكم والحاكم بين عباده، والحاكم في عباده، تبارك وتعالى فلا فضل في شيء إلا ما فضله الله، سواء كان ذلك في زمان أو مكان أو عمل أو أمة: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ [البقرة: 253].
أيها الإخوة، إن فضائل الزمان وفضائل المكان لا تتلقى من عقل فلان وفلان، ولا من ذوق فلان وفلان، وإنما تتلقى من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الله عز وجل، فهو الذي يفضل من شاء ويفضل ما شاء، وقد تكلمنا في أول هذا الشهر شهر رجب على أن شهر رجب ليس فيه عبادات مخصوصة من بين سائر الشهور غير أنه من الأشهر الحرم الأربعة؛ وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، وكان الناس يعتمرون فيه؛ لأنه شهر محرم لا قتال فيه في الجاهلية، فكانوا يختارونه لأداء العمرة لهذا السبب؛ كما كانت الأشهر الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم كانت أشهر الحج؛ لأن الناس يسافرون إلى الحج شهراً ويرجعون شهراً، وربما يقيمون في مكة شهراً أو دون ذلك، المهم أن الناس كانوا يختارون شهر رجب للعمرة من أجل ذلك وليس من أجل خصوصيتها في هذا الشهر، نعم شهر رمضان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة"(15)، وبينا - أيضا - أن ليلة سبع وعشرين من هذا الشهر وهي التي بعد الليلة القادمة أنها ليست ليلة المعراج؛ لأن ذلك لم يثبت في أي تاريخ بسند صحيح، وإذا كان لم يثبت فإنه لا عبرة به؛ لأن الأخبار مرجعه النقل فقط ولا مدخل للعقل فيها، وكذلك - أيضاً - لو صح أن ليلة سبع وعشرين من هذا الشهر فإنه لا يجوز إحداث أي شيء فيها من الشعائر الدينية أو العرفية؛ لأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن المؤسف جداً أن كثيراً من المسلمين اليوم يحتفلون بهذه الليلة - أعنى: ليلة سبع وعشرين من رجب - يدعون أنها ليلة المعراج، وليس لهم أصل خبري صحيح يبنون عليه، وليس لهم أصل صحيح شرعي يعتمدون عليه، فعملهم إذاًً لا أصل له من الناحية التاريخية، ولا أصل له من الناحية الشرعية، وإذا كلفوا بالأمور التي دون ذلك مشقة من الأمور الثابتة شرعا مما يحبه الله ويرضاه تجدهم يتكاسلون ويتأخرون، ربما يكون هؤلاء الذين يعظمون هذه الليلة ويحتفلون بها ربما يكون كثير منهم لا يشهدون صلاة الجماعة، مع أن الاجتماع على الصلوات الخمس من الأمور المشروعة بل الأمور المفروضة إلا من عذر، وهذا مما يدل على ضعف الإيمان في قلوب كثير من الناس، وعلى هشاشة الإسلام في قلوبهم، وإلا لو كان الإنسان حراً طليقاً من الهواء لم يتبع إلا ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من قول أو فعل، وكذلك الشهر الثاني الذي يليه - أعني: شهر شعبان - فيه - أيضاً - أشياء كثيرة لا أصل لها، وأنا أجملتها في هذه الخطبة وإن كان بعضها لم يحن بعد، ولكن جمع الشيء يكون أنفع وأكثر، فمن ذلك صيام شهر شعبان، هل هو مشروع من بين سائر الشهور؟ نعم، هو مشروع، قالت عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان"، إذاً لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم الشهر المحرم كاملاً تقول: "وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان"(16) إذاً كان يصوم في شعبان أكثر ما يصوم في المحرم، وفي البخاري قالت: "كان يصوم شعبان كله"(17) وفي رواية مسلم: "كان يصومه إلا قليلا"(18) وهذه هي المعتمدة، أعني: رواية مسلم مقدمة في هذه المسألة على رواية البخاري، ولكن تحمل رواية البخاري على أن إطلاق الكل يراد بها الغالب؛ ليوافق قولها: "ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان"، ثانياً: صيام النصف فيه؛ هل صيام نصفه مشروع؟ الجواب: فيه حديث عن علي - رضي الله عنه - عند ابن ماجة، ذكر ابن رجب في اللطائف أن إسناده ضعيف، وقال صاحب المنار: والصواب أنه موضوع - أي: مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا فلا يعتمد تخصيصه بصوم، واعتماد تخصيصه بصوم من البدع؛ لأن السنة لم تثبت بذلك، ثالثاً: فضل ليلة النصف منه - أي: من شعبان - وردت فيه أخبار، قال عنها ابن رجب - رحمه الله - في (اللطائف): ضعفها الأكثرون، وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنها ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، رابعاً: قيام ليلة النصف منه - أي: من شعبان - لم يرد فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث يصح الاعتماد عليه، لا قيامها مطلقاً ولا مقيداً بعدد، وغاية ما جاء في تخصيصها أن بعض التابعين من أهل الشام عظموها واجتهدوا في العبادة فيها، قال بن رجب في (اللطائف): وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل - يقول ابن رجب -: أنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز - يعني: في عصر التابعين - وقالوا ذلك كله بدعة، ومن المعلوم أن علماء الحجاز من التابعين أقرب إلى الصواب من علماء الشام؛ لأن السنة جاءت من قبلهم وانتشرت منهم، وقال - أيضاً - أعني: ابن رجب -: لم يثبت فيها عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا عن أصحابه شيء، وقال صاحب (المنار): إن الله لم يشرع للمؤمنين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في سنته عملاً خاصاً بهذه الليلة، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: ما ورد في فضل الصلاة في تلك الليلة فكله موضوع، والموضوع عند المحدثين هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خامساً: اشتهر عند كثير من العوام أن ليلة النصف منه يقدر فيها ما يكون في العام، وهذا باطل بنص القرآن؛ لأن هذا خاص بليلة القدر؛ كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1]، وليلة القدر هي الليلة التي قال الله فيها: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 3] وفي رمضان قطعاً؛ لقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: 185]، سادساً: إطعام الطعام يوم النصف منه، أدركنا الناس قديماً يصنعون يوم النصف من شعبان عشاء يقولون: إنه عشاء الوالدين يوزعونه على الجيران والأقارب، وهذا لا أصل له عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا عن سلف الأمة، وما ليس كذلك من أمور الدين فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، ولقد ألهم الله نبيه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يعلن في خطب الجمعة أن كل بدعة ضلالة، وأن يقول عليه الصلاة والسلام: "إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"(19)، يقول ذلك معلناً في كل أسبوع على الأمة حذراً من هذه البدع التي انتشرت في العالم الإسلامي، نسأل الله تعالى أن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه.
أيها الإخوة، "إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"(20)، فالتزموا شريعة الله، أخلصوا لله، لا تبتدعوا في دين الله، والله لن ينفعكم ذلك ولن يزدكم من الله إلا بعداً، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم تقبل منا يا رب العالمين.
عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؛ امتثالاً لأمر الله، وأداء لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [الأحزاب: 56]، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد.
---------------------
(1) أخرجه مسلم، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (6442).
(2) أخرجه أحمد (6/50)، والترمذي (2470)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة (998)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البخاري (1461).
(4) أخرجه مسلم، من كتاب المساجد، باب فضل بناء المساجد والحث عليها (533)، وأخرجه البخاري (450)، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(5) سبق تخريجه.
(6) أخرجه البخاري تعليقاً (2778)، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، انظر: فتح الباري (5/496-499) (2778).
(7) أخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632)، من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(8) أخرجه البخاري (2764)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(9) أخرجه النسائي (6/232) (3605-3607)، من حديث عمر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(10) أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
(11) أخرجه أحمد (4/186)، وأبو داود (3565)، وابن ماجه (2713)، والترمذي (2120)، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
(12) أخرجه البخاري، في كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (5027)، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(13) أخرجه البخاري (1419)، ومسلم (1032)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(14) أخرجه البخاري، في كتاب الوصايا، باب (2) أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكففوا الناس (2742) الفتح (5/362)، ومسلم، في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (1628) (3/1250-1253).
(15) أخرجه البخاري، في كتاب العمرة، باب (4) عمرة في رمضان (1782)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان (757)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(16) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم شعبان (1833)، ومسلم، في كتاب الصيام، في باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب ألا يخلي شهراً عن صوم (1958)، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
(17) أخرجه البخاري، في كتاب الصوم، باب صوم شعبان (1834)، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
(18) أخرجه مسلم، في كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب ألا يخلي شهراً عن صوم (1957)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(19) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (8671)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(20) سبق تخريجه.
من موقع بن عثيمين