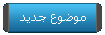«الجزء الثالث»
«الجزء الثالث»
فـصل
[ في بناء العام على الخاص ]
• قال المصنِّف ‑رحمه الله‑ في [ص 196]:
«إِذَا تَعَارَضَ لَفْظَانِ خَاصٌّ وَعَامٌّ بُنِيَ العَامُّ عَلَى الخَاصِّ، مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أَنَّهُ قَالَ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»(1)، فَاقْتَضَى ذَلِكَ نَفْيَ كُلِّ صَلاَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(2)، فَأَخْرَجَ بهَذَا اللَّفْظِ الخَاصِّ الصَّلاَةَ المَنْسِيَّةَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهَا بَعْدَ العَصْرِ، سَوَاءٌ كَانَ الخَاصُّ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا».
[م] التمثيل بهذين الحديثين في هذا المقام يضعه علماء الأصول ‑أيضًا‑ مثالاً في مسألة أخرى تعرف ب «تعارض عمومين من كلٍّ وجه» أي أن يكون أحد اللفظين عامًّا من وجه خاصًّا من وجه آخر، فالحديث الأوّل النهي فيه عامٌّ في الصلاة خاصّ في الوقت، والحديث الثاني الأمر فيه عامٌّ في الوقت خاصٌّ في الصلاة، ومن هذا القبيل الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامّ في الوقت خاصّ في الكلام، والنهي عن الكلام حال خطبة الجمعة عامّ في كلّ كلام خاصّ في الوقت، وكذلك الأمر بتحية المسجد عامّ في الوقت خاصّ بالصلاة، والنهي عن الصلاة بعد العصر عامّ في الصلاة خاصّ في الوقت، وفي مثل هذه المسائل ينبغي سلوك المراتب التدريجية، وعند من قال بالترجيح يرى تعذَّر التوفيق الصحيح والجمع المقبول بين عموم الأمر بالصلاة أو الإنصات وعدمه من جهة، وبين خصوص كلا العمومين من وجه معارض بخصوص الآخر من جهة ثانية؛ لأنَّ لكلِّ منهما جهة عموم تطرَّقت إليه ظنِّية الدلالة فلا ينتهض للتخصيص، وعندئذ وجب المصير إلى الترجيح، ووجهه أنَّ العموم في أحد الدليلين إذا ضعفت دلالته بدخول التخصيص عليه، كان العامُّ الذي يقابله أرجح منه؛ لأنَّ العامَّ المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص أقوى وأولى بالتقديم من العموم الذي دخله التخصيص.
هذا، ويجوز تخصيص العموم مطلقًا سواء كان اللفظ العامُّ أمرًا ونهيًا أو خبرًا، وسواء كان المخصِّص مَتَّصلاً أو منفصلاً، وسواء عُلِم تاريخ نزول كلّ واحد منهما أو لم يُعلم، وسواء تقدَّم العامُّ على الخاصِّ أو تأخَّر، أو جهل التاريخ فلا يُعلم أيهما المتقدِّم من المتأخِّر وهذا مذهب الجمهور، ولا يصحُّ ذلك إلاَّ بدليلٍ صحيحٍ يجب العمل به في صورة التخصيص وإهمال دلالة العامِّ عليها، وتبقى دلالة العامِّ حجّة قاصرة على ما عدا صورة التخصيص. ويكفي الحكم على صحَّة هذا المذهب: عمل الصحابة رضي الله عنهم في الاستدلال بالعمومات وتمسُّكهم بالعامِّ المخصوص مع تقديمهم لدليل الخصوص مطلقًا من غير نظر إلى كون أحدهما متقدِّمًا أو متأخِّرًا مثل قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، فإنَّ الآية عامّة على جميع الأولاد لكن الصحابة رضي الله عنهم خصَّصوا حقّ التوريث بما إذا لم يكن الولد كافرًا أو قاتلاً لأبيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ وَلاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ»(3)، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «القَاتِلُ لاَ يَرِثُ»(4)، وكذلك يخرج من استحقاق الميراث أولاد الأنبياء بما استدلَّ به أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَحْنُ مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»(5).
والأمثلة عنهم كثيرة في العمل بالخاصّ مطلقًا سواء تقدَّم على العامِّ أو تأخّر عنه أو جهل التاريخ، فلم ينقل عنهم أنهم اجتهدوا في البحث عن تاريخ نزول أحدهما ليعمل بالمتأخّر منهما، فظهر ‑والحال هذه‑ رجحان القول بأنّ الخاصّ يخصِّص العامَّ مطلقًا.
[ وجه بناء العام على الخاص عند الأحناف ]
• قال المصنِّف في [ص 197]:
«وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ الخَاصُّ مُتَقَدِّمًا نَسَخَهُ العَامُّ المُتَأَخِّرُ، وَإِنْ كَانَ العَامُّ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَالخَاصُّ مُخْتَلَفًا فِيهِ قُدِّمَ العَامُّ عَلَى الخَاصِّ».
[م] لجمهور الحنفية تفصيل في مسألة بناء العامِّ على الخاصّ ويظهر وجهه:
إمَّا أن يُعلم أنَّ الخاصَّ ورد بعد العامِّ أو ورد العامُّ بعده، وإمَّا أن يُعلم أنهما وردَا معًا، أو يُجهل تاريخ كلٍّ منهما، فإنْ عُلِم أنَّ الخاصَّ ورد بعد العامِّ كان الخاصُّ ناسخًا للعامِّ، فلا يعمل إلاَّ بدلالة الخاصِّ، وإن عُلِمَ أنَّ العامَّ ورد بعد الخاصِّ، كان العامّ ناسخًا للخاصِّ، فلا يعمل إلاَّ بدلالة العامّ في الحكم الثابت لجميع أفراده، وإن عُلِم ورودهما معًا فإنَّ الخاصَّ مُقدَّم على العامِّ، ويجب العمل بالخاصِّ في صورة التخصيص، والعمل بالعامِّ فيما عدا صورة التخصيص، فإن جهل التاريخ فلا يُعلم المتقدِّم من المتأخِّر فالواجب التوقُّف لاستواء دلالة العامِّ والخاصِّ في القطعية ولا يُرجَّح أحدهما إلاَّ بدليل(6).
وعمدة جمهور الحنفية في تقرير هذا المذهب قول ابن عباس رضي الله عنهما: «وكان صحابةُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم يتَّبعون الأحدث فالأحدث من أمره»(7)، ووجه دلالته ظاهرة في أنّ المتأخّر أولى بالعمل من المتقدّم سواء كان المتأخّر هو الخاصّ أو هو العامّ، أمَّا حال المقارنة بينهما فإنّ الخاصّ يقيّد العامّ ويخصّصه، ويلزم التوقّف ‑عند عدم العلم بتاريخ المتقدّم من المتأخّر‑ حتى يأتي دليل مرجِّح لأحدهما.
والمذهب الأوّل أقوى وهو أنّ النصّ الخاصّ يخصّص اللفظ العامّ مطلقًا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ‑كما تقدّم‑ ولأنّ تخصيص العامّ بالخاصّ إعمال لكلّ واحد منهما وهو جمع بين الدليلين، بينما العمل بالنسخ أو التوقّف إهمال لأحد الدليلين أو لكليهما، و«الإِعْمَالُ أَوْلَى مِنَ الإِهْمَالِ»، و«الجَمْعُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّسْخِ وَالتَّوَقُّفِ».
أمَّا الأثر المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو زيادة مدرجة من قول الزهري، وبذلك جزم البخاري(8)(9)، وفي بيان هذا المعنى ترجم ابن خزيمة في أحد أبواب «صحيحه» بقوله: «باب ذكر البيان على أنَّ هذه الكلمة «إنما يؤخذ بالآخر» ليس من قول ابن عباس»(10)، فضلاً عن أنه معارَضٌ بعمل الصحابة رضي الله عنهم، وعلى تقدير صحَّة الأثر فيحمل على ما إذا كان الأحدث خاصًّا للجمع بين الدليلين.
هذا، وإنما آل بالأحناف إلى هذا التقرير هو البناء على قاعدتهم أنَّ دلالة العامِّ قطعية كدلالة الخاصِّ(11)، وقد فنَّد المصنِّف هذا القول في آخر الفصل ببيانه أنَّ الخاصَّ قطعي يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التأويل، والعامّ ظنّي فهو يتناول الحكم على وجه يحتمل التأويل، والقطعي أولى بالتقديم على الظنّي في كُلِّ الأحوال مطلقًا تقديمًا للقوي على ما دونه، فكان الخاصّ أولى من العامّ مطلقًا.
ومن أهمِّ ما يتفرَّع عن هذه المسألة: جواز تخصيص العامّ من الكتاب أو السنّة المتواترة بالدليل الظنِّي، فالجمهور يجيزون هذا التخصيص؛ لأنَّ العامَّ ‑عندهم‑ ظنّي الدلالة، فيصحّ تخصيصه بالظنّي كخبر الآحاد، والقياس الذي ثبتت علّته بنصّ أو إجماع، بخلاف الأحناف فيمنعون هذا التخصيص؛ لأنّ العامّ قطعيّ إذا ورد من الكتاب أو السنّة المتواترة، والقطعي في ثبوته ودلالته لا يصحُّ تخصيصه بالظنِّي. ولا يخفى كثرة الآثار التطبيقية المترتّبة على هذه المسألة، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: 178]، فالآية تفيد عموم القصاص سواء كان المقتول مسلمًا أو كافرًا، وقد خصّص الجمهور هذه الآية بحديث: «لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»(12) عملاً بأنَّ دلالة العموم ظنّية يصحّ تخصيصها بظنّيٍّ آخر كخبر الواحد سواء أكان هذا الدليل الخاصّ نزل قبل العموم أو بعده أو جُهِل تاريخهما، بخلاف الأحناف حَكَّموا العموم لدلالته القطعية، بينما الحديث ظني لا يصلح للتخصيص أوّلاً وهو قابل للتأويل ثانيًا، وقد أوَّلوه بقتل المسلم للكافر الحربي، فلو كان الخاصّ قطعيًّا في ثبوته ودلالته كالحديث المتواتر، ونزل بعد الآية متراخيًا فإنه يكون ناسخًا للعامِّ في القدر الذي اختلفَا فيه متى تساوى معه في الثبوت.
فـصل
[ في طرق دفع التعارض ]
• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص 198]:
«فَإِذَا تَعَارَضَ اللَّفْظَانِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ فِيهِمَا نُسِخَ المُتَقَدِّمُ بالمُتَأَخِّرِ، وَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ، نُظِرَ فِي تَرْجيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ بوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجيحِ… فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ فِي أَحَدِهِمَا تُرِكَ النَّظَرُ فِيهِمَا، وَعُدِلَ إِلَى سَائِرِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ».
[م] ليس المراد به التعارض الحقيقي الذي هو التضادُّ التامُّ بين حُجَّتين متساويتين دلالةً وعددًا وثبوتًا ومتّحدتين محلاً وزمانًا؛ لأنَّ الوحي منزَّه عن التعارض الحقيقي لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]، ولقوله تعالى مخبرًا عن نبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]؛ ولأنَّ الله تعالى أمر بالرجوع ‑عند الاختلاف‑ إلى الكتاب والسُّنَّة ليرتفع الخلاف في قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]، فدلَّ ذلك على عدم وجود التعارض الحقيقي، وإنما المراد به التعارض الظاهري الذي هو وَهْمٌ يقوم في ذهن الناظر ولا وجود له في الواقع، ويزول هذا الوهم بمجرّد إظهار التوفيق بين الدليلين وحصول الائتلاف بينهما من خلال الجمع، أو ببيان النسخ، أو إبراز الترجيح.
وأسباب التعارض الظاهري(13) تعود في مجملها إمَّا إلى قصور في إدراك الناظر إلى اختلاف الرواة من حيث الحفظ أو الأداء، وإمّا إلى دلالات الألفاظ من حيث العموم والخصوص، وإمَّا إلى الجهل بالناسخ والمنسوخ، أو الجهل بتغاير الأحوال.
وللعلماء مسالكُ في دفع التعارض الظاهري، واختار المصنِّف مذهب جمهور العلماء ‑في الجملة‑ الذي رتَّب مسالكه على الوجه التالي:
أوّلاً: الجمع بين الدليلين المتعارضين وَفق شروط الجمع وهي:
أن تثبت الحجِّية لكلِّ واحد من المتعارضين وذلك بصحّة سنده ومتنه.
وأن يتساوى الدليلان المتعارضان في درجة واحدة من حيث القوّة.
وأن يكون التأويل صحيحًا حتى يوافق الدليل الآخر.
وأن يكون الموفِّق أهلاً لذلك.
وأن لا يؤدِّي الجمعُ بين المتعارضين إلى إبطال نصٍّ شرعي، أو الاصطدام معه، وإذا روعيت هذه الشروط أمكن الجمع، وله أوجه منها:
• الجمع بتخصيص العموم، مثاله: تخصيص عموم آية المواريث في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، بحديث: «القَاتِلُ لاَ يَرِثُ»(14)، وحديث: «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»(15).
ومثاله ‑أيضًا‑: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَرَكُ الوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(16)، وبين حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: «أنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ»(17)، فالحديث الأوَّلُ عامٌّ في عدمِ انتقاض الوضوء في كُلِّ ما مسَّته النار سواء لحم الإبل أم غيره، والثاني خاصٌّ في نقض الوضوء من لحوم الإبل، ومذهب أحمد وابنِ خُزيمة وابنِ حزم(18) وهو أحد قولي الشافعي الجمع بين الحديثين بالتخصيص، وهو قول عامَّة أصحاب الحديث(19).
ومثال ثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارُ»(20)، الذي يفيد أنَّ ما أتلفته البهيمة من حرث الغير وزرعه لا يضمنه صاحبها، ويعارضه حديث حرام بن محيصة عن أبيه أنَّ ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، «فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ المَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ»(21)، فإنَّ الحديث يدلُّ على التفريق بين وقوع الإتلاف بالليل أم النهار، والجمهور يحملون العامَّ على الخاصِّ جمعًا بين الأدلة(22).
• الجمع بتقييد المطلق، مثاله: حمل آية تحريم الرضاع المطلقة في قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، على التقييد بالمصَّة والمصَّتين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ»(23)، أو تقييد مطلق الآية بخمس رضعات في قول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمِسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوَفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ»(24).
ومثاله ‑أيضًا‑: حمل الإطلاق الوارد في حديث: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»(25)، على تقييد الغنم بالسائمة(26) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»(27).
ومثال ثالث: حمل الإطلاق الوارد في حديث: «مَنْ ُيطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»(28)، على تقييد الطاعة في المعروف في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»(29).
الجمع بحمل الوجوب على الندب، مثاله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»(30)، الذي يدلُّ على وجوب الغسل على من غسَّل الميت، وحمله على الندب لوجود صارف عن الوجوب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ، إِنَّ مَيِّتَكُمْ المُؤْمِنَ طَاهِرٌ، وَلَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ»(31).
• الجمع بحمل التحريم على الكراهة، مثاله: حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ»(32)، فإنه يدلُّ على عدم جواز توضُّؤ الرجل أو اغتساله بفضل غسل المرأة، ويعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»(33)، فيجمع بين الحديثين بحمل النهي في حديث الحكم رضي الله عنه على الكراهة التنزيهية بالقرينة الصارفة إليها وهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبهذا الجمع بين الحديثين قال جمهور العلماء(34).
ومثاله ‑أيضًا‑ حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ»(35)، فهو يدلُّ على أنَّ أجرة الحجَّام حرام، وإجارته فاسدة، ويعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ»(36)، وقد حمل الجمهور التحريم في حديث رافع رضي الله عنه على الكراهة بالقرينة الصارفة إليها جمعًا بين الدليلين(37)، والخبيث هنا بمعنى الدنيء، وإنما كره ذلك النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم للحُرِّ تنزيهًا لدناءة هذه الصناعة، وقد سمَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثوم والبصل خبيثين(38) مع إباحتهما.
• الجمع بحمل الحقيقة على المجاز، ومثاله: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى الخَائِنِ قَطْعٌ»(39)، فهو يدلُّ على أنه لا تقطع يد جاحد العارية؛ لأنه خائن، ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا» إلى أن قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا»(40)، فهو يدلُّ على أنه تقطع يد جاحد العارية، وعامَّة أهل العلم يذهبون إلى أنَّ المستعير إذا جحد العارية لا تقطع يده(41)، وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها على المجاز، وذلك بحمل قولها: «كانت تستعير المتاع وتجحده» على أنَّ المراد به تعريف المرأة بالصفة التي اشتهرت بها، وهي جحدها للعارية، كما عرفتها بأنها: «مخزومية» ولم تقصد بذلك حقيقة أنَّ جحدها للعارية كان سببًا لقطع يدها، فسبب القطع هو السرقة لا جحدها للعارية وقد صرَّح الحديث باللفظ أنها «سرقت».
ومثاله ‑أيضًا‑ حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»(42)، الذي يفيد ثبوت الشفعة للجار الذي يعارضه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِفَت الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ»(43)، فهو يدلُّ على أنَّ الشفعة مختصة بالشريك دون الجار. وقد عمل الجمهور بالجمع بين الدليلين بالحمل على المجاز(44)، فيعمل بظاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أنَّ الشفعة للشريك فقط، وأمَّا حديث أبي رافع رضي الله عنه فإنَّ الجار فيه حقيقة في المجاور، مجاز في الشريك، إذ أنَّ كلَّ شيءٍ قارب شيئًا فهو جار له، وقد حمل اللفظ على المجاز لوجود قرينة، وهي أنَّ أبا رافع رضي الله عنه سمَّى ‑في حديثه‑ الخليط جارًا، وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد، وهي قرينة على إرادته بالجار الشريك الخليط.
• الجمع بالأخذ بالزيادة، ومثاله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»(45)، فهو يدلُّ على جواز اقتناء كلب الصيد والماشية، بينما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍِ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»(46)، فهو يدلُّ على ما يدلُّ عليه الحديث السابق إلاَّ أنه فيه زيادة كلب الزرع الذي لم يتعرض له الحديث السابق، وقد عمل العلماء بقبول الزيادة جمعًا بين الدليلين؛ لأنها زيادة حافظ غير منافية(47)، وقد وافقها حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»(48).
• الجمع باختلاف الحال، مثاله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن حضانة الغلام: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»(49)، فإنه يدلُّ على أنَّ الأمَّ أحقُّ بحضانة ابنها إذا أراد الأب انتزاعه منها، ويعارضه قوله صلى الله عليه وآله وسلم للغلام: «هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ»(50)، فهو يدلُّ على أنه إذا تنازع الأب والأمُّ في غلام لهما، فإنَّ الواجب هو تخيير الغلام، فمن اختاره فهو أحقُّ به، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الحديثين باختلاف الحال، وذلك بحمل حال الغلام الذي لم يبلغ سنَّ التمييز، أو قبل استغنائه بنفسه على أنَّ الأم أحقّ به من غيرها ما لم تنكح، ويحمل الحديث الآخر فيما إذا بلغ سنَّ التمييز، واستغنى عن الحضانة فإنه يخير بين أبويه إذا تنازعا فيه، فمن اختار منهما فهو أولى به(51).
• الجمع بجواز الأخذ بأحد الأمرين (أي: الجمع بالتخيير)، مثاله: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ»(52)، ويعارضه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ»(53)، وقد دفع العلماء التعارض بجواز الأمرين، فتارةً ينصرف من الصلاة إلى جهة يساره، وتارة ينصرف إلى جهة يمينه، فأخبر كلّ واحد من الرواة بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، ولذلك يكون المصلي مخيّرًا بين الانصراف عن جهة اليمين أو جهة اليسار من غير كراهة(54).
ثانيًا: النسخ عند تعذُّر الجمع، وذلك بالبحث في تاريخ صدور كلٍّ من النصَّين المتعارضين، فإن علم تاريخ صدورهما وأنَّ أحدهما متقدِّم والآخر متأخِّرٌ عمل بالمتأخِّر الناسخ وأهمل المتقدِّم المنسوخ، ولا يسعه العمل بالناسخ إلاَّ عند توفُّر جملة من الشروط منها:
‑ أن يكون الناسخ خطابًا شرعيًّا.
‑ وأن يكون الناسخ مساويًا للمنسوخ في قُوَّة ثبوته ودلالته.
‑ وأن يكون الناسخ ورد متراخيًا عن المنسوخ وهذا لازم للرفع.
‑ وأن يكون المنسوخ حُكمًا شرعيًّا لا عقليًّا، ومؤبّدًا لا مؤقّتًا.
‑ وأن يوجد تعارض بين الناسخ والمنسوخ.
ومثل هذا النسخ إنما يثبت بالطرق الاحتمالية التي يمكن إجمالها في:
• تصريح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسخ، مثل: قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنَّا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيردُّ علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال: «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَأَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ»(55)، ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالآخِرَةِ»(56)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ»(57)، ومن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالقِيَامِ فِي الجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرَنَا بِالجُلُوسِ»(58)، ولا خلاف بين العلماء في ثبوت النسخ بهذه الطريقة(59).
• تصريح الصحابي بالناسخ، مثل: قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ»(60)، فهو ناسخ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(61).
ومثاله: حديث أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أَمَرَ بِالغُسْلِ»(62)، وفي رواية: «ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»(63)، والنسخ بنص الصحابي على الناسخ والمنسوخ صحيح، لكن الصورة المختلف فيها هي: أن يذكر الصحابي أنَّ الخبر منسوخ من غير أن يُعيِّن الناسخ، والراجح من الأقوال المختلفة قبول هذه الصورة من النسخ إذا كان هناك نصّ آخر يخالف النص الذي قال عنه الصحابي: إنه منسوخ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ النصَّ المخالف له هو الناسخ، وغاية ما في قول الصحابي الإعلام بالمتقدِّم والمتأخِّر فيقبل قوله في ذلك(64).
• معرفة التاريخ، فإذا تعذَّر الجمع بين الدليلين المتعارضين وعلم التاريخ، فإنَّ العلم به يوجب كون المتأخِّر ناسخًا والآخر منسوخًا.
ومثاله: ما رواه يعلى بن أمية رضي الله عنه: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجلٌ مُتَضَمِّخٌ بطيب، فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جُبَّة بعدما تضمخ بطيب؟!.. فقال: أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ»(65)، ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ»(66)، وعنها رضي الله عنهما قالت: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»(67)، وعنها ‑أيضًا‑ قالت: «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ (نوع من الطيب) المُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَنْهَاهَا»(68).
فالحديث الأول يدلُّ على أنه يحرم على المحرم استصحاب أثر الطيب السابق للإحرام أو بعده، بينما حديث عائشة رضي الله عنها يدلُّ على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام، والمسألة خلافية(69)، وجماهير العلماء على القول بدفع التعارض بالنسخ بتقديم حديث عائشة باعتباره ناسخًا لحديث يعلى رضي الله عنه، وذلك لتأخُّر حديث عائشة رضي الله عنها عنه، إذ أنَّ قصة يعلى رضي الله عنه كانت بالجِعِرَّانَة(70) في ذي القعدة سنة ثمان بلا خلاف، وحديث عائشة رضي الله عنها كان في حجَّة الوداع سنة عشر بلا خلاف، لذلك يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره ناسخًا للأول.
• الإجماع على النسخ، مذهب جمهور العلماء أنَّ الإجماع لا ينسخ النص، فلا يكون الإجماع ناسخًا ولا منسوخًا، ولكنه يدلُّ على وجود الناسخ، وهو النص الذي استند إليه الإجماع وليس الإجماع ذاته(71).
ومثاله: ما رواه معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»(72)، وقد ذكر الشافعي أنه لا خلاف بين أهل العلم في نسخ قتل شارب الخمر(73)، وقال الترمذي: «إنما كان هذا ‑يعني القتل‑ في أول الأمر ثمَّ نسخ بعد»، ثمَّ قال: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث»(74)، والحديث الناسخ الذي استند إليه الإجماع ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ»(75)(76).
• تأخُّر إسلام الراوي، ذهب بعض العلماء إلى أنَّ حديث المتأخِّر إسلامًا ناسخ للمتقدِّم، عملاً بظاهر التأخير في الزمن، وخالف الجمهور الحكم، حيث يرون أنه لا يحكم بالنسخ لجواز أن يكون المتأخِّر إسلامًا سمعه في حال كفره، ثمّ رواه بعد إسلامه، أو يحتمل أنه سمعه ممَّن سبق بالإسلام فلا يعتبر متأخِّرًا، وهو الصحيح(77). وكذلك يقال فيمن انقطعت صحبته لجواز أن يكون حديث من بقيت صحبته سابقًا لحديث من انقطعت صحبته(78)، فالحاصل أنَّ تأخُّر إسلام الراوي لا يلزم تأخر روايته.
ومثاله: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»(79)، فإنه يفيد أنَّ حدَّ الزاني المحصن الجلد ثمَّ الرجم، ويعارضه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «..عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرِأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا»(80)، وفي حديث آخر لأبي هريرة أنَّ رجلاً اعترف بالزنى وشهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَبِكَ جُنُونٌ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ أُحْصِنْتَ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»(81)، فحديثا أبي هريرة رضي الله عنه يدلاَّن على أنَّ حدَّ الزاني المحصن الرجم فقط، وهما ناسخان لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ لأنَّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو آخر الأمرين بالنظر إلى تأخر إسلامه، وذكر الرجم ولم يتعرّض للجلد، فكان فعله ناسخًا لقوله، اكتفاءً بالرجم لعدم الجمع بين عقوبتين لجريمة واحدة، من باب تخفيف الحدّ، ويقوّي هذا الحكم الاقتصار في قصة ماعز على الرجم فقط، وكذلك في قصة الغامدية، والجهنية، واليهوديين، ولم يذكر الجلد مع الرجم، وبه قال الجمهور(82).
• حداثة سنَّ الراوي، فذهب بعض أهل العلم إلى أنّ ما رواه الأصغر سنًّا يكون ناسخًا للنص الآخر، عملاً بالظاهر في أنَّ الأصغر سنًّا متأخَّر في الزمن عن الأكبر، ومذهب الجمهور على خلاف ذلك، فيقرِّرون بأنه لا يلزم من حداثة سن الراوي تأخّر روايته لسببين:
الأول: احتمال رواية الأصغر سنًّا عمَّن تقدَّمت صحبته، إذ قد ينقل أصاغر الصحابة عن أكابرهم، فلا يلزم أن تكون روايته مُتأخِّرة.
الثاني: احتمال سماع الكبير الناسخ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سمع الصغير منه المنسوخ(83).
ويمكن التمثيل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمحرم: «لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»(84)، ويعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ»(85)، فإنَّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدلُّ على أنه يباح للمحرم الذي لم يجد نعلين أن يلبس خُفَّين، ولكنه مقيَّد بشرط قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، في حين أنَّ حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدلُّ على أنه يباح للمحرم الفاقد للنعلين أن يلبس خُفَّين ولم يقيده بالقطع، والجمهور ذهبوا إلى الجمع بحمل المطلق على المقيد، أي: اشترطوا على من لم يجد نعلين أن يقطع الخفين ثمَّ يلبسهما، والحنابلة سلكوا طريق النسخ، فرأوا أنَّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما(86)؛ لأنَّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان بعرفات، لذلك يجوز لمن تعذَّر عليه وجود نعلين أن يلبس خفين غير مقطوعين عملاً بمطلق حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قلت: والحديث يمكن التمثيل به على حداثة سن الراوي؛ لأنَّ ابن عباس رضي الله عنهما أصغر سنًّا من ابن عمر رضي الله عنهما(87).
• موافقة البراءة الأصلية، بأن يكون أحد الدليلين المتعارضين موافقًا للبراءة والآخر مخالفًا لها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ النص الموافق للبراءة الأصلية متأخَّر عن النص المخالف لها، لكونه يفيد فائدة جديدة بعد رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحكم الذي شرع بعدها، أمَّا مذهب الجمهور فلا يعدُّ ذلك ناسخًا؛ لأنَّ جعل غير الموافق مُتقدِّمًا والموافق متأخِّرًا ليس أولى من العكس؛ ولأنَّ الموافق للبراءة الأصلية كما أنه يأتي بفائدة جديدة عند تأخره فكذلك يأتي بفائدة عند تقدُّمه، وهي أنَّ الشارع جاء موافقًا للعقل، وغير مخالف له(88).
ويمكن التمثيل له بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَِنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ»(89)، الذي يدلُّ على مشروعية قيام القاعد للجنازة، ويعارضه حديث علي رضي الله عنه قال: «قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ»(90)، فإنه يدلُّ على أنَّ القيام للجنازة غير مشروع، فمن سلك مسلك الجمع حَمَل الأحاديث الدالة على وجوب القيام على الندب لاحتمال أنَّ قعوده صلى الله عليه وآله وسلم كان لبيان الجواز، ومن تمسَّك بالنسخ رأى أنَّ أحاديث القيام لها حال القعود منسوخة بالقعود من جهة موافقتها للبراءة الأصلية؛ ولأنَّ النسخ ورد بالنص في الرواية الأخرى لعليِّ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالقِيَامِ فِي الجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرَنَا بِالجُلُوسِ»(91).
ثالثًا: الترجيح عند تعذُّر الجمع على وجه مقبول، وتعذَّر الوقوف على المتقدِّمِ والمتأخِّر، ويسعى المجتهد في البحث في درجة النصَّين من حيث القُوَّة، فإن ظهر له مرجِّح لأحدهما على الآخر: إمَّا من حيث ثبوته، أو من حيث دلالتُه، أو من حيثيات أخرى معتبرة شرعًا، عمل بالراجح وأهمل المرجوح وفق شروط الترجيح وهي:
‑ استواء الدليلين المتعارضين في الحُجِّية.
‑ وعدم إمكان الجمع بينهما.
‑ وعدم معرفة تاريخهما.
‑ وأن يكون المرجّح به وصفًا قائمًا بالدليل.
‑ وأن لا يكون الدليلان قطعيين، أو قطعيًّا مع ظني لأنه لا يُتصوَّر تعارضهما(92)، فإذا روعيت هذه الشروط أمكن الترجيح، وله ثلاث جهات وهي:
الجهة الأولى: الترجيح من جهة سند الحديث، وهذه الجهة تنقسم إلى وجوه الترجيح باعتبار حال الراوي، وإلى وجوه الترجيح باعتبار قُوَّة السند في مجموعه.
أمَّا الجهة الثانية: وهي الترجيح من جهة المتن فتنقسم إلى: وجوه الترجيح باعتبار لفظ الدليل، وإلى وجوه الترجيح باعتبار دلالة الدليل، وإلى وجوه الترجيح باعتبار مدلول الدليل أو حكمه.
أمَّا الجهة الثالثة: وهي الترجيح بأمرٍ خارجيٍّ، فتنقسم إلى ترجيح ما وافقه دليلٌ آخر وإلى ترجيح ما عمل به واحتمل تأخّره(93).
رابعًا: التوقُّف عن العمل بأحد الدليلين أو التساقط إن تعذَّر دفع التعارض بالجمع والنسخ والترجيح، ولم يذكر المصنِّف وغيره من القائلين بهذا المسلك معيار التوقُّف عن أحد الدليلين واختيار الآخر، والواجب في ذلك هو السعي الحثيث في طلب الدليل والاجتهاد في معرفة الحقِّ، إذ لا تخلو مسألة عن دليل وبيان من الشرع، ويبقى القول بالتوقُّف أو التساقط في حقيقة الأمر ما هو إلاَّ مجرَّد كلامٍ نظريٍّ ليس له أثرٌ عمليٌّ على الجانب الفقهي، وقد أوضح ابن خزيمة أنه لا يوجد حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متضادَّان إلاَّ يمكن التوفيق بينهما، ولا يمكن أن يَرِدَ عن الشارع نصَّان متعارضان في موضوعٍ واحدٍ دون أن يكون أحدهما ناسخًا أو راجحًا(94)، ويؤيِّد هذا المعنى إمام الحرمين بقوله: «إنَّ قول العلماء بالتوقُّف ‑إن تعذَّر الترجيح‑ إنما هو مجرَّد افتراض لا يمكن حدوثه»(95)، وورد عن الشاطبي ما يُؤكِّد ذلك بقوله: «لا يوجد دليلان تعارضَا بحيث أجمع العلماء على التوقُّف فيهما»(96).
هذا، والذي تجدر ملاحظته أنَّ المصنِّف قدَّم مسلك الجمع مطلقًا على النسخ والترجيح، والأَوْلَى تقديم النسخ الثابت بنصّ الشارع على بقية المسالك؛ لأنَّه إذا ثبت بالنصِّ نسخ أحدهما فإن محاولة الجمع أو الترجيح بينهما هو إعطاء حُجِّية لدليل انتهت حُجِّيته فلا يصلح أن يعارض الدليل الناسخ، وإنما يقدَّم الجمع على النسخ إن كان ثابتًا بالطرق الاحتمالية المتقدِّمة وليس بالنصّ؛ لأنَّ الطُرُق الاحتمالية للنسخ المختلف فيها يمكن اعتبارها من قرائن الترجيح لا من طرق النسخ، كما أنَّ المصنِّف رَتَّب مسلك التساقط ضمن مسالك دفع التعارض، والأولى إلغاؤه لأنَّه مجرَّد كلام نظري لا أثر له من الناحية العملية والواقعية في الفقه الإسلامي، وعليه يكون ترتيب المسالك كالآتي: النسخ بالنصِّ، ثمَّ يليه الجمع، ثمَّ النسخ الاحتمالي، ثمَّ الترجيح.
• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص 199]:
«…فَإِنْ تَعَذَّرَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ تِلْكَ الحَادِثَةِ كَانَ النَّاظِرُ مُخَيَّرًا فِي أَنْ يَأْخُذَ بأَيِّ اللَّفْظَيْنِ شَاءَ الحَاظِرِ أَوِ المُبيحِ، إِذْ لَيْسَ فِي العَقْلِ حَظْرٌ وَلاَ إِبَاحَةٌ».
[م] اختار المصنِّف مسلكَ التخيير في العمل بأي الدليلين شاء عند تعذَّر وجود دليل على حكم تلك المسألة المبحوث عنها، وبهذا قال أبو بكر الباقلاني والغزاليُّ والفخرُ الرازي والبيضاوي(97)، ولا يخفى أنَّ القول بالتخيير جمع بين النقيضين واطِّراح لكلا الدليلين وكلاهما باطل، ووجه الجمع بين النقيضين أنَّ المباح نقيض المحرَّم، فإذا تعارض المبيح والمحرِّم، وخيِّر بين كونه محرَّمًا يأثم بفعله وبين كونه مباحًا لا إثم على فاعله كان جمعًا بينهما وذلك محال، ولأنَّ في التخيير بين الموجب والمبيح رفعًا للإيجاب فيصير إلى التخيير المطلق، وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين معًا فيكون اطِّراحًا لهما وتركًا لموجبهما.
وعليه فإنَّ التخيير في الشرع لا ينكر لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال وهو في نفسه محال. قال ابن تيمية -رحمه الله-: «الترجيح بمجرد الاختيار بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجَّح بمجرَّد إرادته واختياره، فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام»(98).
هذا، ومَرَدُّ خلافهم في مسألة الاختيار والتوقُّف مبنيٌّ على مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد، ومنشأُ القول بالتصويب والتخطئة يعود إلى مسألة: هل لله تعالى في كلِّ مسألة حكم معيّن قبل اجتهاد المجتهِد أو ليس له ‑سبحانه‑ حكمٌ معيّن، وإنما الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده ؟ وبناءً عليه فمن قال: إنَّ لله حكمًا معيّنًا في كلّ واقعة قبل الاجتهاد ‑وهو قول المخطِّئة‑ قال: لا تعارض بين أدلّة الشرع وعلى المجتهد إصابة الحكم فإذا أصابه فهو المصيب الذي يستحقُّ أجرين، وإذا أخطأه ‑بعد بذل الجهد‑ فهو المخطئ الذي يستحقّ أجرًا واحدًا، فإن عجز عن الترجيح ولم يجد دليلاً آخر فلا يجوز أن تبقى الأدلة متكافئة في محلٍّ واحدٍ، بل لا بد أن يكون أحد المعنيين أرجح، فيلزمه والحال هذه ‑نظرًا لعجزه‑ التوقُّف وبه قال أكثر الأحناف وأكثر الشافعية(99)، وأنكر وقوعَه إمامُ الحرمين والشاطبيُّ(100) وغيرُهما ‑كما تقدَّم‑ أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح، وبه قال تقي الدِّين بن تيمية وحكاه الزركشي عن حكاية الجويني(101)، أو يتعيَّن الأغلظ وهو الحظر وبه قال الأبهري(102) وابن القصار(103) والشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب وابن الهمام(104)، أو تتعيّن الإباحة بناءً على أنَّ الأصلَ في الأشياء الإباحةُ، وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي(105)، وابن حمدان الحنبلي(106)، أمَّا على قول المصوِّبة: أنَّ الحكم في مسألة هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده، فالحقُّ ‑عندهم‑ ليس في جهة واحدة، إنما هو مطالب متعدّدة(107)، ويجوز أن تتكافأ الأدلة في محلٍّ واحدٍ بحيث لا مزية لأحدهما على الآخر، وبناءً عليه يكون حكم الله التخيير، وقد تقدَّم القول بأنَّ مسلك التوقُّف أو التساقط ما هو إلاَّ مجرَّد كلام نظريّ ليس له أثرٌ عملي في الفقه الإسلامي.
فـصل
[ في المخصّصات المنفصلة للعموم ]
• قال المصنِّفُ -رحمه الله- في [ص 199]:
«يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ القُرْآنِ بخَبَرِ الوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بالقُرْآنِ، وَتَخْصِيصُ عُمُومِ القُرْآنِ وَأَخْبَارِ الآحَادِ بالقِيَاسِ الجَلِيِّ وَالخَفِيِّ، لأَنَّ ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ».
[م] والمصنِّفُ في هذا الفصل، والذي يليه تناول بالذِّكر بعضَ المخصِّصات المنفصلة، وضابطُ المخصِّص المنفصل هو: «أنَّه يستقِلُّ بنفسه دون العامِّ بأن لا يكون مرتبطًا بكلام آخر، وهو لفظ أو غيره»(108)، والمسائل التي ذكرها المصنِّفُ تصريحًا وغيرها تعريضًا كتخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنَّة المتواترة أو الآحاد، أو تخصيص عموم القرآن والسنَّة بالإجماع والقياس مطلقًا وبالمفهوم، لا نزاع في جوازها عند الجمهور لوقوعها، و«الوُقُوعُ دَلِيلُ الجَوَازِ»، ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تخصيص العامِّ من الكتاب والسنّة المتواترة بخبر الواحد من غير نكير، كتخصيص أبي بكر رضي الله عنه الآية في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ﴾ [النساء: 11]، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّا مَعشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»(109)، كما خصَّصوا عمومَ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24] بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ خَالَتِهَا»(110).
ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة: 228] فإنّ عمومَ منطوق هذه الآية قد خُصِّص بقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 14]، فهذه الآية تخصّص الحامل من عموم عِدَّة المطلقات بثلاثة قروء (حيض أو طهر على خلاف)، فإنَّ عِدَّتها بوضع الحمل، ولو بعد ساعة من طلاق أو بعد سنة منه.
وأمَّا تخصيص الكتاب بالسُّنَّة فمثل قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ﴾ [النساء: 11] فهو عموم مخصَّص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ»(111).
ومثل تخصيص السُّنَّة بالكتاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»(112)، فهي مُخصَّصة بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43].
ومثل تخصيص العموم بالإجماع، قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3]، فظاهر الآية يقضي بإباحة المملوكة سواء كانت أختًا من الرضاع أو لم تكن، لكن الإجماع خصَّص الآيةَ بتحريم المملوكة إذا كانت أختًا من الرضاع.
وأمَّا تخصيص اللفظ العامِّ بالقياس، فمثل قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2] خصص منه العبد قياسًا على الأَمَة المخصَّصة منه بقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25].
وأمَّا تخصيصُ العامِّ بالمفهوم مُطلقًا، فمثاله في مفهوم الموافقة: تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيُّ الوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»(113) بمفهوم قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، فإنَّه يُفهم منه منع حبس الوالد للدين، فلا يصحُّ أن يحبس في دين ولده.
ومثاله في مفهوم المخالفة تخصيص قوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 3] بمفهوم قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النساء: 25]. فإنه مفهوم يقتضي عدم جواز نكاح الأَمَة لمستطيع الطول فيخصَّص به العامّ.
هذا، والمصنِّف ذكر مذهبَ الجمهور في جواز تخصيص اللفظ العامّ بالقياس مطلقًا سواء كان جليًّا أو خفيًّا، وهو الصحيح، خلافًا لمن فَرَّقَ بينهما في التخصيص، فجعل القياس الجليَّ يخصّص العموم دون الخفي وهو مذهب ابنِ سُرَيجٍ والإِصْطَخْرِي من الشافعية(114)، علمًا أنَّ العلماء يختلفون في تفسير القياس الجليّ والخفيّ على آراء متعدِّدة، حيث يرى بعضهم: أنَّ القياس الجليَّ هو قياس العِلَّة، والقياسُ الخفي هو قياس الشبه، ومنهم من يرى: أنَّ القياس الجليّ ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي خلافه، وفسّر آخرون الجليَّ: بأنَّه ما تبادرت علَّته إلى الفهم عند سماع الحكم والخفي بخلافه، وفي المسألة أقوال أخرى، ولكن مهما كان الاختلاف في تفسيرهما فلا يخرج القياس الخفي من أن يكون دليلاً شرعيًّا، حكمه حكم القياس الجليّ، فهما أشبه في تخصيص العموم بخبر المتواتر وخبر الواحد.
أمَّا مذهب الجمهور في العُرف والعادة فإنَّه لا يخصَّص بهما العموم؛ لأنَّ أعراف الناس وعاداتهم لا تكون حُجَّة على الشرع.
فصل
[ في بقية المخصَّصات المنفصلة للعموم ]
• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص 202]:
«وَقَدْ يَقَعُ التَّخْصِيصُ أَيْضًا بمَعَانٍ فِي أَفْعَالِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِقْرَارِهِ عَلَى الحُكْمِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ».
[م] ويجوز تخصيصُ العمومِ بفعل النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مذهبُ جمهور أهل العلم ونفاه بعضُهم كالكرخي، وفصَّل آخرون كالآمدي والشوكاني وغيرِهما، وتوقَّف غيرُهم، كما يجوز تخصيصُ العامِّ بإقرار النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو مذهب الجمهور أيضًا، وهو الصحيح(115)؛ لأنَّ إقرارَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم على فِعْلٍ وسكوتَه عن الإنكار دليلٌ على جواز الفعل، والإقرار ‑وإن كان لا صيغة له‑ إلاَّ أنَّه حُجَّة في الجواز لعِصمته صلى الله عليه وآله وسلم ونفي الخطأ عنه، فتظهر قُوَّةُ حُجِّيَّته من هذا الجانب، بخلاف العامِّ فمحتمل للتخصيص والأقوى مقدَّم، ومن أمثلة تخصيص العامِّ بفعل النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] فإنّ هذا العمومَ خُصِّصَ بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ»(116)، أمَّا تخصيص اللَّفظ العامِّ بإقراره صلى الله عليه وآله وسلم فمثاله عمومُ النهيِّ عن الصلاة بعد الصُّبح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»(117)، وقد خُصِّصَ بجواز قضاءِ الراتبة بعد الصبح بما روى قيس ابن قهد قال: «رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ ؟ فقلت: يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم»(118).
[ في تخصيص العموم بمذهب الراوي ]
• ثمَّ قال المصنِّفُ -رحمه الله- بعد ذلك في [ص 203]:
«وَلاَ يَقَعُ التَّخْصِيصُ بمَذْهَبِ الرَّاوِي، وَذَلِكَ مِثْلُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: «المُتَبَايعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»(119)، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: التَّفَرُّقُ بالأَبْدَانِ».
[م] اختلف أهلُ العلم في المراد بالراوي، هل هو مخصوصٌ بالصحابي أم هو أعمُّ من ذلك ويشمل غيرَه ؟ مع اتفاقهم على عدم حُجِّية قولِ غيرِ الصحابيِّ، فذهب القرافيُّ وغيرُه إلى أنّ المسألةَ مخصوصةٌ بما إذا كان الراوي صحابيًّا، وذهب فريقٌ آخر إلى أنَّه يشمل التابعيَّ أيضًا؛ لأنَّه لا يكاد يأتي شيء عن التابعين إلاَّ وهو مأخوذ عن الصحابة، ويرى فريقٌ ثالثٌ أنّ الأمر أعمُّ من تخصيصه بالصحابي أو التابعيِّ؛ لأنّ مخالفتَه إنّما تصدر عن دليل، وكلّ ما في الأمر أنَّ من ليس بصحابي فمخالفته أضعف، والأَوْلَى قَصْرُه على الصحابيِّ؛ لأنَّ مخالفةَ مذهبه لما رواه يحتمل الدلالة على اطلاعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قرائن حالية تفيد اختصاصه بها؛ ولأنَّه يحسن في الصحابي دون غيره أن يقال هو أعلم بمراد المتكلِّم، خلافًا لغير الصحابي، فإنَّ مخالفته مبنية على ظنِّه واجتهاده(120).
أمَّا مسألةُ تخصيصِ العموم بمذهب الصحابيِّ فإنَّما يجوز التخصيصُ به إذا كان له حكم الرفع، وذلك فيما لا مجال للرأي فيه، أمَّا ما عدا ذلك فإنَّ مذهبَ الصحابيِّ لا يُخصَّص به العمومُ، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وبه قال الشافعي في الجديد خلافًا للحنفية وبعضِ الحنابلة وجماعةٍ من الفقهاء(121)، ويشهد لمذهب الجمهور واقع الصحابة رضي الله عنهم حيث كان الواحد منهم يترك قولَه ومذهبَه إذا سمع العمومَ من كتابٍ أو سُنَّةٍ، وما نُقِلَ عن أحدٍ منهم أنّه خَصَّص عمومًا بقول نفسِه، وهذا يدلُّ على أنَه لا يخصَّصُ به العمومُ لضعفه عن العموم، أي أنَّه يُقدَّم المرفوعُ على الموقوفِ ولا يُخصَّص به، ومثاله: رجوعُ ابنِ عمر رضي الله عنهما إلى خبر رافع بن خديج رضي الله عنه في المخابرة(122) حيث قال: «كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ قَوْلِ رَافِعٍ»(123).
ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين(124)، ورجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عدم أخذه جزية المجوس حتى حَدَّثَهُ عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرٍ(125)، وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.
وهذه المسألة مبنيةٌ على حُجِّية قولِ الصحابيِّ، فَمَنِ اعتبره حُجَّةً خَصَّصَ به العمومَ، ومن لم يعده كذلك منع التخصيص به، ومن اعتبر حُجِّيَّتَه إذا وافق القياسَ قال بتخصيص العموم به، وهو في حقيقة الأمر تخصيصُ العمومِ بالقياس، ومن اشترط انتشار مذهبه بحيث لا يوجد له مخالف كان حُجَّةً وإجماعًا قال بالتخصيص، وهو في واقع الأمر تخصيصٌ بالإجماع، ويبقى الاختلاف ظاهرًا في تحقُّق وقوعِ هذا الشرط من عدمه(126).
وقول المصنِّف أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «التَّفَرُّقُ بِالأَبْدَانِ» فالمنقول عنه رضي الله عنه بيانه للتفرُّق بفعله المفسّر لحديث خيار المجلس، فقد ثبت في الصحيحين وغيرِهما من قولِ نافع مولى ابنِ عمر رضي الله عنهما أنَّه: «كان إذا بايع رجلاً، فأراد أن يقيله قام فمشى هنيهة ثمَّ رجع إليه»(127)، وأنَّه: «كان إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبه»(128)، وفي الصحيح ‑أيضًا‑ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كُنَّا إذا تبايعنا كلٌّ منَّا بالخيار ما لم يتفرَّق المتبايعان، قال: فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر، قال: فلمَّا بعته طفقت أنكص القَهْقَرَى خشية أن يرادَّني عثمان البيع قبل أن أفارقه»(129).
وثبوتُ خيار المجلس هو الصحيح من قولي العلماء، وبه قال الصحابة وجمهور التابعين، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأكثر المجتهدين وسائر المحدثين، خلافًا لأبي حنيفة(130) ومالك وجمهور أصحابهما الذين منعوا خيار المجلس وفسّروا التفرُّقَ في الحديث أنه التفرّق بالأقوال -وهذه المسألة بيَّنْتُها مفصَّلة في كتابي «مختارات من نصوص حديثية»(131)، غيرَ أنَّ الذي يشكل من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينكص القهقرى خشيةَ أن يُرَادَّ من المتعاقد ليثبت له البيع، مع أنَّ هذا الفعلَ وردَ النهيُ عنه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ»(132) ولدفع هذا الإشكال يمكن حمله على أنَّه لم يبلغه خبر النهي. والله أعلم.
• وقوله -رحمه الله- بعدها في [ص 204]:
«فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ التَّخْصِيصُ بذَلِكَ».
[م] والقولُ بتخصيصِ العموم بقول الصحابيِّ ومذهبِه هو أيضًا مذهبُ الحنفيةِ والحنابلةِ، وهو قولُ الشافعيِّ في القديم وابنِ حزم، ودليل هذا المذهب مبنيٌّ على القول بحُجِّية مذهب الصحابيِّ وتقديم مذهبه على القياس، وإذا جاز تخصيصُ العموم بالقياس فإنَّ الأمر يقتضي تخصيص العموم بمذهب الصحابي من باب أولى لتقدُّمه على القياس.
ولا يخفى أنَّ مذهبَ الصحابي يكون حُجَّةً فيما إذا كان له حكم الرفع، أو كان حُجَّةً وإجماعًا، أو وافقه قياسٌ صحيح ‑كما تقدَّم‑ وقد يكون حُجَّةً إذا لم يعارض مذهبُه نصًّا من كتابٍ أو سُنَّةٍ، أمَّا إذا عارض أحدَهما أو كليهما فلا حُجَّةَ فيه، وقياسُه على القياس فاسدٌ للفرق بينهما؛ لأنَّ القياسَ ثابت استنادًا إلى أصلٍ ثابتٍ بكتابٍ أو سُنَّةٍ فجاز تخصيصُه للدليل المعتمد عليه، أمَّا مذهب الصحابي فلا يُعلم مستنده، لذلك عدل عنه إلى العمل بما علم وهو العموم.
هذا، والخلافُ في هذه المسألة معنويٌّ، ومن آثاره: مسألة قتل المرأة إذا ارتدت، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»(133). فإنَّ الحديثَ بعُمومه يقتضي قتلها، لكن راويه ‑وهو ابن عباس رضي الله عنهما‑ يرى أنَّ المرأة لا تقتل إذا ارتدت، بل تحبس كما يقوله أبو حنيفة، فهل يخصَّص عمومُ الحديث بمذهب الصحابي أم لا ؟(134). وهذه المسألة تبنى على هذا الأصل الذي له جملة من التطبيقات الفرعية.