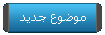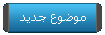-الجزء الرابع عشر-
-الجزء الرابع عشر-
فصل
[ في صحة لزوم الدليل على نافي الحكم ]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص 326]:
«مَنِ ادَّعَى نَفْيَ حُكْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَمَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلىَ مَنْ أَثْبَتَهُ، وَقَالَ دَاوُدُ: «لاَ دَلِيلَ عَلىَ النَّافِي»».
[م] هذه المسألة لها علاقة بموضوع الاستصحاب، وهي أنه: إذا نفى بعضُ المجتهدين حُكمًا من الأحكام، فهل يكفيه التمسُّك بأصلِ النفي في عدم ثبوت الحكم عنده، أم يطالب بإقامة الدليل كما يطالب به المثبِت للحكم ؟
ففي تحرير محلِّ النِّزاع لا يختلف العلماء في أنَّ المثبِت للحكم يلزمه الدليلُ، كما أنَّ النافيَ للحكم إن كان نفيه مُستلزمًا لإثبات ضدِّ المنفي كمن نفى الإباحة فإنه يُطالب بالدليل اتفاقًا، وإنما الخلاف في النافي للحكم إذا كان نفيه لا يستلزم ثبوتًا وهو: النفي المجرّد كنفي عبادة في الشرعيات، أو صِحَّة عقدٍ من العقود، أو نفي شيء من الأشياء في العقليات، فهل يلزمه إقامة الدليل ؟
فالذي ارتضاه المصنِّف هو ما عليه جمهور الفقهاء والمتكلِّمين من أنَّه يلزمه إقامةُ الدليل مُطلقًا، خلافًا لمن قال: إنه لا يُطالب بالدليل ولا يلزمه وهو مذهبُ بعضِ الشافعية وداودَ بن علي، ومَن تبعه من أهل الظاهر إلاَّ أنَّ ابنَ حزم وافق الجمهور في هذه المسألة(1)، وفصَّل آخرون فيها مع اختلافهم في وجوه التفصيل(2).
[ في الاحتجاج بلزوم الدليل على نافي الحكم ]
• وفي الاحتجاج على مذهب الجمهور يقول الباجي -رحمه الله- في الصفحة نفسها:
«وَالدَّلِيلُ عَلىَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالىَ: ﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 111]».
[م] ووجه الاستدلال بالآية التي احتجَّ بها المصنِّف: أنَّ الله تعالى -وهو أحكم الحاكمين- طالبَ اليهود والنصارى بالدليل على دعوى نفي دخول الجنة إلاَّ مَن كان هودًا أو نصارى، ولما كانت دعواهم دعوى نفي فإنَّها تفيد لزوم الدليل على نافي الحكم.
والصواب: أنَّ الاستدلال بالآية على هذا الحكم لا يصحُّ؛ لأنَّ الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرّد، بل ادَّعوا دعوى مضمونها دخولهم هم الجنّة، وأنَّ غيرَهم لن يدخلها، وطولبوا بالدليل على هذه الدعوى المركّبة من النفي والإثبات، وصاحبُ هذه الدعوى يلزمه الدليل باتفاق الناس، وإنما الخلاف في النفي المجرّد، كما أفصح عن ذلك ابن القيم -رحمه الله- وحقَّق هذه المسألة بقوله:
«إن النفي نوعان:
w نوعٌ مستلزم لإثبات ضِدِّ المنفي، فهذا يلزم النافي فيه الدليل، كمن نفى الإباحة فإنه يُطالَبُ بالدليل قَطْعًا؛ لأنَّ نفيَها يستلزم ثبوتَ ضِدٍّ من أضدادِها، ولابدّ من دليلٍ، وكذلك نفيُ التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة(3) يستلزم دخول الجنّة والفوز بالنعيم ولابدّ من دليل.
w النوع الثاني: نفيٌ لا يستلزم ثبوتًا كنفي صِحَّةِ عقدٍ من العقود، أو شرطٍ، أو عبادةٍ في الشرعيات، ونفي إمكان شيءٍ ما من الأشياء في العقليات، فالنافي إن نفى العلم به، لم يلزمه الدليل، وإن نفى المعلوم نفسَه، وادّعى أنه مُنتفٍ في نفس الأمر فلابدَّ له من دليل»(4).
والظاهر أنَّ نفي المعلوم في نفس الأمر هو دعوى منفية الحكم نفيًا مجرَّدًا، والدعاوى لا تثبت إلاَّ بدليل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنَةُ عَلىَ مَنِ ادَّعَى»(5)، وعليه فلا فرق في وجوب إقامة الدليل على الدعوى سواء على المثبت أو النافي، إذ لو سقط الدليل على النافي لأمكن للمثبت أن يعبر عن مذهبه بلفظ النفي كأن يقول مثلًا: «غير قادر« بدلًا من لفظة «عاجز» ليتخلَّص بأسلوب النفي من الدليل، الأمر الذي يُفضي إلى إسقاط الدليل على المثبت والنافي جميعًا، ولا شكَّ في بطلان هذه النتيجة فتبطل وسيلتُها المفضية إليها جريًا على قاعدة: «مَا أَدَّى إِلَى بَاطِلٍ فَهُو بَاطِلٌ»، لذلك يلزم النافي للحكم الدليل سدًّا للذريعة.
هذا، ولا يعلم انعكاس هذا الخلاف وتأثيره على الفروع الفقهية، لذلك كان الخلاف لفظيًّا، يُحتاج إليه في تقعيد المناظرات العلمية.
فصل
[ في صفة المجتهد وشروطه]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص 327]:
«صِفَةُ المُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بمَوْضِعِ الأَدِلَّةِ، مَوَاضِعِهَا منْ جهَةِ العَقْلِ، وَيَكُونَ عَارِفًا بطَرِيقِ الإِيجَابِ وَبطَرِيقِ المُوَاضَعَةِ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ، وَيَكُونَ عَالِمًا بأُصُولِ الدِّيَانَاتِ وَأُصُولِ الفِقْهِ».
[م] من صفة المجتهد أن يعرف الأدلةَ من حيث ترتيبُها في القُوَّة والحُجِّيَّة، كما يعرف كيفية استثمار الأحكام من أصولها، وهي على ضربين: متفق عليها، ومختلف فيها، فالأدلَّة المعتبرةُ شرعًا التي اتفق عليها أهل السُّنَّة أربعة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس من حيث الجملة، وأنَّ هذه الأدلَّةَ الأربعة متفقة لا تختلف، إذ يصدق بعضُها بعضًا، ويوافق بعضُها بعضًا؛ لأنَّ الجميع حقٌّ، والحقُّ لا يتناقض، وهي من جهة أخرى متلازمة لا تفترق؛ لأنَّ جميعَ الأدلة سواء المتفق عليها أو المختلف فيها ترجع إلى أصل الكتاب إذ هو عمدة الشريعة، وأصل أدلَّتها، وأصل مصادر التشريع وأهمِّها، ويستدلُّ على حُجِّية الأدلَّة به، فالسُّنَّة بيانه، والإجماع لا يكون إلاَّ عن دليلٍ منه أو من السُّنَّة، والقياسُ لا يكون إلاَّ على أصلٍ ثبت حكمه بالنصِّ أو الإجماع، فجميعها راجعة إليه، إمَّا في البيان والتوضيح، وإمَّا لاعتبارها حُجَّة ومصدرًا لدلالة القرآن عليها(6)، وأن يكون مُحيطًا بشروط ذلك من تقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره، عارفًا بدلالة الألفاظ على المعاني، ونسبة إيقاع اللفظ للمعنى وتعيّنه له من جهة الوضع اللغوي أو الشرعي، بحيث يظهر تمكنّه من معرفة وجوه دلالات الألفاظ على المعاني من جهة منطوقها، ومنظومها، وفحواها، ومفهومها، ومعناها، ومعقولها(7).
ولا يُشترط في المجتهد أن يكون عالما بأصول الدِّيانات ولا معرفة العقائد على طريقة المتكلِّمين بأدلَّتهم التي يحرِّرونها(8)، ولكن يشترط أن يكون عالما بمعرفة الله تعالى، بصفاته الواجبة، وما يجوز عليه سبحانه وما يمتنع عليه، ومعرفة نبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه معصوم عن الخطأ في شرعه، وأنَّ إجماعَ الأُمَّةِ معصومٌ ولا يُشترط العلم بدقائقه(9)؛ لأن المجتهَد فيه -وهو الحكم الشرعي العمليُّ- ليس فيه دليلٌ قاطع، فاحترز بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، وبما ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأُمَّة من جليات الشرع(10)، كما لا يشترط في المجتهِد معرفته بتفاريع الفقه؛ لأنَّها ثمرة الاجتهاد، ولا يكون إلاَّ بعد بلوغ المجتهد مرتبة الاجتهاد حيث يولدها ويتصرف فيها، والشيء لا يتوقَّف على ثمرته، وإلاَّ للزم الدور(11)، ولا يشترط -أيضًا- معرفته بأصول الفرائض ولا علم الحساب ولا بالدليل العقلي ونحو ذلك من العلوم غير الضرورية، فليست شرطًا في الاجتهاد في الأحكام ولكنَّها صفة كمال، بخلاف علم أصول الفقه فإنه يشترط في المجتهد معرفته به؛ لأنه الآلة التي يتوصَّل بها للاجتهاد فهو عماده، وأساسه الذي يقوم عليه أركان بنائه، وقد ذكر أبو حامد الغزالي -رحمه الله- أنَّ أعظم علومِ الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: علم الحديث، وعلم اللغة، وعلم الأصول(12)، ولا يكفي معرفة مسائل الأصول المقرَّرة عند الأئمَّة، بل يلزمه إدراكها بنفسه كما أدركها الأئمَّة قبل تدوين علمِ الأصول، حتى يتسنى له ردّ الفروع إلى أصولها بأيسر طريق وأقل عمل.
والمصنِّف -رحمه الله- عطف على شرط المعرفة بأصول الفقه بعض تفاصيل هذا الفنّ بأن يكون «عَالِمًا بِأَحْكَامِ الخِطَابِ: مِنَ العُمُومِ، وَالأَوَامِرِ، وَالنَّوَاهِي، وَالمُفَسَّرِ، والمُجْمَلِ، وَالنَّصِّ، وَالنَّسْخِ، وَحَقِيقَةِ الإِجْمَاعِ»، فينبغي عليه أن يعرف أقسام القواعد الأصولية وشروط كلّ دليل، وترتيبها، وفكّ التعارض بينها.
[ في معرفة المجتهد بأحكام الأصول ونوع دلالتها على الحكم ]
• ثمَّ قال المصنِّف -رحمه الله- بعدها في [ص 328]:
«عَالِمًا بأَحْكَامِ الكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالآثَارِ، وَالأَخْبَارِ وَطُرُقِهَا، وَالتَّمْييزِ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا».
[م] المجتهد إذا أراد الاستدلال على حكم حادثةٍ بآيةٍ أو حديثٍ فلا بدّ أن يعرف جملة من المسائل منها: سبب النزول، وكونها منسوخة أو لا ؟ وأقوال الصحابة والتابعين من بعدهم، ومعرفة سند الحديث وطريق وصوله إلينا، ومعرفة الصحيح من الأحاديث من سقيمها، ومُحكمها من منسوخها، وتفاسير العلماء وشروحهم، ومعرفة شروح علماء اللغة لها، ومعرفة نوع دلالتها على الحكم بالمفهوم أو المنطوق ونوع كلّ واحدٍ منهما.
ولا يُشترط حفظ القرآن الكريم ولا آيات وأحاديث الأحكام، بل يكفيه أن يعرف مواضع الأدلة حتى يتسنى له الرجوع إليها في وقت الحاجة كآيات وأحاديث الرضاع والنكاح والطلاق والأطعمة وغيرها، على أن يتمَّ معرفة الآيات والأحاديث لغةً بمعرفة معاني المفردات والمركبات وخواصِّها في إفادة المعنى، ومعرفتها شرعًا بأن يعرف العِلل والمعاني المؤثِّرة في الأحكام، وأوجه دلالة اللفظ على المعنى.
[ في بقية شروط المجتهد ]
• ويستتبع المصنِّف -رحمه الله- بشروط أخرى للمجتهد، وذلك بأن يكون «عَالِمًا بأَقْوَالِ الفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، عَالِمًا مِنَ النَّحْوِ وَالعَرَبيَّةِ مَا يَفْهَمُ بهِ مَعَانِيَ كَلاَمِ العَرَبِ، وَيَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مَأْمُونًا فِي دِينِهِ، مَوْثُوقًا بهِ فِي فَضْلِهِ».
[م] وشرط العلم بما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه إنما اشترط لئلاَّ يقع اجتهاده في مسألة أجمع العلماء على حكمها، فينبغي عليه في كُلِّ مسألة يُفتي فيها أن يعلم أنّ فتواه غيرُ مخالفة للإجماع تجنّبًا للشذوذ والفُرقة، ولا يُشترط له أن يحفظ مواضع الإجماع والخلاف، ويكفيه العلم بموافقة مذهب من مذاهب العلماء، أو غلب على ظنِّه أنَّ هذه الحادثة وقعت في عصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض(13)، وله أن يعتمد على كتاب «الإجماع» لابن المنذر(14) -رحمه الله-، و«مراتب الإجماع» لابن حزم -رحمه الله-.
أمَّا المسائل المختلف فيها، فالواجب على المجتهد أن يعرف كُلَّ مسألةٍ ودليل المختلفين فيها، ويمكن أن يستعين بكتب علم الخلاف ك «المحلى» لابن حزم، و«بداية المجتهد» لابن رشد، و«المغني» لابن قدامة، و«الذخيرة» للقرافي، و«المجموع» للنووي، و«المبسوط» للسرخسي وغيرها.
وأن تكون معرفته باللغة العربية وقواعدِها في كلِّ ما يتوقَّف عليه فهم الألفاظ بقصد فهم الكتاب والسُّنَّة لورودهما بلغة العرب، ولا يشترط معرفة دقائق اللغة، ولا التعمُّق في النحو والبلاغة والبديع ونحو ذلك، وإنما يكفي معرفة القدر الذي يفهم منه خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال بحيث يستطيع التفريق بين النصِّ الصريح والظاهر والمجمل، والعامّ والخاصّ، والمحكم والمتشابه، والمطلق والمقيّد ليتمكَّن من فهم الأحكام الشرعية من تلك الألفاظ بلغة العرب على أن يكون على دراية باللفظ والمراد منه سواء أريد باللفظ المعنى اللغوي له، أو الشرعي، أو العرفي بقرائن السياق والسباق والقرائن الخارجية والعقلية وغيرها.
ويمكنه أن يرجع في تفسير ما ورد في الكتاب والسُّنَّة من غريب الألفاظ إلى الأئمَّة المشتغلين بذلك مثل: كتاب «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني، و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة، و«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير، و«الفائق في غريب الحديث» للزمخشري.
أمَّا قول المصنف: «وَيَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مَأْمُونًا فِي دِينِهِ، مَوْثُوقًا بِهِ فِي فَضْلِهِ» فإنه يتعلَّق بعدالة المجتهد بحيث يكون متجنِّبًا للمعاصي القادحة في العدالة، وهو شرط في جواز الاعتماد على فتواه؛ لأنَّ من ليس عدلًا لا تُقبَل فتواه بالنسبة للآخرين، أمَّا في خصوص نفسه فيجب أن يعمل باجتهاده إذا توفَّرت فيه الشروط وإن لم يكن عدلًا.
هذا، ويضيف العلماء شرطًا مؤكّدا متمثِّلاً في معرفة المجتهد بمقاصد الشريعة العامَّة في وضع الأحكام، ذلك لأنَّ استنباط الحكم الشرعي من دليله ينبغي أن يكون وفقًا لمعارف المجتهد بأسرار الشريعة ومراميها وأبعادها، خبيرًا بمصالح الناس لجلب النفع لهم ودفع الضرِّ عنهم، مُطلِّعًا على أحوالهم وعاداتهم وأعرافهم، ولأهمِّية هذا الشرط جعله أبو إسحاق الشاطبي -رحمه الله- عنصرًا أساسيًّا لتحصيل درجة الاجتهاد حيث يقول: «إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكّن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها»(15).
بـاب
أحكام التَّرجيح
الترجيح بابه واسعٌ لا يمكن الإحاطة به سعةً...
"يتبع".
1- انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (326).
2- من وجوه التفصيل ما ذهب إليه بعض الشافعية أنَّ الحكم إن كان عقليًّا يلزم النافي له الدليل، ولا يلزمه إن كان شرعيًّا وهو محكي عن الباقلاني وابن فورك وغيرهما، وهذا التفصيل بين العقليات والشرعيات يحتاج إلى دليل التفريق، وذهب آخرون إلى نفي الحكم إن ثبت بالضرورة، فلا يطالب بالدليل؛ لأنَّ الضرورة دليل، أمَّا إن ثبت بالظنّ أو بالعلم النظري وجب عليه الدليل كما يجب على من أثبته؛ لأنَّه محلّ شبهة بخلاف الضروري فتنتفي فيه الشبهة، ولا يخفى أنَّ الضروري خارج عن محلِّ النزاع باعتبار أنَّ الضرورة دليل، أمَّا العلم النظري فلا يخرج عن مذهب القائلين بلزوم الدليل عليه فلا وجه للتفصيل.
3- وذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ [البقرة: 80].
4- «بدائع الفوائد» لابن القيم (4/151-152).
5- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (10/252)، وأصله في الصحيحين بلفظ: «اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». أخرجه البخاري في «الرهن» (5/145) باب إذا اختلف الراهن والمرتهن، ومسلم في «الأقضية» (12/2) باب اليمين على المدَّعى عليه، والترمذي في «الأحكام» (3/626)، باب البينة على المدعي والنسائي في «القضاء» (8/248) باب عظة الحاكم على اليمين، وابن ماجه في «الأحكام» (2/778) باب البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعَى عليه، من حديث ابن عباس { وفيه قصّة.
[انظر تخريجه في: «نصب الراية» للزيلعي (4/95)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (2/208)، «الدراية» لابن حجر (2/175)، «إرواء الغليل» للألباني (8/264)].
6- «الفتح المأمول» للمؤلف (72).
7- «لباب المحصول» لابن رشيق (2/711).
8- انظر: «المستصفى» للغزالي (2/352).
9- «الإحكام» للآمدي (3/204)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (4/464)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (252).
10- «إرشاد الفحول» للشوكاني (252).
11- «المستصفى» للغزالي (2/353)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (252).
12- «المستصفى» للغزالي (2/353). انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (328-329).
13- انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (328-329).
14- هو أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإمام المجتهد، كان فقيهًا محدِّثًا ثقةً، قال النووي: «له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية من التمكن في معرفة الحديث»، له تصانيف كثيرة، منها: «الإجماع»، و«الإشراف في مسائل الخلاف»، و«المبسوط»، و«جامع الأذكار» وغيرها توفي سنة (318ه).
انظر ترجمته في: «طبقات الشيرازي» (108)، «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2/196)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/207)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (14/490)، «لسان الميزان» لابن حجر (5/27)، «شذرات الذهب» لابن العماد (2/280)، «طبقات المفسرين» للداودي (2/55)، «طبقات المفسرين» للسيوطي (91)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني (77).
15- «الموافقات» للشاطبي (4/105-106).