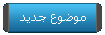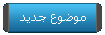«الجزء الثاني»
«الجزء الثاني»
أبـواب العموم وأقسامُه
• قال القاضي أبو الوليد -رحمه الله- في عنوان الباب من [ص 184]:
«أَبْوَابُ العُمُومِ وَأَقْسَامُهُ… وَالكَلاَمُ هَا هُنَا في العُمُومِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ خَمْسَةٌ مِنْهَا».
[م] لم يتعرَّض المصنِّف إلى التعريف بالعامِّ ولا إلى بيان أقسامه، وإنما ذكر صِيَغَ العموم وألفاظَه، وهو أحد أقسام العموم الذي استفيد عمومه من جهة اللغة، إذ اللفظ العامُّ في الوضع اللغوي: إمَّا أن يكون عمومه من نفسه: كأسماء الشرط والاستفهام والمَوْصُولات، وإمَّا أن يكون من لفظٍ آخر دالٍّ على العموم فيه، وهذا اللفظ الآخر: إمَّا أن يكون في أوَّل العامِّ كأسماء الشرط والاستفهام والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام والامتنان، والألف واللام، وعبارتي «كلّ» و«جميع»، وإمَّا أن يكون في آخره كالمضاف إلى المعرفة مطلقًا سواء كان مفردًا أو جمعًا فهو اللفظ الذي لا يستفاد العموم إلاَّ من آخره، وكلّ ما ذكره المصنِّف من ألفاظ العموم لا يخرج عن هذا البيان المتعلّق باستفادة عمومه من جهة اللغة، أمّا بقية أقسام العموم فلم يتناولها المصنِّف، وهي تتمثَّل في العام من جهة العرف وهو: ما استفيد عمومه من جهة عرف الشريعة، مع أنَّ لفظه لا يفيد العموم من جهة اللغة، مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، فإنه لما عين العرف الاستمتاع في المحذوف لزم تعلّق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع بالوطء وغيره، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، فليس في الآية ما يفيد العموم من جهة اللغة، لكن العرف جعله مفيدًا للتحريم في جميع أنواع الانتفاعات بالأكل وغيره(1). والثالث من أقسام العموم هو: العام الذي استفيد عمومه من جهة العقل دون اللغة والعرف وهو: ما يسمى بالعموم العقلي وهو على أربعة أنواع وهي:
الأوّل: عموم الحكم لعموم عِلَّته كما في القياس.
والثاني: عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي كقوله: «والله لا أكلت»، فإنه يحنث بكلِّ مأكول، فإن صرَّح بالمفعول كان من قبيل العموم اللغوي كما لو قال: «و الله لا أكلت شيئًا».
والثالث: في المفهوم فإنه يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه سواء على موافقة المنطوق به أو على مخالفته، وهو مذهب جمهور العلماء، كالضرب والشتم وغيرها من المسكوت عنه في تحريم التأفيف في قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، ولا زكاة في كلِّ ما ليس بسائمة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»(2). هذا ظاهر في مفهوم الموافقة، أمَّا مفهوم المخالفة فالتحقيق أنه لا عموم له في غير جنس المذكور ‑كما سيأتي بيانه‑(3).
والرابع: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن غيلان الثقفي وكان قد أسلم وتحته عشرة نسوة: «أَمْسِكْ أَرْبعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»(4)، فلم يستفسر منه أَعَقَدَ على أولئك النسوة بعقد واحدٍ في زمنٍ واحدٍ أم بعقود مُتعدِّدة في أزمان مختلفة ؟ فتركه للسؤال عن ذلك يفيد العموم. وكذلك فيما يرجع إلى سؤال السائل عن أمرٍ فإنَّ حكمه له يعمُّ كُلَّ مُكلَّفٍ(5 «مفتاح الوصول» للتلمساني (507) والمصادر الأصولية المثبتة على هامشه.).
ولعلَّ الأفضل ‑في عنوان المصنِّف‑ إفراد لفظة «أبواب» إلى «باب»؛ لكونه أبلغ من حيث الشمول، والجمع قد لا يشمل الأحكام الخاصَّة، ولأن نفي الفرد يستلزم نفي الجمع ولا العكس، ومن جهة أخرى يقع التوازن مع غيره من أبواب الكتاب، ومن حيث التجانس ‑أيضًا‑ تنسجم لفظة «مسائله» على «أقسامه» ليكون موافقًا لما تحتويه فصول باب العموم، ويكون العنوان على التركيب التالي: «باب العموم ومسائله»، ولعلَّ ذلك هو مقصود المصنِّف من تلك اللفظة(6).
‑ ومن جهة أخرى فالمصنِّف لم يصدِّر في باب العموم بتعريف لمعناه كما لم يتناوله في «إحكام الفصول في أحكام الأصول» مكتفيًا بما عرفه في كتاب «الحدود في الأصول» بقوله: «العموم: استغراق ما تناوله اللفظ»، وهذا التعريف ليس مانعًا إذ لا يحترز به من أسماء الأعداد، والمطلق، وصيغ العموم التي يكون المقصود بها فردٌ واحدٌ. والأَوْلى تعريف العام بأنه: «اللفظُ المستغرقُ لجميعِ ما يَصلحُ له بحَسَب وضع واحد، دفعةً واحدةً من غير حصر»(7).
‑ ف «اللفظ» في تعريف العامِّ قيدٌ لإخراج العموم المعنوي أو المجازي؛ لأنَّ الحكم فيه مختلف، مثل قولك: «المطر عام»، فلا يتَّحد الحكم فيه في أماكن نزوله، بخلاف قولك: «أكرم الطلاب» فالحكم فيه متّحد على جميع الطلاب من غير تخصيص أو استثناء، كما يخرج من هذا القيد الألفاظ المركبة التي تفيد العموم بأكثر من لفظ كقولك: «كلام منتشر».
‑ «ما يصلح له» قيدٌ يقصد منه تحقيق معنى العموم والاحتراز من اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصلح مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النساء: 54]، فلفظ ﴿النَّاسَ﴾ صيغة عموم ولكن المقصود بها فرد واحد وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
‑ «بحَسَب وضع واحد» ليخرج منه اللفظ المشترك كالعين والقُرْء، فلا يسمَّى عامًّا بالنسبة للجارية والباصرة، وللحيض والطهر؛ لأنَّه لم يوضع لهما وضعًا واحدًا، بل لكلٍّ منهما وضع مستقلٌّ، أمَّا اللفظ العامُّ، فهو: اللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد، هذا المعنى عام شامل لكلِّ أفراده، و لهذا يجب العمل باللفظ العام دون اللفظ المشترك إلاَّ بعد وجود القرينة المعيِّنة لأحد المعاني، اللهمَّ إلاَّ على رأي من يجوِّز استعمال المشترك في جميع معانيه إن أمكن.
‑ والاستغراق في العامِّ يشمل جميعَ أفرادِه في آنٍ واحدٍ، وهو قَيْدٌ لإخراج المطلق؛ لأنّ استغراق المطلق بدلي لا دفعة واحدة، وقيد لإخراج النكرة منه في سياق الإثبات كقولك: «اضرب رجالاً»، فإنّ استغراقها بدلي يحقّق الضرب في أقلّ الجمع وهو ثلاثة رجال.
‑ «من غير حصر» قيدٌ تخرج منه أسماء الأعداد مثل قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]؛ لأنَّ الاستغراق في العامِّ لا حدَّ له ولا حصر.
فـصل
[ في حكم العمل بالعموم ]
• قال الإمام الباجي -رحمه الله- في [ص 186]:
«فَإِذَا وَرَدَ شَيْءٌ مِنْ أَلْفَاظِ العُمُومِ المَذْكُورَةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَيُصَارُ إِلَى مَا يَقْتَضيهِ الدَّلِيلُ».
[م] العموم ‑في اللغة‑ له صيغة خاصَّة به، موضوعة له، تدلُّ على العموم حقيقة، ولا تحمل على غيره إلاَّ بقرينة، وهي الصيغ السابقة، وهذا مذهب الجمهور الذي رجَّحه المصنِّف وهو الصحيح، ويكفي للدلالة على صحَّته: إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنَّ تلك الصيغ للعموم، فقد كانوا يجرُونها حال ورودها في الكتاب والسنَّة على العموم ويأخذون بها، ولا يطلبون دليل العموم، بل كانوا في اجتهاداتهم يطلبون دليل الخصوص، وفهمهم للعموم إنما كان من صِيَغِهِ وألفاظه، جرى ذلك عندهم من غير نكير، ومن الوقائع التي عمل الصحابة فيها بالعموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾[المائدة: 38]، وقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ [النساء: 34]، فهذه الآيات وغيرها تفيد العموم بسبب وجود الألف واللام غير العهدية، فالاسم المحلى بالألف واللام يفيد الاستغراق والعموم سواء مفردًا أو جمعًا، وقد استدلّ أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»(8)، وسَلَّم له بقية الصحابة رضي الله عنهم احتجاجه بهذا العموم، واحتجاجه ‑أيضًا‑ بلفظ «الناس» من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»(9)، ولم ينكر عليه أحدٌ منهم إفادته للعموم، ونظائره كثيرة.
وأثر هذه المسألة يظهر في أنَّ هذه الألفاظَ تفيد العموم من غير حاجة إلى قرائن على مذهب الجمهور، وتفتقر إلى قرينة عند غيرهم(10)، فإن قال رجل لزوجته: «إذا قدم الحاج فأنت طالق»، فهي لا تطلق إلاَّ بعد قدوم جميع الحجاج، فلو رجع بعضهم، أو مات أحدهم فلا تُطلَّق على مذهب الجمهور خلافًا لغيرهم.
هذا، وحرِيٌّ بالتنبيه أنَّ اللفظ العامَّ يجب اعتقاد عمومه قبل ظهور المخصِّص، فإذا ظهر فإنَّه يتغيَّر الاعتقاد السابق؛ لأنَّ الأصل عدم المخصِّص، ويكفي ظنّ عدم المخصِّص في إثبات اللفظ العامِّ.
[ في الاحتجاج بالعام المخصَّص ]
• قال أبو الوليد -رحمه الله- في [ص 188]:
«فَإِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ أَلْفَاظِ العُمُومِ بَقِيَ بَاقِي مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ العَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا، يُحْتَجُّ بهِ كَمَا كَانَ يُحْتَجُّ بهِ لَوْ لَمْ يُخَصَّ شَيْءٌ مِنْهُ».
[م] اللفظ العامُّ سواء كان أمرًا أو نهيًا أو خبرًا يجوز تخصيصه بدليل صحيح، ويجب العمل به في صورة التخصيص وإهمال دلالة العامِّ عليها، وتبقى دلالة العامِّ حُجَّة قاصرة على ما عدا صورة التخصيص، سواء كان المخصِّص مُتَّصلاً أو منفصلاً، وهذا مذهب جمهور العلماء الذي قرَّره المصنِّف وهو الراجح من أقوال أهل العلم، ويكفي للدلالة على صحَّة هذا المذهب إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الاحتجاج بالعُمومات مع أنَّ معظمها مخصوص، فمن إجماعاتهم: احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، مع دخول التخصيص على الآيتين كالصبي، والمجنون، والمكره، والجاهل، وكاحتجاج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ﴾ [النساء: 11] على طلب حقِّها في الميراث ولم ينكر عليها أبو بكر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة مع أنَّ الآية مخصَّصة بعدم توريث الكافر والقاتل والعبد، وكذا ما احتجَّ به عليها أبو بكر رضي الله عنه على سبيل التخصيص للآية السابقة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»(11).
[ في جواز تخصيص العام إلى أن يبقى فردًا واحدًا ]
• وقول المصنّف في هذا الفصل من [ص 189]:
«…وَكَذَلِكَ لَوْ وَرَدَ تَخْصِيصٌ آخَرُ لَبَقِيَ اللَّفْظُ العَامُّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ».
[م] يجوز التخصيص إلى أن يبقى العامُّ فردًا واحدًا مُطلقًا، سواء كان جمعًا كالرجال، أو غير جمع كـ «من» و«ما»، وتبقى دلالة العام حجّة قاصرة على ذلك الفرد الباقي بعد التخصيص، وهو مذهب الجمهور، وبه قال مالك -رحمه الله- وهو الصحيح، ويشهد لهذا المذهب وقوعه في القرآن واللغة، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9] ومُنزّل الذِّكْرِ هو الله تعالى، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: 199]، والمقصود به «إبراهيم عليه السلام»، وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النساء: 54]، والمقصود ب ﴿النَّاسَ﴾ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ [النور: 26]، والمقصود به «عائشة» رضي الله عنها، وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «إني قد وجهت إليك ‑أو أمددتك‑ بألفي رجل، عَمرو بن مَعْدِي كَرِبَ(12)، وطُليحة بن خُويلِد(13)، فشاورهما في الحرب ولا تولهما شيئًا»(14)، ولم يرد نكير في إطلاق ألف على كلِّ واحدٍ منهما(15).
[ في المخصِّصات المتصلة ]
• وقول الباجي -رحمه الله- بعدها:
«وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ التَّخْصيصُ وَالبَيَانُ مَعَ اللَّفْظِ العَامِّ».
[م] التخصيص نوعٌ من البيان إذا ارتبط بالمبيّن على صفة تحدّ من عمومه(16)، سواء كان التخصيص منفصلاً أو متَّصلاً، والمخصِّصات التي ترتبط بكلام آخر ولا تستقلُّ بنفسها هي المخصِّصات المتصلة منها: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، واقترانها بالعامِّ يُعدُّ من وجوه الفرق بين التخصيص والنسخ الذي يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ، والأحناف يطلقون على الاستثناء بيان التغيير، وعلى النسخ بيان التبديل(17).
[ في حكم تأخير البيان ]
• وفي الصفحة نفسها قال -رحمه الله-:
«وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ إِلَى وَقْتِ فِعْلِ العِبَادَةِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ الوَقْتِ».
[م] لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند عامَّة العلماء إلاَّ على من يرى جواز التكليف بما لا يطاق، والصحيح أنَّ الفعل المكلَّف به يشترط في صحّة التكليف به شرعًا أن يكون ممكنًا، فإن كان محالاً لم يجز الأمر به، والتفريع على شرط الإمكان يتولَّد عنه عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وصورته أن يقول: صلوا غدًا، ثمَّ لا يبيِّن لهم في غدٍ كيف يصلُّون، أو يقول: آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثمَّ لا يبيِّن لهم عند رأس الحول كم يؤدُّون ونحو ذلك.
أمَّا تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فجائز مطلقًا سواء كان المقصود بيان ما له ظاهر يفهم ويعمل به كالعام والمطلق، أو ما ليس له ظاهر كالمجمل وهو مذهب جمهور العلماء خلافًا للمانعين والمفصِّلين، وصورته: أن يقول وقت الفجر مثلاً: صلوا الظهر، ثمَّ يؤخِّر بيان أحكام الظهر إلى وقت الزوال، أو يقول: حجّوا في عشر ذي الحجّة ثمَّ يؤخِّر بيان أحكام الحجِّ إلى دخول العشر(18).
ومذهب الجمهور القاضي بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة مطلقًا هو الصحيح لوقوعه مطلقًا، و«الوُقُوعُ دَلِيلُ الجَوَازِ»، وممَّا وقع في الكتاب والسنّة قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 19]، و«ثمَّ» للتراخي، فدلَّت على تراخي البيان عن وقت الخطاب، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، فأخَّر بيان أفعال الصلاة وأوقاتها حتى بيَّنها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ بيَّنها صلى الله عليه وآله وسلم لأُمَّته فقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(19)، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاديرَ الزكوات ونوع الأجناس بالتدريج، وبيّن أفعال الحجّ وأحكامَه بعد نزول آية الحجّ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(20)، ومن ذلك أيضًا، قوله تعالى لنوح عليه السلام: ﴿احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ [هود: 40]، وأخّر بيان أنّ ولده الذي غرق ليس من الأهل الموعود بنجاتهم حين قال نوح: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: 45]، فبيَّن له تعالى أنه ليس من أهله، وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة: 228]، ثمَّ ورد التَّخصيص بعد ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، ولأنَّ النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأوَّل ولا خلاف في جواز تأخير بيانه إلى وقته، إلى غير ذلك من الأدلَّة وهي كثيرة، لا سبيل إلى إنكارها(21).
فـصل
[ في أقـل الجمع ]
• قال المصنّف -رحمه الله- في [ص 190]:
«أَقَلُّ الجَمْعِ اثْنَانِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَحَكَى القَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الطَّيِّبِ أَنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ».
[م] ليس من محلِّ النِّزاع المفهوم من لفظ «الجمع» لغةً إجماعًا؛ لأنَّه ضَمُّ شيء إلى شيء، وذلك موجود في الاثنين والثلاثة وما زاد، كما لا خلاف في أنَّ أقلَّ الجمع في لفظ «الجماعة» في غير الصلاة ثلاثة، وفي الصلاة اثنان، ويخرج أيضًا من محلِّ النِّزاع ما لو قصد المتكلِّم بلفظ الجمع التخفيف، كقول القائل: «ضربتُ رؤوسَ الرَّجُلين» أو «وطئتُ بطونَهما»، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4]، كما يخرج عنه تعبير الاثنين عن نفسيهما بضمير الجمع سواء كان ضمير المتكلِّم مُتَّصلاً مثل: «عملنا»، أو منفصلاً مثل: «نحن»، وهذا يصدق ـ أيضًا ـ على الواحد عن نفسه بضمير الجمع، وليس من محلِّ الخلاف الجمع المعرف ب «أل» كالرجال فإنَّه يفيد الاستغراق، وإنما يتعيَّن محلُّ النِّزاع في الجمع المذكَّر السالم المنكَّر ك «مسلمين»، وجمع المؤنَّث السالم: ك «مسلمات»، وجمع الكثرة المنكر ك «جِمَال» و«رِماح»، أو جمع القِلَّة المنكَّر وهو على أربعة أوزان: الأوّل: «أَفْعِلَةٌ» ك «أطعمة»، و«أعمدة»، والثاني: «فِعْلَة» ك «فتية» و«شيخة»، والثالث: «أَفْعَالٌ» ك «أحمال» و«أبواب»، والرابع: «أَفْعُلٌ» ك «أعين» و«أذرع»(22)، كما أنَّ مِن محلِّ النِّزاع «واو» الجمع ك «دخلوا» أو «خرجوا»، والمصنِّف فيها اختار أنَّ أقلَّ الجمع اثنان حقيقةً وعلى الواحد يطلق مجازًا، وهو مذهب القاضي الباقلاني وابن الماجشون(23) وداود الظاهري وأبي إسحاق الإسفرائيني، وبه قال الخليل بن أحمد(24) وسيبويه(25)وعلي بن عيسى النحوي وغيرهم، واستدلَّ المصنِّف بقوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: 78]، فقد جمع الله في الآية بين حكم سليمان وداود بضمير الجمع في قوله: ﴿لِحُكْمِهِمْ﴾ فدلَّ ذلك على أنَّ أقلَّ الجمع اثنان، وأجيب عن هذا الدليل بأنَّ ضمير الجمع يرجع إلى أربعة وهم: الحاكمان: داود وسليمان عليهما السلام، والمحكوم له: وهو صاحب الزرع، والمحكوم عليه: وهو صاحب الغنم. والدليل الثاني الذي احتجّ به المصنِّف على مذهبه قوله تعالى: ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: 15]، فقد أطلق فيه ضمير الجمع المتمثّل في لفظه ﴿مَعَكُم﴾ وأُرجِع إلى موسى وهارون عليهما السلام، واعترض على هذا الدليل بأنَّ الضمير يرجع إليهما وإلى فرعون الذي أُمِرَا بأن يذهبا إليه.
أمَّا دليل المصنِّف من اللغة فقولهم: «ظهراهما مثل ظهور الترسين»، وأجيب عن الاستشهاد بهذا البيت بأنه خارج عن محلِّ النِّزاع؛ لأنَّ المقصود بالجمع في لفظ «ظهور» التخفيف، فإنه لو قال: «ظهري» لثقل اجتماع ما يدلُّ على التثنية فيما هو كالكلمة الواحدة(26).
والظاهر أنَّ مذهب القائلين أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة ويطلق على الاثنين والواحد مجازًا أقوى وهو مذهب جمهور أهل العلم لما رواه الحاكم والبيهقي(27) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال: لِمَ صار الأَخَوان يَرُدَّان الأم إلى السدس، وإنما قال الله: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ [النساء: 11]، والأَخَوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس»(28)، فهذان الصحابيان من أهل اللسان واللغة يتّفقان على أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثةٌ وإنما عدل عثمان رضي الله عنه في مسألة حجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود قرينة صارفة وهي إجماع من قبله على خلافه، فصحَّ ما قاله ابن عباس رضي الله عنه من أنَّ الأخوين ليسا بإخوة في كلام العرب ولغتهم، الأمر الذي يدلُّ على أنَّ أقلَّ الجمع حقيقة ثلاثةٌ؛ لأنَّ الجمع لا يُطلق على الاثنين إلاَّ على وجه المجاز(29)، وهذا الأثر ‑وإن لم يصحَّ سندُه‑ إلاَّ أنه يؤكِّد معناه إجماع أهل اللغة على التفريق بين الجمع والتثنية في الضمير المنفصل، فقالوا في الجمع «هم» وفي التثنية: «هما»، كما فرَّقوا بين الجمع والتثنية بالتوكيد مثل: «أقبل الطلاَّب أنفسهم»، وأمَّا في التثنية فقالوا: «أقبل الطالبان أنفسهما»، كما فرَّقوا بينهما في الضمير المتصل فقالوا في الجمع: «عملوا» و«اعملوا»، وفي التثنية: «عملاَ» و«اعملا»، وهذا ما يفسِّر أنَّ مرتبة الجمع غيرُ مرتبة التثنية، فالثلاثة تُنعت بالجمع والجمع يُنعت بالثلاثة، لكن التثنية لا تنعت بالجمع ولا ينعت الجمع بالتثنية، وإذا كان في الاثنين فمن باب أولى الواحد، فدلَّ ذلك على أنَّ أقل الجمع يكون حقيقة في الزائد على الاثنين وهو ثلاثة، ويؤيِّده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ»(30)، وبما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الشَّيْطَانُ يَهِمُّ بِالوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً لَمْ يَهِمَّ بِهِمْ»(31)، والحديثان ظاهران في فصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين التثنية والجمع، وجعل للاثنين حكمًا خاصًّا دون الجمع، فظهر جليًّا أنَّ التثنية ليست بجمع حقيقة، ولا يعترض بأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: «الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا»(32)؛ لأنَّه ورد في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد قال عنه الإمام أحمد: «إنه مضطرب الحديث»، وقال عنه يحي بن معين: «لا يحتجُّ بحديثه»(33)، ولو ثبت فمراده إفادة ذلك مجازًا، أو حمل كلامه على خصوص مسألة حجب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين(34).
والخلاف في هذه المسألة ينبني عليه آثار فقهية منها:
‑ الصلاة على الميت لا تصحُّ إلَّا بثلاثةٍ عند مَن يرى أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثةٌ، ولا تصحُّ إلاَّ بالاثنين عند من قال أنَّ أقلَّ الجمع اثنان، أو بالواحد عند من يرى أنَّ أقلَّ الجمع واحد.
‑ ومن ذلك من نذر أن يصوم أيامًا من غير تعيينٍ فيلزمه ثلاثة أيام على القول الأوَّل، ويلزمه يومان على القول الثاني، ويوم واحد على القول الثالث.
‑ وكذلك إذا أقسم أن لا يكلِّم الناس فإنه لا يحنث إلاَّ إذا كلَّم ثلاثة من الناس خلافًا لمن قال بأنَّ أقلَّ الجمع اثنان أو واحد.
‑ ومن ذلك أيضًا المقرُّ لغيره بدراهم أو ثياب أو بأي جِنس من الأجناس وعبَّر عنه بلفظ الجمع غير المنصوص على عدد(35) فإنه يلزمه ثلاثة دراهم أو أثواب على المذهب الأول أو اثنان على المذهب الثاني أو واحد على المذهب الثالث.
فـصل
[ الاختلاف في تناول لفظ الجمع المذكر للنساء ]
• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص 193]:
«إِذَا وَرَدَ لَفْظُ الجَمْعِ المُذَكَّرِ لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ جَمَاعَةُ المُؤَنَّثِ إِلاَّ بدَلِيلٍ، لأَنَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ لَفْظًا يَخْتَصُّ بهِ فِي مُقْتَضَى اللُّغَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: 35]».
[م] لا خلاف بين العلماء في عدم دخول كلِّ واحد من المذكَّر والمؤنث في الجمع المختصّ به أحدهما كلفظ «الرجال» للمذكر، فإنَّ النساء لا يدخلن فيه اتفاقًا، أو لفظ «النساء» للمؤنث فإنَّ الرجال لا يدخلون فيه اتفاقًا، ولا خلاف في دخولهما في الجمع الذي لم تذكر فيه علامة التذكير ولا التأنيث كالبشر والناس، فإنَّ لفظ الجمع بهذا المعنى يتناول الذكور والإناث لغةً ووضعًا بالاتفاق، ومن هذا القبيل ‑أيضًا‑ أسماء الشرط والاستفهام التي لا تظهر فيها علامة التذكير والتأنيث، فإنَّ لفظ الجمع فيها يتناول الذكور والإناث بالاتفاق، وإنما الخلاف في هذه المسألة واقع في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالجمع بالواو والنون نحو: «مسلمون» و«مؤمنون»، أو الجمع بضمير الجمع نحو: «عملوا» و«جاهدوا» و«كلوا» و«اشربوا»، فهل هذا الجمع يتناول الإناث ؟ فالمصنِّف اختار مذهبَ القائلين أنَّ جماعة المؤنَّث لا يدخلن في الجمع الذي تبيَّنت فيه علامة التذكير إلاَّ بدليل خارجي وهو مذهب جمهور الحنفية وبعض المالكية كالباقلاني وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة كالطوفي(36)، وممَّا استدلَّ لهم المصنِّف أنَّ الله تعالى في الآية السابقة خصّ الذكور بخطاب والإناث بخطاب آخر، ولما حرص على تخصيصهنَّ بألفاظ مميَّزة دلَّ ذلك على عدم دخولهنَّ في الخطابات التي ظهرت علامة التذكير فيها إلاَّ بقرينة أو دليل.
وقد أجيب عن هذا الدليل بأنَّ تخصيص الإناث بألفاظ ونون النسوة إنما هو للبيان والإيضاح والتأكيد عليهنَّ، وهذا لا يلزم عدم دخولهنَّ في اللفظ العامِّ، إذ قد يجيء لفظ عامٌّ شاملٌ للأعيان مع أنه يخصُّ بعض الأفراد بالذكر، كما يعطف الخاصّ على العامّ لمزيد اهتمام وتأكيد مثل قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا للهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: 98] فإن تخصيص جبريل وميكال عليهما السلام بالذِّكر لا يلزم عدم دخولهما في لفظ «الملائكة» و«الرسل» فهما لفظان شاملان لكلِّ الملائكة والرسل، وكذلك لفظ «المسلمين» شامل للذكور والإناث، لكن لما عطف عليه لفظ «المسلمات» كان ذلك زيادة في التأكيد وتخصيصًا للشيء بالذِّكر.
هذا، ولعلَّ أصحَّ المذهبين قول القائلين بدخول النساء في الجمع الذي تبيّنت فيه علامة التذكير، سواء بالجمع بالواو والنون، أو الجمع بضمير الجمع، وهو ما عليه أكثر الحنابلة، وبعض الشافعية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ودليل صحّته انعقاد الإجماع على أنّ النساء يدخلن في الصيغة الخاصّة بالذكور في جميع خطابات الشرع العامَّة، وأكثر أوامره ونواهيه مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقوله تعالى: ﴿وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ﴾ [الأعراف: 31]، وقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ [الإسراء: 32]، فلو كانت صيغ هذه الأحكام والخطابات خاصّة بالذكور لما تعدَّى إلى الإناث، فدلَّ ذلك على دخولهنَّ في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير، ويؤيِّد ذلك أيضًا أنَّ المألوف عند العرب في خطاباتهم تغليب التذكير على التأنيث في حالة اجتماع الذكور والإناث ولو كان الذكر واحدًا، وقد وقع مثل هذا في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [البقرة: 38]، فكان الخطاب واردًا على «آدم» و«حواء» و«إبليس»، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ»(37)، فسمَّى الإقامةَ أذانًا من باب تغليب التذكير لشرفه، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: 11]، فغلب جانب الأب على الأمِّ، والأمثلة على قاعدة التغليب المعتادة عند العرب متكاثرة(38)، وهي معمول بها في خطاباتهم وكلامهم، والقرآن الكريم إنما نزل بلغة العرب فدلَّ ذلك على أنَّ النساء يدخلن في الجمع الذي تبيَّنت فيه علامة التذكير ولا يخرجن إلاَّ بدليل؛ ولأنَّ النساء شقائقُ الرجال ولا يخرجن من الخطاب الإلهي إلاَّ بدليل.
هذا، ومن فروع هذه المسألة الاختلاف في:
‑ صحَّة دعاء المرأة بالجمع المذكَّر كأن تقول: «وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ»، «وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ»، فعلى من يرى دخولها في الجمع المذكَّر قال: يكفيها أن تقول ذلك بخلاف من منع ذلك إلاَّ بدليل.
‑ ومن هذا القبيل الوصية والعطية، فمن قال لجمعٍ من الرجال والنساء: «وهبتكم عقاري» أو «لكم ثلث مالي بعد وفاتي» فعلى من يدخل النساء في خطاب الرجال بالجمع المذكَّر قال: يشاركن الرجالَ في العطية والوصية، وعلى المذهب الآخر الذي ارتضاه المصنِّف فلازمه أنَّ النساء لا حقَّ لهنَّ في العطية والوصية لافتقار الدليل الخارجي.
فـصل
[ في الخاص الذي أريد به العام ]
• قول المصنِّف -رحمه الله- في [ص 195]:
«وَمِمَّا خُصَّ أَوَّلُهُ وَعُمَّ آخِرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]».
[م] هذا المثال الذي ساقه المصنِّفُ ليس بين العموم والخصوص تعارض حتى يقصر الخاصّ على أفراده المخصوصة ويعمل بالعامّ فيما عداه من الأفراد الداخلة تحت عمومه، وإنما يندرج هذا المثال في باب: «تخصيص بعض أفراد العموم بالذِّكر»، لذلك استدلَّ بالآية على أنَّ خطاب الشرع عامٌّ للنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ولأُمَّته ولا يخرج عن العموم إلاَّ بدليلٍ خاصٍّ، وهذا معلومٌ من استقراء القرآن الكريم أنَّ الله يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بخطابٍ لفظه خاصّ ويكون المراد منه تعميم الحكم، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الأحزاب: 1]، ثمَّ قال: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: 2]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾، إلى أن قال سبحانه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 1، 2]، وقوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ ثمَّ قال سبحانه: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ﴾ [الروم:30، 31]، فهذه الآيات شواهد على ما خصّ أوَّله بلفظ خاصّ لكن المقصود منه تعميم الحكم إلاَّ إذا ورد دليل على الخصوصية.
--------------------------------------------------------------------------------
1- انظر: العموم العرفي في «مفتاح الوصول» للتلمساني (504) والمصادر الأصولية المثبتة على هامشه.
2- هو جزء من حديث طويل وفيه: «…وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة»، قال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم». انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (2/175). والحديث أخرجه أحمد (1/11)، والبخاري (3/317)، وأبو داود (2/214)، والنسائي (5/27)، والبيهقي (4/86)، والحاكم (1/390)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (6/3)، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعًا. والحديث يمكن أن يكون مثالاً للعموم اللغوي باعتبار إضافته إلى معرفة.
3- انظر: (المقال التاسع ، الهامش 42).
4- الحديث أخرجه الترمذي (3/435)، وابن ماجه (1/628)، وأحمد في «مسنده» (2/13)، والدارقطني في «سننه» (3/269)، والحاكم في «المستدرك» (2/192)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. [انظر: «صحيح الترمذي» للألباني (1/574)، و«صحيح ابن ماجه» له (2/151)، و«إرواء الغليل» (رقم: 1883)].
5- انظر العموم العقلي في «مفتاح الوصول» للتلمساني (507) والمصادر الأصولية المثبتة على هامشه.
6- يوجد تقسيم آخر للعام من حيث مرتبته وسعته يتمثّل في: عام لا أعمّ منه كالمعلوم والمذكور وهو شامل لجميع الموجودات والمذكور، وخاص لا أخصّ منه كالأعيان والأشخاص، وواسطة هي أعمّ مما تحتها وأخص مما فوقها، كالحيوان فإنه أعمّ من الإنسان وأخص من النامي، والنامي أعمّ من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا. [انظر «شرح مختصر الروضة» للطوفي (2/461) و«مذكرة» الشنقيطي (204)].
كما يوجد تقسيم ثالث للعام باعتبار بقائه على عمومه أو دخول التخصيص عليه أو إرادة بعض أفراده، فالأول هو العام المحفوظ والثاني العام المخصوص، والثالث هو العام الذي أريد به الخصوص. [انظر: «الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول لابن باديس» (120)].
ولا يخفى أنّ هذين التقسيمين غير مرادين لاتجاه المصنِّف إلى صيغ العموم وألفاظه وهو العموم اللغوي، وقسيماه ‑في هذا المجال‑ هما العموم العرفي والعقلي.
7- انظر: «كشف الأسرار» للبخاري (1/33)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (112)، «أصول الفقه» لزكي الدين شعبان (322)، «تفسير النصوص» محمَّد أديب صالح(2/9-10).
8- أخرجه أحمد في «مسنده» (3/129)، وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، وله طرق أخرى من حديث علي بن أبي طالب وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنهما، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (2/298)، وفي«صحيح الجامع الصغير» (2/406).
9- متفق عليه: أخرجه البخاري (3/262)، ومسلم (1/262) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
10- انظر اختلاف العلماء وأدلَّتهم في صيغة العموم ومحاملها في المصادر المثبتة على هامش كتاب «الإشارة» (ص 187).
11- أخرجه البخاري (12/5)، ومسلم (12/80)، وأبو داود (3/381) من حديث عائشة رضي الله عنها.
12- هو الصحابي أبو ثور عمرو بن مَعْدي كَرِب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم الزبيدي رضي الله عنه أسلم سنة تسع، وشهد عامة الفتوح بالعراق، وكان فارسًا مشهورًا بالشجاعة، وشاعرًا محسنًا، مات يوم القادسية، وله في الإسلام بلاء حسن، وقيل: مات بعد واقعة نهاوند سنة (21ه).
انظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر (3/1201)، «أسد الغابة» لابن الأثير (4/132)، «الإصابة» لابن حجر (3/18).
13- هو الصحابي طُليحة بن خُويلد نوفل الأسدي رضي الله عنه أسلم سنة تسع، ثمّ ارتدّ وادعّى النبوة، وتمت له حروب مع المسلمين، ولحق بالغسانيين بالشام لما انهزم، ثمّ أسلم وحسن إسلامه، وكان فارسًا مشهورًا يضرب بشجاعته المثل، شهد القادسية ونهاوند، وتوفي سنة (21ه).
انظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر (2/773)، «أسد الغابة» لابن الأثير (3/65)، «دول الإسلام» (1/17)، «سير أعلام النبلاء» كلاهما للذهبي (1/316)،«الإصابة» لابن حجر (2/235)، «شذرات الذهب» لابن العماد (1/32).
14- رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (17/45. رقم: 97)، قال البيهقي في «مجمع الزوائد» (5/576): «رواه الطبراني هكذا منقطع الإسناد».
15- قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (1/317): «قال محمَّد بن سعد: كان طليحة يُعَدُّ بألف فارسٍ لشجاعته وشِدَّته».
16- انظر: «الإحكام» لابن حزم (1/89).
17- انظر: «كشف الأسرار» للبخاري (3/106) وما بعدها.
18- «شرح مختصر روضة الناظر» للطوفي (2/688).
19- أخرجه الشافعي في «مسنده» (55)، والبخاري (2/111) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، في أوله قصة وفي آخره: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». والحديث متفق عليه إلَّا هذا الطرف من الحديث فهو من أفراد البخاري، [«صحيح مسلم» (5/174)، «سنن البيهقي» (2/17)].
20- أخرجه أحمد في «مسنده» (3/318، 337، 367، 378)، ومسلم (9/44)، وأبو داود (2/495)، وابن ماجه (2/1006)، والنسائي (5/270)، والبيهقي في«السنن الكبرى» (5/130)، والبغوي في «شرح السنّة» (7/179) بألفاظ متقاربة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وتمامه: «فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ».
21- انظر: تفصيل المذاهب وأدلّتها على هذه المسألة في المصادر المثبتة على هامش كتاب «الإشارة» (ص 190).
22- انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (233).
23- هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة بن الماجشون التيمي، العلامة الفقيه تلميذ الإمام مالك، وعنه تفقه أئمة كابن حبيب وابن معذل وسحنون، كان فصيحًا مفوهًا، وعليه دارت الفتيا في زمانه بالمدينة، توفي سنة (312ه).
انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/442)، «التاريخ الكبير» (5/424)، «التاريخ الصغير» كلاهما للبخاري (2/300)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/358)، «طبقات الفقهاء» للشيرازي (148)، «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (1/360-365)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (3/166-167)، «سير أعلام النبلاء» (10/359-360)، «الكاشف» (2/211)، «ميزان الاعتدال» كلها للذهبي (2/658-659)، «الديباج المذهب» لابن فرحون (153-154)، «تهذيب التهذيب» (6/407-409)، «تقريب التهذيب» كلاهما لابن حجر (1/520)، «وفيات ابن قنفذ» (40)، «شذرات الذهب» لابن العماد (2/28)، «الفكر السامي»للحجوي (2/3/94)، «شجرة النور» لمخلوف (1/56).
24- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (191).
25- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (192).
26- انظر: المصادر المثبتة على هامش كتاب «الإشارة» (ص 193).
27- هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي الخُسْرَوجِرْديُّ، الحافظ الكبير، الفقيه الشافعي، العلامة الثبت، من أجلِّ أصحاب أبي عبد الله الحاكم، والمكثرين عنه، من مشهور كتبه: «السنن الكبرى»، و«شعب الإيمان»، و«دلائل النبوة»، توفي سنة (458ه).
انظر ترجمته في: «معجم البلدان» لياقوت (1/538)، «اللباب» لابن الأثير (1/202)، «الكامل» لابن الأثير (10/52)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1/75)،«طبقات الشافعية» للإسنوي (1/98)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (18/163)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/94)، «وفيات ابن قنفد» (56)، «طبقات الحافظ»للسيوطي (432)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/304)، «الفضل المبين» للقاسمي (359)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني (33).
28- أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/335)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (6/227)، وابن حزم في «المحلى» (9/258)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقرّه الذهبي في التلخيص على صحَّته، قال ابن كثير في «تفسيره» [2/198-199] معقّبًا على ذلك بقوله: «وفي صحَّة هذا الأثر نظر، فإنَّ شعبة هذا تكلَّم فيه مالك بن أنس، ولو كان صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به»، ورده الحافظ -أيضًا- في «التلخيص» (3/85) بقوله: «وفيه نظر، فإنَّ فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعَّفه النسائي». والحديث ضعَّفه الألباني في «الإرواء» (6/122).
29- انظر: «المحلى» لابن حزم (9/258)، «شرح مختصر الروضة» للطوفي (2/498)، والمصادر المثبتة على هامش «الإشارة» (193).
30- أخرجه مالك في «الموطأ» (3/144)، وأبو داود (3/80)، والترمذي (4/193) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، والحديث حسَّنه الألباني في«صحيح سنن أبي داود» (2/124)، والأرناؤوط في «شرح السنة» للبغوي (11/21).
31- أخرجه مالك في «الموطأ» (3/144)، وقال ابن عبد البر: إنه مرسل باتفاق رواة الموطأ على ما نقله الزرقاني في «شرح الموطأ» (4/21)، وقال السيوطي في «تنوير الحوالك» (3/144): «وصله قاسم بن أصبغ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه».
32- أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/335)، والبهيقي في «سننه الكبرى» (6/227) وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (1/483): «هذا موقوف حسن».
33- «تهذيب التهذيب» لابن حجر (6/170).
34- انظر: «أصول الفقه» لابن مفلح (2/783).
35- انظر: «إيضاح المحصول» للمازري (281)، و«مفتاح الوصول» للتلمساني (512).
36- انظر تفصيل الخلاف في المصادر المثبتة على هامش كتاب «الإشارة» (194).
37- أخرجه البخاري (2/110)، ومسلم (6/124)، وأبو داود (2/60)، والترمذي (1/351)، والنسائي (2/28)، وابن ماجه (1/368) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
38- قال الخطابي في «معالم السنن» (2/60): «أراد بأذانين: الأذان والإقامة حمل أحد الاسمين على الآخر، والعرب تفعل ذلك كقولهم: الأسودين للتمر والماء، وإنما الأسود أحدهما، وكقولهم: سيرة العمرين يريد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما فعلوا ذلك لأنَّه أخفّ على اللسان من أن يثبتوا كلّ اسم منهما على حدته ويذكروه بخاصِّ صفته