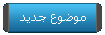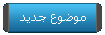الأذكار المتنوعة هل يشرع المداومة على أحدها، أو تلفيق ذكر منها جميعها، أو جمعها في الموضع الواحد؟ بحث قيم لابن تيمية [فائدة انتقاها الشيخ محمد بازمول (2)]
الأذكار المتنوعة هل يشرع المداومة على أحدها، أو تلفيق ذكر منها جميعها، أو جمعها في الموضع الواحد؟
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/243-252): "وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد؛ أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله؛ كما قلنا في أنواع صلاة الخوف.
وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه. ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها. وكما قلنا في أنواع التشهدات. وأنواع الاستفتاحات. وأنواع الاستعاذات . وأنواع القراءات. وأنواع تكبيرات العيد الزوائد. وأنواع صلاة الجنازة. وسجود السهو. والقنوت قبل الركوع وبعـده. والتحميد بإثبات الواو وحـذفها. وغير ذلك.
لكـن قـد يستحب بعـض هـذه المأثورات، ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل، ولا يكره الآخر.
ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادة المتنوعة بين النوعين في الوقت الواحد، لا يمكنه أن يأتي بتشهدين معا، ولا بقراءتين معا، ولا بصلاتي خوف معا، وإن فعل ذلك مرتين، كان ذلك منهيا عنه، فالجمع بين هذه الأنواع محرم تارة، ومكروه أخرى.
ولا تنظر إلى من قد يستحب الجمع في بعض ذلك، مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلوات على النبي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق، وقال في حديث أبي بكر الصديق المتفق عليه ـ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي ـ فقال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كبيرًا)، وفي رواية: (كثيرا)، (وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم). فقال: يستحب أن يقول: كثيرا، كبيرا، وكذلك يقول في أشباه هذا؛ فإن هذا ضعيف، فإن هذا؛
أولا : ليس سنة، بل خلاف المسنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك جميعه جميعا. وإنما كان يقول هذا تارة، وهذا تارة، إن كان الأمران ثابتين عنه، فالجمع بينهما ليس سنة، بل بدعة وإن كان جائزاً.
الثاني: أن جمع ألفاظ الدعاء، والذكر الواحد، على وجه التعبد مثل جمع حروف القراء كلهم لا على سبيل الدرس والحفظ، لكن على سبيل التلاوة والتدبر، مع تنوع المعاني، مثـل أن يقـرأ في الصـلاة :
{فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ اليمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [البقرة:10].{بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ}. {رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} [سبأ: 19]. {بَعِّد بين أسفارنا}. {وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة:74] (عَمَّا يَعْمَلُونَ).{وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ} [الأعراف:157]. {آصارهم}. {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]. {وأَرجُلِكُم}.
{وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].{حتى يَطْهُرْنَ}.
{وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا} [البقرة:229].{إِلاَّ أَن يُخَافَا}.
{أّ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [المائدة: 6]. {أو لَمَسْتُم}.
ومعلوم أن هذا بدعة مكروهة قبيحة.
الثالث: أن الأذكار المشروعة ـ أيضاً ـ لو لفق الرجل له تشهدا من التشهدات المأثورة فجمع بين حديث ابن مسعود، و... وصلواته، وبين زاكيات تشهد عمر، ومباركات ابن عباس، بحيث يقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، والمباركات، والزاكيات، لم يشرع له ذلك، ولم يستحب، فغيره أولى بعدم الاستحباب.
الرابع: أن هذا إنما يفعله من ذهب إلى كثرة الحروف والألفاظ. وقد ينقص المعنى، أو يتغير بذلك، ولو تدبر القول لعلم أن كل واحد من المأثور يحصل المقصود، وإن كان بعضها يحصله أكمل، فإنه إذا قال: ظلما كثيرا، فمتى كثر فهو كبير في المعنى، ومتى كبر، فهو كثير في المعنى.
وإذا قال: (اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد)، أو قال: (اللهم صل على محمد، وأزواجه وذريته)، فأزواجه وذريته من آله بلا شك، أو هم آله. فإذا جمع بينهما وقال: (على آل محمد، وعلى أزواجه وذريته)، لم يكن قد تدبر المشروع.
فالحاصل أن أحـد الذكرين إن وافق الآخر في أصل المعنى، كـان كالقراءتين اللتين معناهما واحـد، وإن كان المعنى متنوعا، كان كالقراءتين المتنوعتي المعنى. وعلى التقديرين، فالجمع بينهما في وقت واحد لا يشرع.
وأما الجمع في صلوات الخوف، أو التشهدات، أو الإقامة أو نحو ذلك بين نوعين، فمنهي عنه باتفاق المسلمين.
وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية لابد من فعلها على بعض الوجوه، كما لابد من قراءة القرآن على بعض القراءات، لم يجب أن يكون كل من فعل ذلك على بعض الوجوه إنما يفعله على الوجه الأفضل عنده، أو قد لا يكون فيها أفضل. وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة، فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم، وليس اختيارهم لطريقهم؛ لأنها أفضل، بحيث يكون حجهم أفضل من حج غيرهم، بل لأنه لابد من طريق يسلكونها، فسلكوا هذه إما ليسرها عليهم، وإما لغير ذلك، وإن كان الجميع سواء، فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند مختاره، وبين كون اختيار واحد منها ضروري. والمرجح له عنده سهولته عليه، أو غير ذلك.
والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر على وجه مشروع، وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه، وأهل بقعته، وقد تكون تلك الوجوه سواء، وقد يكون بعضها أفضل، فجاء في الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفضله، فجاء الآخر فعارضه في ذلك، ونشأ من ذلك أهواء مردية مضلة،فقد يكون النوعان سواء عند الله ورسوله فتري كل طائفة طريقها أفضل،وتحب من يوافقها على ذلك، وتعرض عمن يفعل ذلك الآخر، فيفضلون ما سوي الله بينه، ويسوون ما فضل الله بينه. وهذا باب من أبواب التفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة.وقد نهى عنه الكتاب والسنة،وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عين هذا الاختلاف في الحديث الصحيح،كما قررت مثل ذلك في [الصراط المستقيم]،حيث قال: "(اقرؤوا كما علمتم".
فالواجب أن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي.
لا يجعل نفس تعيين واحد منها لضرورة أداء العبادة موجبا لرجحانه؛ فإن الله إذا أوجب على عتق رقبة، أو صلاة جماعة، كان من ضرورة ذلك، أن أعتق رقبة وأصلى جماعة،ولا يجب أن تكون أفضل من غيرها،بل قد لا تكون أفضل بحال،فلابد من نظر في الفضل، ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان، لم يعب على من فعل الجائز، ولا ينفر عنه لأجل ذلك، ولا يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة، فقد يكون الرجحان يسيرا.
لكن هنا مسألة تابعة، وهو أنه مع التساوي أو الفضل، أيما أفضل للإنسان: المداومة على نوع واحد من ذلك، أو أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟
فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك مختارا له، أو معتقدا أنه أفضل، ويري أن مداومته على ذلك النوع أفضل.
وأما أكثرهم فمداومته عادة، ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته، لا لاعتقاد الفضل.
والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة، وإحياء لسنته، وجمعا بين قلوب الأمة، وأخذاً بما في كل واحد من الخاصة، أفضل من المداومة على نوع معين، لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجوه:
أحدها: أن هذا هو اتباع السنة والشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد فعل هذا تارة، وهذا تارة، ولم يداوم على أحدهما، كان موافقته في ذلك هو التأسي والاتباع المشروع، وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل؛ لأنه فعله.
الثاني: أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها، وزوال كثرة التفرق والاختلاف والأهواء بينها، وهذه مصلحة عظيمة، ودفع مفسدة عظيمة، ندب الكتاب والسنة إلى جلب هذه، ودرء هذه، قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} [آل عمران: 103]، وقال تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران:105]. وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159].
الثالث: أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب، فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب. ولهذا أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه، وقلب غيره أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجبات؛ لأجل العادة التي جعلت الجائز كالواجب.
الرابع: أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحـد مـن تلك الأنواع، فإن كل نوع لابد له من خاصة، وإن كان مرجـوحا، فكيف إذا كان مساوياً، وقد قدمنا أن المرجوح يكون راجحاً في مواضع؟!
الخامس: أن في ذلك وضعا لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله، ولا أثارة من علم، فإن مداومة الإنسان على أمر جائز مرجحاً له على غيره، ترجيحاً يحب من يوافقه عليه، ولا يحب من لم يوافقه عليه، بل ربما أبغضه، بحيث ينكر عليه تركه له، ويكون ذلك سبباً لترك حقوق له وعليه، يوجب أن ذلك يصير إصراً عليه، لا يمكنه تركه، وغلا في عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما أمر به، وقد يوقعه في بعض ما نهي عنه.
وهذا القدر الذي قد ذكرته واقع كثيراً، فإن مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادا ومحبة غير مشروعين، ثم يخرج إلى المدح والذم، والأمر والنهي، بغير حق، ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين، من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس والخزرج في الجاهلية، وأخلاق...
ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع، فيبذل ماله على ذلك عطية ودفعاً، وغير ذلك من غير استحقاق شرعي، ويمنع من أمر الشارع بإعطائه إيجابا أو استحبابا، ثم يخرج من ذلك إلى الحرب والقتال، كما وقع في بعض أرض المشرق، ومبدأ ذلك تفضيل ما لم تفضله الشريعة والمداومة عليه، وإن لم يعتقد فضله سبب لاتخاذه فاضلا اعتقاداً وإرادة فتكون المداومة على ذلك إما منهيا عنها، وإما مفضولة.
والتنوع في المشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل.
السادس: أن في المداومة على نوع دون غيره، هجران لبعض المشروع وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه، حتى يعتقد أنه ليس من الدين، بحيث يصير في نفوس كثير من العامة أنه ليس من الدين، وفي نفوس خاصة هذه العامة عملهم مخالف علمهم، فإن علماءهم يعلمون أنه من الدين ثم يتركون بيان ذلك إما خشية من الخلــق، وإما اشتراء بآيات الله ثمنا قليلا من الرئاســة والمال، كما كان عليه أهل الكتاب، كما قد رأينا من تعود ألا يسمع إقامة إلا موترة، أو مشفوعة، فإذا سمع الإقامة الأخري، نفر عنها وأنكرها، ويصير كأنه سمع أذاناً ليس أذان المسلمين، وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده.
وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة. قال الله تعالى: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة:14]. فأخبر ـ سبحانه ـ أن نسيانهم حظا مما ذكروا به سبب لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. فإذا اتبع الرجل جميع المشروع المسنون، واستعمل الأنواع المشروعة، هذا تارة، وهذا تارة، كان قد حفظت السنة علما وعملاً، وزالت المفسدة المخوفة من ترك ذلك.
ونكتة هذا الوجه: أنه وإن جاز الاقتصار على فعل نوع، لكن حفظ النوع الآخر من الدين ليعلم أنه جائز مشروع، وفي العمل به تارة حفظ للشريعة، وترك ذلك قد يكون سببا لإضاعته ونسيانه.
السابع: أن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل: التسوية بين المتماثلين، وحرم الظلم على نفسه، وجعله محرما بين عباده، ومن أعظم العدل العدل في الأمور الدينية، فإن العدل في أمر الدنيا من الدماء والأموال كالقصاص والمواريث، وإن كان واجباً وتركه ظلم، فالعدل في أمر الدين أعظم منه، وهو العدل بين شرائع الدين، وبين أهله.
فإذا كان الشارع قد سوي بين عملين أو عاملين، كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم، وإذا فضل بينهما، كانت التسوية كذلك، والتفضيل أو التسوية بالظن وهوي النفوس من جنس دين الكفار، فإن جميع أهل الملل والنحل يفضل أحدهم دينه إما ظنا، وإما هوي، إما اعتقاداً، وإما اقتصاداً، وهو سبب التمسك به وذم غيره.
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرع تلك الأنواع إما بقوله، وإما بعمله، وكثير منها لم يفضل بعضها على بعض، كانت التسوية بينها من العدل والتفضيل من الظلم، وكثير مما تتنازع الطوائف من الأمة في تفاضل أنواعه، لا يكون بينها تفاضل، بل هي متساوية. وقد يكون ما يختص به أحدهما مقاوماً لما يختص به الآخر، ثم تجد أحدهم يسأل: أيما أفضل هذا أو هذا؟ وهي مسألة فاسدة، فإن السؤال عن التعيين فرع ثبوت الأصل، فمن قال إن بينهما تفاضلا حتى نطلب عين الفاضل؟!
والواجب أن يقال: هذان متماثلان، أو متفاضلان، وإن كانا متفاضلين: فهل التفاضل مطلقا، أو فيه تفصيل بحيث يكون هذا أفضل في وقت، وهذا أفضل في وقت؟
ثم إذا كانت المسألة كما تري، فغالب الأجوبة صادرة عن هوي وظنون كاذبة خاطئة، ومن أكبر أسباب ذلك المداومة على ما لم تشرع المداومة عليه. والله أعلم"اهـ.
قلت (أبوصهيب): وهذا بحث نفيس فيه تحرير من الإمام الفقيه ابن تيمية -رحمه الله- فاعقله ولخص فوائده تضبط هذه المسألة بأصلها وفرعها، ثم إنَّ بعض الفروع قد يتردد بين طرفي المسألة كالجمع بين الأذكار المختلفة في الركوع والسجود والرفع من الركوع فهذه اختلف العلماء فيها، بين مجوز وقائل بالمشروعية ومحرم، و(لعل) الجواز هو أقربها دون المشروعية.
وبهذا تنتهي هذه الفائدة الثانية التي انتقاها لنا الشيخ محمد بازمول -وفقه الله- وهذا رابط الأولى: توجيه كلمة الكرخي: كل آية أو حديث على خلاف مذهبنا فهي منسوخة أو متأولة"